السبت 29 ربيع الأول 1437// 9 يناير/كانون الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
د. محمد بن سعد الدبل
القرآن الكريم كتاب الله، ومعجزة نبيِّه، وهو المنبع الأول لجميع الأعمال التي تتصل بالعقيدة الإسلامية، وأحكام الشريعة، بما يدخل فيها من العبادات والمعاملات، وما يتصل بنظام الأسرة والمجتمع، وحق الفرد على الجماعة، وواجبه نحو نفسه، ونحو غيره ممن يحيا بينهم، وكل ما يتصل بمبادئ الأخلاق وقواعد السلوك، وسائر الفضائل التي تميِّز الإنسانَ على كل ما خلق الله، وتَرْفعه على غيره درجات، وعلى الجملة، فإن القرآن الكريم هو جماع العقيدة والعبادة والفضائل، وكل ما يتصل بتوجيه البشر نحو الغاية المثلى التي يتطلعون إليها، وهي السعادة التي ينشدها الناس في الحياة الدنيا والآخرة.
♦ ♦ ♦ ♦
وقد كان الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – إمام هذه الأمة القائد، والقدوة الحسنة، والمعلم الأول، الذي اقتدى به المسلمون، فحاكَوْه في الفضائل التي جمَّله بها ربُّه، وفي العمل بالأحكام التي نزلت بها شريعتُه، وفي كل ما يحتاجون إلى إدراكه ومعرفته من أسباب الهداية إلى سبيل الرشاد.
قراءة المزيد: انفجار بركان ساكوراجيما يقذف رمادا بارتفاع 4400 متر جنوب غربي اليابان
وقضى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – وانقطع الوحي، فكان القرآن هو الإمامَ الذي يأتم به المسلمون، ويرجعون إليه في كل أمر فيه صلاح لمعاشهم ومعادهم، رجع المسلمون إلى كتاب الله يحاولون إدراك ما خفِي عليهم من مقاصده ومراميه، ويستخرجون منه أصول عقيدتهم وأحكام دينهم، ويبحثون في طبيعة القرآن للوقوف على أسرار عظمته وأسباب إعجازه؛ فقد عرَفوا أنه المعجزة الكبرى لنبيِّهم – صلى الله عليه وسلم – وكذلك التمسوا من القرآن أفصحَ ما عُرِف من لغة العرب في مفرداتها وتراكيبها، وفي مظاهر الإبداع التي يختص بها الفن الأدبي الذي برعوا فيه منذ كانت لهم حياة على وجه الجزيرة.
ولذلك؛ كان الكتاب الكريم قِبْلة الفقهاء، وكان إدراكه غايةَ أهل التفسير والتأويل، وكان جماله وتفوقه البياني مجالَ بحثِ البُلغاء والناقدين، وكانت مُثُله العليا في المعاملة والأخلاق والسلوك مجالاً للمفكرين من علماء الأخلاق وعلماء الاجتماع، ونجتزئ في هذا المقام بتلك الكلمات القصيرة التي جعلت القرآنَ الكريم يجذب إليه عقولَ العلماء والمفكرين في كل وادٍ من أودية الفكر، وتستثير أذواق القادرين على تذوق فنون الكلام والموازنة بين روائعه؛ ليخلصوا إلى الغاية التي ينشدونها، وهي إثبات إعجاز الكتاب الكريم.
ويعنينا في هذا المقام أن نشير إلى أن هذه العناية الكبرى بالقرآن لم تنقطع طوال ذلك الزمن، منذ أُنزل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى زمننا، وستظل تلك العناية موصولةً إلى أن يرثَ الله الأرض ومن عليها؛ فإن أسرار ذلك الكتاب لا تنفَدُ، وكنوزه المخبَّأة لا تنتهي، وستظل الإنسانية تفتش في ذلك الكنز؛ لتستخرج منه كل يوم جديدًا يغذي العقول، ويهز المشاعر، ويثير الأذواق، ومن الطبيعي أن تخلِّف تلك الجهودُ الموصولة التي بذلها العلماء والعارفون في خدمة كتاب الله – تعالى – تراثًا حيًّا يعِزُّ على الإحصاء؛ ففي حقل التفسير تزخر المكتبة القرآنية بأمهات الكتب، التي منها ما أظهر عناية خاصة بشرح آيات الذكر الحكيم، وما يعرض فيها من معنى لفظ، أو بيان عظمة، أو سرد خبر؛ كتفسير ابن كثير، والراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، وغيرهما.
ومنها ما اختص بذكر أسباب النزول، وبيان الناسخ والمنسوخ، والمُحكَم والمتشابه، والمُطلَق والمقيَّد، والمكي والمدني، وتفسير آيات الأحكام.
قراءة المزيد: الفلبينيون يحتجون في مانيلا رفضا لفضيحة فساد بمشاريع مكافحة الفيضانات
وبيان أنواع القراءات عند مَن عُنِي بضبط لغات القرآن، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه.
ومن العلماء مَن اهتم بالنواحي الإعرابية؛ كمحب الدين أبي البقاء العكبري، وفي وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، وابن خالويه في كتاب: “إعراب ثلاثين سورة من القرآن”، ومنهم مَن وجَّه عنايته إلى التفسير البلاغي؛ كالزمخشري في “الكشاف”، وعبدالقاهر الجُرْجاني، والقاضي الباقلاني في مسألة النَّظم ودلائله.
♦ ♦ ♦ ♦
وكان من أبرز ما عُنِيت به الدراسات القرآنية قديمًا البحثُ في البيان والإعجاز، حتى كان القول في البيان مندرجًا تحت القول بالإعجاز، يقول أبو هلال العسكري في كتابه: “الصناعتين”: “وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخلَّ بمعرفة الفصاحة، لم يقع علمُه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه اللهُ به من حسن التأليف وبراعة التراكيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف…”.
قراءة المزيد: الملك الأردني يزور إندونيسيا بعد تدريبه مع برابوو في القوات الخاصة الأمريكية
“وقد كان البيان، وهو من أقدم علوم البلاغة، وكان اسمه يطلق على ما يراد منها جميعًا – متأثرًا في نشأته وتطوره إلى حد بعيد بهذا العامل الديني الجديد؛ فهو بذلك معدودٌ من جملةالعلوم الإسلامية؛ لإبرازه ما في القرآن الكريم، وهو كتاب العقيدة الإسلامية، وآيتها المعجزة، من وجوه الجمال التي يمتاز بها عن سائر كلام البشر”[1].
ولذا؛ تجرد العلماء للعناية بتلك الظاهرة، ووسَّعوا مجال البحث فيها، نلحظ ذلك فيما تناوله بعضُهم وخصَّه بالبحث والتأليف؛ كالذي في “تأويل مشكل القرآن” لابن قتيبة (ت 276هـ)، “وحجج النبوة” للجاحظ (ت 255 هـ)، وتناوله المفسرون؛ كالذي في “جامع البيان” للطبري (ت 310هـ)، و”مجاز القرآن” لأبي عبيدة (ت 208هـ)، و”معاني القرآن” للفراء”[2].
♦ ♦ ♦ ♦
وهناك نشاط ملحوظ في دراسة بلاغة القرآن الكريم؛ فقد بذل العلماء جهودًا كبيرة في التعرف على بلاغة كتاب الله، ولم يكن اهتداؤهم إليها أمرًا يسيرًا؛ فهم قد اعترفوا أن وجوهَ البلاغة في القرآن يصعُب تحديدها، لكن هذه الصعوبة لم تمنعهم من محاولة استنباط ما استطاعوا استنباطه من وجوه البلاغة القرآنية، حتى اهتدوا إلى معرفة الكثير من نواحي الحُسن في القرآن، والخصائص التي يمتاز بها، سواء كان ذلك من ناحية النَّظم والتأليف، أم كان ذلك من ناحية المرامي والأغراض، نلمس تلك الجهود عند الكثير من؛ كالنكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت 386هـ)، وبيان إعجاز القرآن للخطابي (ت 388هـ)، الذي عالج فيه موضوعَ البلاغة بذكر الأقسام الثلاثة للكلام المحمود، مقررًا أن بلاغة القرآن قد أَخذت من كل قسم حصةً، ومن كل نوع شُعبة، مناقشًا بعض وجوه البلاغة القرآنية، إذ يقول:
“وأما ما عابوه من الحذف والاختصار في قوله – سبحانه -: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ [الرعد: 31]، فإن الإيجازَ في موضعه، وحَذْف ما يَستغني عنه الكلامُ نوعٌ من أنواع البلاغة، وإنما جاز حذف الجواب في ذلك وحَسُن؛ لأن المذكور فيه يدلُّ على المحذوف والمسكوت عنه من جوابه، ولأن المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالمنطوق به، والحذف في مثل هذا أبلغ من الذِّكر؛ لأن النفس تذهب في الحذف كلَّ مذهب”[3]، وحصر الأمثلة والوجوه البلاغية في كتاب الخطابي قد يخرج بنا إلى الاستطراد؛ ولذا سنرجئه؛ إذ سيأتي الكلام على رأيه مفصلاً عند الحديث عن النَّظم، وأنه وجهٌ من وجوه الإعجاز.
قراءة المزيد: تايوان تجلي آلاف السكان مع اقتراب العاصفة المدارية فونغ وونغ
والنَّظم من صميم الأبحاث البلاغية التي أَولاها العلماء عناية فائقة، وفي الذروة منهم عبدالقاهر الجُرجاني (471هـ) أو (474هـ)، الذي استقى من جميع الينابيع التي سبقته، واستنار بآراء الذين كتبوا قبله في إعجاز القرآن وبلاغته، ولم يكن مقلدًا لمن سبقه أو عاصره، ويُعَدُّ كِتاباه “أسرار البلاغة” و”دلائل الإعجاز” من أمهات الكتب المبتكرة العميقة في الدراسات البلاغية، وخاصة فيما يتعلق ببلاغة القرآن وفصاحته، والقول في فكرة النظم، تلك الفكرة التي أكدها عبدالقاهر، ونادى بها، وفَلْسَفَها بأسلوبه المنطقي وبفكره الواعي، مما لا نجد مجالاً لتفصيله في هذا المدخل الموجز.
وقد تناول عبدالقاهر في كتابيه كثيرًا من الموضوعات والأبواب البلاغية، وعالج مسائلها وقضاياها، وعُنِي بالمعاني ومكانتها في أي عمل أدبي، وهو بذلك يكشف عن أسرار بلاغة القرآن وأسباب إعجازه، وليس في الإمكان أن نحصي المسائل البلاغية والأدلة القرآنية التي ساقها هذا العالم في ثنايا دراسته القيمة.
وسنذكر بعض الأمثلة له عند الحديث عن النظم، وأنه وجه من وجوه الإعجاز، والذي يهمنا في هذه العجالة هو اهتمام عبدالقاهر وعنايته القصوى بالبلاغة والإعجاز القرآني، التي كانت ذروة لجهود الأعلام من العلماء الذين سبقوه؛ فعنايته قائمة على تحليل النص، والكشف عن أسراره ولطائفه، والاستشهاد عليه من كلام أئمة البلاغة العربية نثرها وشعرها، حتى عُدت طريقتُه الطريقة التحليلية النفسية التي تسمو بالذوق في مدارج البلاغة وفن القول.
♦ ♦ ♦ ♦
قراءة المزيد: الهند.. الشرطة تحقق بانفجار نيودلهي تحت قانون الإرهاب
ومن جملة مَن عُنِي بالدراسات البلاغية القرآنية الإمام فخر الدين الرازي (ت 606هـ) في كتابه: “نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز”، وهذا الكتاب واضح التأثُّر بما كتب عبدالقاهر الجُرجاني في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، ومن الممكن القول بأن الدراسة المستفيضة والبحث المبسوط في هذين الكتابين، اختصر في هذا الكتاب.
وأكثر ما كتبه الرازي في خطبته في فضل علم البيان وأثرِه في الأدب في إثبات إعجاز القرآن – منقولٌ نقلاً يكاد يكون حرفيًّا مما كتب الجرجاني في مقدمة أسرار البلاغة، كما أن أسلوب عبدالقاهر وأفكاره في الأدب والبيان واضحةٌ كل الوضوح في المباحث التي عالجها الكتاب، وفي هذه الخطبة أشاد الرازي بجهود عبدالقاهر في علم البيان؛ فهو الذي استخرج أصول هذا العلم وقوانينه، ورتَّب حججه وبراهينه، وبالَغَ في الكشف عن حقائقه، والفحص عن لفظه ودقائقه، وصنَّف في ذلك كتابين؛ لقَّب أحدهما بدلائل الإعجاز، والثاني بأسرار البلاغة، وجمع فيهما من القواعد الغريبة،والدقائق العجيبة، والوجوه العقلية، والشواهد النقلية، واللطائف الأدبية، والمباحث العربية – ما لا يوجد في كلام مَن قبله من المتقدمين، ولم يصل إليها غيره من العلماء الراسخين، ولا يؤخذ عليه إلا أنه أهمل رعاية ترتيب الأصول والأبواب، وأطنب في الكلام كل الإطناب، ويعترف بأنه التقط من الكتابين معاقد فوائدهما، ومقاصد فوائدهما، غير أنه راعى الترتيب مع التهذيب، والتحرير مع التقرير، وضبط أوابد الإجمالات في كل باب بالتقسيمات اليقينية، وجمع متفرقات الكلم في الضوابط العقلية مع الاجتناب عن الإطناب الممل، والاحتراز عن الاختصار المخل[4].
♦ ♦ ♦ ♦
وكذلك تأثر ابن الزملكاني (ت 651هـ) في كتابه “التبيان في علم البيان، المطلع على إعجاز القرآن” بعبدالقاهر وكتابه دلائل الإعجاز، الذي وصفه ابن الزملكاني بأنه جمع فأوعى، وأنه فك قيد الغرائب بالتقييد، وهدم سور المعضلات بالتسوير المشيد، حتى عاد أسهل من النفس..”، ثم يأخذ ابن الزملكاني على كتاب عبدالقاهر بأنه واسع الخطو، كثيرًا ما يكرر الضبط، فقيد للتبويب، طريد من الترتيب، يمل الناظر، ويُعشي الباصر، والمتأمل يلحظ التناقض الواضح في أسلوب ابن الزملكاني؛ فهو أسلوب مصنوع، نقض في آخره ما بنى في أوله؛ ليجد ذريعة إلى هذا التأليف الذي سهل الله – تعالى – جمع مقاصده وقواعده، وضبط جوامحه وطوارده، مع فرائد سمح بها الخاطر، وزوائد نقلت من الكتب والدفاتر.
قراءة المزيد: اعتقال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الاستخبارات في كوريا الجنوبية
ويتضح لنا أن دلائل الإعجاز هو أصلُ كتاب التبيان بزيادة مما سمح به الخاطر، وما نقل من الكتب والدفاتر[5].
على أن هذين الكتابين لم يبلغ واحد منهما ما بلغ عبدالقاهر في كتابه؛ لأن الرازي وابن الزملكاني اتجها اتجاهًا قاعديًّا جافًّا، فأبعدا البلاغةَ العربية عن طريقها الطبيعي الذي يقوم على التذوق وتنبيه الإحساس إلى أسرار الجمال في فن القول، ومكنا لهذا الاتجاه الذي غلب على بلاغة المتأخرين، فأحالها إلى قواعدَ تُحفظ وأقسامٍ تحصى.
♦ ♦ ♦ ♦
وللقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى سنة 403هـ) أثرٌ جليل، يدل على حذق الباقلاني للبيان والبلاغة القرآنية، ذلك الأثر هو كتابه “إعجاز القرآن”، الذي أفاض القول فيه عما يوجَّه إلى القرآن من المطاعن التي يريد بها أصحابُها الغضَّ من شأن الآية الكبرى للنبوة المحمدية، مع ذكر المؤلف جملة من وجوه إعجاز القرآن عند بعض العلماء، ويعنينا في هذه العجالة اهتمامُ الباقلاني وعنايته بالدرس البلاغي للقرآن الكريم؛ فقد أفاض في الحديث عن بدائع القرآن، وساق الأمثلة من آياته، وعُنِي بمعالجة فكرة النظم في كثير من الآيات، بل طبقها على سورتين كاملتين، هما سورتا غافر وفصلت.
قراءة المزيد: 20 عسكريًا كانوا على متن طائرة الشحن التي تحطمت في جورجيا
إلى غير ذلك من الآثار عند القدماء التي خدمت القرآن، وكشفت عن أسرار إعجازه وبلاغته؛ “كالجمان في تشبيهات القرآن” لابن ناقيا البغدادي (ت485هـ)، وبدائع القرآن وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصري (ت654هـ)، وكتابه: بديع القرآن “كتاب فريد في بابه؛ حيث جاء في فترة سبقها نضج في الدراسات القرآنية، فحاول ابن أبي الإصبع أن يفيد من جهود سابقيه، ويجعل من كتابه مادة تطبيقية لآيات القرآن على ما عرَفه من فنون البيان والبديع”[6].
وقد توافرت الدراسات القرآنية، وهي في ماهيتها مَعِينٌ لا ينضب، تستقي أمثلتها وشواهدها من القرآن الكريم وآثار السابقين؛ “كالصناعتين” لأبي هلال العسكري (ت 395هـ)، و”سر الفصاحة” لابن سنان الخفاجي، و”المثل السائر” لابن الأثير والطراز للعلوي.
ومن كل ما تقدم نستطيع أن نجمل مظاهر العناية بالدراسات القرآنية عند القدماء فيما يلي:
1- “إن المتكلمين اتخذوا دراسة البيان أساسًا اعتمدوا عليه في دراسة إعجاز القرآن، وفهم معانيه، ومعرفة أحكامه، وطرق الاستدلال بأساليبه وتعابيره على إثبات الإعجاز والرد على منكريه أو المتشككين فيه.
2- إن هذه الدراسات لم تقتصر على الناحية اللفظية وحدها، ولا على الناحية المعنوية وحدها، بل هي دراسة موضوعية لا تقف عند النظرة الكلية التي تلقى فيها الأحكام عامة، دراسة واسعة عميقة تتناول الأسلوب بأوسع معانيه، فتدرس اللفظ مفردًا، وتتناول الجملة ونظم العبارة كما تتناول دلالة اللفظ ودلالة العبارة على المعنى.
قراءة المزيد: كمبوديا تنفي اتهامات تايلند بشأن الألغام الحدودية
3- إن أصحاب هذه الدراسات نهجوا فيها منهجًا موضوعيًّا جديدًا، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على أسلوب الموازنة بين النصوص المأثورة وبين الأسلوب القرآني.
4- إنهم جددوا في دراسة البيان العربي بما استخرجوه من القرآن الكريم من فنون بيانية رائعة أضافوها إلى جهود مَن سبقهم، وكانت دراسة عملية يثار فيها جانب العقل والتفكير، وتستثار ملكة الملاحظة، وتدرب المواهب، حتى كانت دراساتهم صورة حية للدقة في التفكير، والدقة في التعبير، ثم طبقوا هذه المعارف على آيات الكتاب الحكيم تطبيقًا يشهد لهم بالذوق المستنير والإدراك الكامل”[7].
♦ ♦ ♦ ♦
وكما فاضت مكتبة الدراسات القرآنية بآثار السلف، سارت الطبقة التي خلفتهم في ذلك الطريق الذي رسموه، فرأينا لفيفًا من العلماء في العصر الحديث يجرِّدون أنفسهم، ويسخِّرون أقلامهم لخدمة تلك الدراسات، التي نشأ عنها صرحٌ جديد في الدراسات القرآنية، وعلى الرغم من أن جهود المعاصرين في ذلك تُعَد امتدادًا لما خلفه أسلافهم، فإن ما أضافوه لا يعدم رُوح التفكير السليم والذوق الرفيع، ومن جملة تلك الدراسات المعاصرة – على سبيل المثال لا الحصر -: كتاب “إعجاز القرآن” للمرحوم مصطفى صادق الرافعي، الذي درس فيه إعجاز القرآن وبلاغته دراسة موضوعية، تناول فيها الإطارَ والمضمون لآيات الكتاب الكريم، مبينًا سمو المعنى في كل آية يسوقها، وشدة تآلف الحروف وانسجامها مع كل لفظة تبنى عليها، وأمثلة ذلك الجهد قارة في موضعها من الكتاب.
قراءة المزيد: قادة صحة الكبد ومسؤولو الصحة في آسيا والمحيط الهادئ يلتقون في تايوان لتعزيز التعاون المشترك
وهناك أثر جليل من آثار الدراسات القرآنية المعاصرة للمجاهد الشهيد بإذن الله سيد قطب، وهو تفسيره: “في ظلال القرآن” الذي نهج فيه منهجًا أدبيًّا رائعًا، وفسَّر جميع سور القرآن على نمط رفيع من الأسلوب، وكذلك كتاباه: التصوير الفني في القرآن، ومشاهد القيامة في القرآن.
ولنقف قليلاً مع كتابه “التصوير الفني في القرآن”؛ إذ موضوعه وثيق الصلة ببحثنا هذا، إن طريقته في هذا الكتاب طريقة تقوم على التحليل لنصوص الآيات، واستخراج عناصر الجمال فيها، والجمع بين البلاغة والنقد؛ إذ يقول في فصل منه تحت عنوان “كيف فهم القرآن”: “أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداءً من أواخر القرن الثاني للهجرة، ولكن هذا النمو بدلاً من أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن وتناسقه مع الجمال الموضوعي البالغ حد الكمال، أخذ يغرقفي مباحثَ فقهيةٍ وجدلية، ونحوية وصرفية، وتاريخية وأسطورية، وبذلك ضاعت الفرصةُ التي كانت مهيأة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني في القرآن”، وربطها بالكمال الموضوعي الذي يتجلَّى فيه.
ثم يسوق الأمثلة من القرآن، موضحًا فيها طريقة التعبير والتصوير، منحيًا باللائمة على السابقين الذين صرَفوا جهدهم عن استخراج عناصر الجمال في التعبير القرآني، فيقول: “انظر إلى التعبير الجميل في قوله – تعالى -: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة: 12]، هذا التعبير الذي يرسم صورة حية للخزي في يوم القيامة، ويصور هؤلاء المجرمين شخوصًا قائمة تكاد تبصرها العين؛ لشدة وضوحها وتسجيل هيئتها ﴿ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ ﴾، وعند من؟ عند ربهم، ثم هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث بلاغي إلا أن يقول: وأصل الخطاب أن يكون لمعيَّن، وقد يترك إلى غير معيَّن… وهو في القرآن كثير؛ كقوله – تعالى -: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾”.
وتستمر التعبيرات المتداولة عن قوم إلى قوم آخرين حول هذا الشاهد وأشباهه من القرآن الكريم.
قراءة المزيد: إجلاء أكثر من مليون شخص بالفلبين مع اقتراب إعصار “فونغ وونغ”
وتطوى تلك الصورة الفنية الحية، وتنتهي عند علماء البلاغة إلى كونها “تفظيعًا لحالهم التي تناهت في الظهور”[8]، ويمكن القول بأن تفسير سيد قطب، وكتابيه التصوير الفني ومشاهد القيامة، كلها تنبع من روح واحدة، وتتجه وجهة واحدة في العناية بالدرس القرآني، هي الوصول إلى فهم الصورة الفنية في القرآن.
وبين أيدينا كتاب قيِّم، يعد من المؤلفات الجليلة النفع في الدراسات القرآنية المعاصرة، ذلك هو كتاب “النبأ العظيم” للدكتور محمد عبدالله دراز، وهو نظرات جديدة في القرآن الكريم، عالج فيها المؤلف بلاغة القرآن وإعجازه، وتناول كغيره من الباحثين اللفظة القرآنية والتراكيب، واستخراج الأسرار البلاغية في القرآن؛ كالذي نجده في قوله: “دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنها “مقحمة”، وفي بعض حروفه: إنها “زائدة” زيادة معنوية، ودع عنك قول الذي يستخف كلمة “التأكيد”، فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة…. أجل دع عنك هذا وذاك؛ فإن الحُكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل – مستورًا أو مكشوفًا – بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن، وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية، وقل قولاً سديدًا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف”[9].
ويمضي المؤلف متحدثًا عن القرآن الكريم في بعض من آياته وسوره، ثم يتوج بحثه بحديثٍ مفصل عن سورة البقرة.
ومن جملة الدراسات القرآنية المعاصرة كتاب “البيان العربي” للدكتور بدوي طبانة، وهو دراسة في تطوير الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى، تناول فيه المؤلف بعض الآثار في الدراسات البلاغية قديمًا وحديثًا، وخصه بحديث مفصل عن القرآن الكريم تحت عنوان “البيان والإعجاز”، وتناول بالعرض والتحليل بعض مناهج الدراسات البلاغية مقررًا “أن القرآن الكريم على اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة، يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب، والتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد، وهذا أمر عجيب تتبين به الفصاحة، وتظهر به البلاغة، ويخرج به الكلام عن حد العادة، ويتجاوز العُرف”[10].
كما بيَّن المؤلف مدى اهتمام الباحثين بالدراسات القرآنية فيما يتعلق بالقرآن كلمة كلمة وجملة جملة، مع ضرب الأمثلة ومناقشتها، وأن القول بإعجاز القرآن كان هو البذرة التي غرسها العلماء، فأخرجت دوحةً وارفة الظلال في تاريخ التفكير الإسلامي والعربي، تتمثل في علوم البلاغة.
ومن بين كتب الدراسات القرآنية المعاصرة كتاب: “من منهل الأدب الخالد” لمحمد المبارك، الذي يعتبر دراسة لاستجلاء بعض الأسرار البلاغية في القرآن، وكتاب: “التفسير البياني” لبنت الشاطئ، وكتاب: “من بلاغة القرآن” للدكتور أحمد أحمد بدوي، ونكتفي بذكرها منعًا للاستطراد، ولأنه سيأتي الحديث عن بعضها وعن غيرها مما سبق ذكره حين نعرض للحديث عن النظم، وأنه أحد وجوه الإعجاز.
ويمكن تلخيص عناية الباحثين في الدراسات القرآنية الحديثة فيما يلي:
1- اتجاه همِّ المعاصرين إلى جميع ما قيل في الإعجاز من أقوال السابقين بطريقة فذة في التناول والعرض والبرهنة والاحتجاج والجدة في المناقشة.
2- إن معظم هذه الدراسات جمعت بين الدراسة النظرية بتتبع أقوال السابقين، وبين الدراسة التطبيقية باستعراض آيات الذكر الحكيم، وتحليلها واستخراج عناصر الجمال الفني فيها.
3- إن هذه الجهود جمعت بين النقد والبلاغة، بإيضاحأسرار القرآن البلاغية التي أغفلها السابقون، وإدامة النظر في وحدة القرآن الفنية، كما في التصوير الفني ومشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب.
4- إلحاح المعاصرين في دراساتهم القرآنية على ذكر آيات التحدي ودراستها دراسة فنية تحليلية، وإدامتهم النظر في فكرة النظم، وما يختص منها بنظم القرآن، وتجليتهم هذه الفكرة في كثير من الآيات، وعنايتهم الفائقة بتحقيق التراث القرآني وجمع بحوثه المتفرقة.
________________________________________
[1] البيان العربي؛ للدكتور بدوي طبانة، ص18، 20، ط. الرابعة.
[2] الإعجاز البياني لبنت الشاطئ، ص15، ط. دار المعارف بمصر.
[3] بيان إعجاز القرآن للخطابي، ص 47، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، ط. د. م بمصر.
[4] انظر البيان العربي؛ للدكتور بدوي طبانة، ص 334، 335، ط الرابعة.
[5] المصدر السابق، من 356.
[6] المصدر السابق ص55، 66.
[7] المصدر السابق ص71، 72.
[8] انظر تحليل الآية في: التصوير الفني في القرآن؛ لسيد قطب، ص 28.
[9] انظر النبأ العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز، ص130، 131، ط الثالثة 1394هـ، مطبعة الكويت.
[10] انظر البيان العربي؛ للدكتور بدوي طبانة، ص 61، ط. الرابعة.
الألوكة





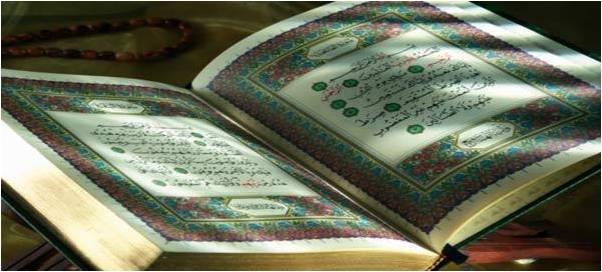






















 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic