الأربعاء،28ذوالحجة1435ه الموافق22أكتوبر/تشرين الأول وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
محمود داود دسوقي خطابي
خصائص منهج التربية الإسلامية
الحمد لله منزل القرآن للمؤمنين شرعةً ومنهاجًا، رب العالمين وهاديهم إليه فضلاً منه لا احتياجًا، مكرمهم برؤيته يوم القيامة؛ ليزدادوا سرورًا وابتهاجًا، ونشكره على نعمه التي غمرتنا جماعاتٍ وأفرادًا، ونستعينه ونستهديه ونستغفره على زللٍ فعلناه جهلاً وتقصيرًا لا اعتقادًا، ونصلي ونسلم على من اصطفاه ربه فأدناه منه اقترابًا، سيدنا محمدٍ الذي أرسله ربه هاديًا للعالمين وسراجًا وهاجًا، فبلغ دينه وأبان للخلق الإسلام علمًا وقولاً وعملاً واعتقادًا، وعلى آله وصحبه وتابعيهم كلما ذكَر اللهَ الذاكرون صباحًا ومساءً وهجادًا.
أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن لكل منهج خصائصَ ينفرد بها ويتميز من خلالها، وإن منهج التربية الإسلامية يتميز بعدة خصائص تجعله شامخًا فوق كل منهج، وهذه الخصائص هي[1]:
1 – أنه نظام: أي: إنه بمفهومه وخصائصه وأسس بنائه وعناصره يكون كلاًّ متكاملاً، كل جزء يتأثر فيه، فلم يهمل الفرد ولم يقدسه، وكذلك المجتمع، بل ربط بينهما، وعمل على القضاء على أي شيء يخدش هذا النظام أو يكدر صفوه من خلال المنهيات والمحرمات؛ فهو نظام بمعنى كلمة نظام، وبما تحويه من معانٍ.
2 – أنه متجرد: أي: إن هذا المنهاج دائم الثمرة، لا ينضب معينه؛ فهو متجدد بتجدد الأشخاص والأحوال والمواقف؛ فما من موقف أو شخص إلا ووجد في هذا المنهاج ما يوائمه وما لا يتعارض مع تصوره وفكره، بل يشمل ذلك كله؛ لأن أصله يحتمل ذلك؛ إذ جعل أصولاً ثابتة لا تتغير، وهذه الأشياء يقاس عليها ما يَجِدُّ من أمور؛ فمثلاً الخمر محرَّمة بنص الكتاب والسنة، ولكن جَدَّتْ بعضُ المشروبات أو المأكولات أو ما شابههما بأي صورة من الصور، وأردنا معرفة حكم الشرع فيها؛ إذ لا يوجد نص صريح بخصوصها، فإننا نلجأ إلى القياس؛ حيث نجعل ما تم النص عليه كأصل، والحكم معروف، وهو التحريم، وهنالك علة لتحريم هذا الشيء، فإذا وُجِدت في شيء أخَذت حكم الأصل؛ لاتفاق الفرع والأصل في علة التحريم، كما يلي:
الأصل: [الخمر] الحكم: التحريم بالنص، العلة ذهاب العقل “الإسكار”.
الفرع: [….] الحكم: التحريم بالقياس، العلة ذهاب العقل “الإسكار”.
وهكذا تجدد في الفكر والعمل، ومراعاة للظروف والأحوال والفروق الفردية؛ كأكل الخنزير والميتة حرام، لكن في بعض الأحيان يصبح حلالاً بقدر الحاجة، وهكذا العبادات وسائر أمور الشرع، مما يدل على أن هذا المنهج يراعي الظروف، ويقدر الأحوال بما يتماشى مع تكوين النفس البشرية؛ لهذا وصف بالتجديد، وتفرَّد به.
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
3 – أنه منهج متصف بالربانية: وهذه الربانية تكسبه شرفًا وقوة وأصالة؛ إذ إنه متصل بالسماء؛ فهو محفوظ من الخلل والعبث والخطأ، وهذه الربانية تكمن في أمرين اثنين، هما:
(أ) ربانية المصدر والمنبع.
(ب) ربانية الوجهة والغاية.
أما ربانية المصدر والمنبع: فهو نظام رباني صادر من الله تعالى للإنسان بما يصلحه في خلافته في الأرض، فعرَّفه كيفية خلقه، وسبب وجوده، وكيفية حياته، ولم يتركه يتخبط في متاهات التخمين للتعرف على خالق هذا الكون؛ ولهذا وجب على الإنسان تلقي هذا المنهاج عملاً وتطبيقًا، ورعاية واهتمامًا؛ فهو الوحيد الذي يصلح للجنس البشري؛ إذ لا زيادة فيه ولا نقصان.
وأما ربانية الوجهة والغاية: فتعني جعل كل هدف هو حسن الصلة بالله تعالى، فيسعى من خلال عمارة الأرض لتطبيق هذا المنهج الذي يستطيع كل الجنس البشري التكيف معه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم: 42]، فمع تمتعه بالدنيا وعمارته لها يجعل هدفه الأسمى هو التقرب من الله، وحب لقائه ورضاه؛ ليسعد في الدارين؛ “ولهذا يجب على المسلم ألا يتلقى أصول عقيدته ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه ولا منهج سياسته ولا موجبات فنه وأدبه وتعبيره – من مصادر غير إسلامية، ولا أن يتلقى في كل هذا من غير مسلم لا يثق في دِينه وتقواه”[2]؛ لأن لمنهج التربية بالنسبة للفرد المسلم ربانيةً في مصدرها ومنبعها، وفي وجهتها وغايتها.
4 – أنه متصف بالعالمية: ووصفه بالعالمية ملازم للتربية الإسلامية؛ فالإسلام ليس مقصورًا على العبادات في بقعة معينة أو في زمن معين، بل منهاج التربية الإسلامية شريعة وعقيدة ومنهاج حياة للبشرية جمعاء، وأصول عقيدته منذ خلق آدم عليه السلام ثابتة من حيث الوحدانية، والإفراد بالعبودية، واليوم الآخر؛ لأنه يصلح لكل زمان ومكان بالنسبة لبني الإنسان، وقد أشار القرآن الكريم إلى عالَمية هذا المنهج؛ كما في قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، وفي قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، وفي قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: 28]، وفي قوله: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم: 42]، وفي قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: 27]، وفي قوله: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾ [العلق: 8]، ومن المعروف أن الإسلام وحده الذي تذوب فيه الطبقية والعنصرية، بل يتقدم فيه من كان أهلاً لذلك، وهذا يؤكد على أن “الإسلام هو المنهج العالمي الوحيد الذي يستطيع أن يحكم نظام الكون، هو وحده بين كل مناهج الأرض الذي لا يفرق بين البشر على أساس طبقي أو عنصري أو طائفي”[3]، وكون منهج تربية الإسلام عالميًّا إنما استمد ذلك من عالمية هذا الدين الخاتم؛ فهو خاتم الأديان، ورسوله خاتم الرسل، والكتاب خاتم الكتب؛ لذلك فمنهجه عالمي خالد.
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
5 – أنه متصف بالثبات: وهذا الثبات في أصوله ودعوته ومعتقداته؛ فكل الأنبياء دينهم واحد، وكلهم أقوالهم في العبادة ثابتة لا تتغير بتغير الأمكنة والأزمان، ولا لتغير بني الإنسان؛ فهو ثابت في نظرته للإله، وفي نظرته للكون، وفي نظرته لتكيف الإنسان من خلال بيئته، ولكن الذي يتغير حقيقة هو وضع من الأوضاع المحيطة بالإنسان، أما معايير الإيمان ومقوماته وكذا تصوره العقدي فهي ثابتة، إنما يتغير طابع من الحياة؛ نظرًا لتكيف الإنسان مع بيئته، ومنهج التربية الإسلامية ثابت مهما كانت هناك نظريات تخالف معتقده، وهو ثابت في إيمانه بخالقه وبكيفية خَلقه وبعثه، كما علمه ربه، بخلاف غير المسلمين؛ فالأمر مضطرب غير ثابت، يتبع كل واحد نظرية أو فكرة، تثبت اليوم ثم تنقض غدًا، أما الفرد المسلم فتلك مسائل محسومة عنده، وثابتة بثَبات صحة دينه.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]، وقال: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]، ودعوة الأنبياء أقوامَهم لإفراد الله بالعبادة عدَّد القرآنُ ذكرها في غير ما موضع؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 25]، فكلهم اتفقوا في دعوة أقوامهم إلى أصل الدين: التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، لكن اختلفت شرائعهم فيما سوى التوحيد؛ تبعًا للحكمة الإلهية؛ كما أخبر بذلك سبحانه بقوله: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 48]، إذًا فدِينُ الأنبياء كلهم واحد، وهو التوحيد، وشرائعهم متعددة، وقد أكد هذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ¬((إنا معاشرَ الأنبياء ديننا واحد))[4]، وقال: ((الأنبياء إخوة لعلاَّت))[5]، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كأنهم إخوة لأمهات شتى وأبوهم واحد، والمقصود به التوحيد؛ ولهذا قال الإمام ابن تيمية: “فدِينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك لـه، وهو يُعبَد في كل وقت بما أمَر به في ذلك الوقت؛ وذلك هو دِين الإسلام في ذلك الوقت”[6]، هذا بدوره يدل على أهمية سلوك الإمام ابن تيمية لهذا المنهج؛ إذ هو كسفينة نوح، من كان في ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك مع الهالكين.
6 – أنه منهاج شامل: وهذا الشمول نابع من كون هذا المنهج إنما هو من عند الله؛ إذ يشمل منهج التربية الإسلامية مسائل بَدء الخلق، ومخاطبة الكينونة الإنسانية بكل جوانبها، مع ربطها بالحقائق الكلية، من حقيقة الألوهية أو الكون أو الحياة أو العبودية، وكذا الإنسانية، مع ربطها مع الكينونة البشرية، فما ترك منهجُ التربية الإسلامية شيئًا إلا وكان لـه دور في تهذيبه وتربيته، فتكلم عن العلاقات بين المخلوقين مع بعضهم البعض وأشرف من ذلك مع خالقهم، وحدد واجبات الأفراد مع بعضهم البعض، وأرشد إلى فعل أشياء وقال: فعلها جائز وحلال، وحذر من فعل أشياء وقال: فعلها غير جائز وحرامٌ، وما ترك الضمير ولا العقل ولا الجسد سدًى، بل تعامل معهم بما لا يتعارض مع الفطرة، بل بما ينمي تلك الفطرة، وبما يكون فيه سيادة الإنسان على وجه الأرض، فشمل له كل جوانب حياته، بل عرَّفه بخَلقه وقبل خلقه، وبعد موته وبعثه، وهذا لا يكون إلا في منهج عقيدته واضحة، و”إن العقيدة التي لا غيب فيها ولا مجهول ولا حقيقة أكبر من الإدراك البشري المحدود ليست عقيدة، ولا تجد فيها النفس ما يلبي فطرتها وأشواقها الخفية إلى المجهول المستتر وراء الحجب المُسدَلة، فتتوازن الفطرة”[7]؛ لذلك تتوازن لدى الفرد المسلم مسألتان: طلاقة المشيئة الإلهية، وثبات السنن الكونية، فيستوعب ما جاء في الشرع من أدلة على القضاء والقدر مع وجوب الأخذ بالأسباب، فلا تتعارض عنده الآراء، ولا تلتبس عليه التصورات والأفهام، فيجمع بينها كلها؛ ليقينه بتوازن الخلق، وهذا يعكس الصورة على الفرد من خلال منهجه المتوازن المتلقى من التربية الإسلامية.
7 – اتصافه بالتوازن: وهو يسير مع الشمول جنبًا إلى جنب، فكما أن منهج التربية الإسلامية شاملٌ، فهو أيضًا متوازنٌ؛ فهو منهج توازنت فيه الأمور: الدنيا والآخرة، والحقوق والواجبات، والنوازع والشهوات، توازن في الفهم واستخدام العقل واستغلاله، وكذلك في الأخلاق، فلم يجعل كل الصفات مكروهة، ولم يحبِّبها إلى الإنسان كلها، بل كل بحسب ما تقتضيه الطبيعة الإنسانية، وهذا المنهج جعل التوازن في تعامل الإنسان مع الروح ومع الفطرة ومع الجسد، وما تدركه حواسُّه وما لا تدركه، فلم يجعل هذا المنهجُ تربيته لأفراد البشر مجردة مَعمليَّة تكون في مختبر، ولم يجعلها في غياهب المجهول، بل ما يحتاج البشر إليه ويدركونه من أمور الغيب أوضحها لهم، وما لا تدركه أفهامهم وعقولهم ما أمرهم بالخوض فيه، وكذلك جعل التوازن في كل معتقد يعتقده الفرد جعل له فيه آثارًا من الغيب؛ حتى تستغل المواهب، وتتفاوت الأنفس في المراتب والدرجات، ولا بد من وجود أمور غيبية في معتقد الإنسان وتصوره، وإلا لما أصبحت عقيدة، كما يقول الأستاذ سيد قطب[8]، فلم يأمر الفرد أن ينعزل في كوخ أو في مغارة بعيدًا عن المجتمع – كأحوال أهل البدع ممن انتسبوا إلى الإسلام – فهذا يخالف طبع الإنسان المدني الاجتماعي وما أناطه من خلافة للأرض، ومع أن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة يعتزل الناس في غار لمدة محدودة، فإن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لم يحدث بعد أن أكرمه الله بالرسالة، ولم يُعرَف هذا عن أحد من أصحابه أو تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وكيف يقاس سلوك الإنسان وتعرف أحواله إلا من خلال تفاعل إيجابي في المجتمع؛ حتى لا يكون عالة على مجتمعه وبني جنسه، فتكون الدواب أكثر فائدة منه، وهذا يؤكد “أن مجرد المعرفة النظرية أو العلم الذي لا يؤثر في سلوك الإنسان وفي واقع حياته لا قيمة لهما، ولا يعتد بهما منهج التربية الإسلامية”[9]؛ فالواقعية صفة ملازمة وخاصة متميزة لمنهج التربية الإسلامية.
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
8 – اتصافه بالإيجابية: وهي متممة ومكملة للصفة السابقة، وأيضًا فإن هذه الصفة “تقتضي من المتعلم في منهج التربية في الإسلام أن يدفع عن نفسه الشعور بالسلبية، وأن يتزود بدوافع الحركة الإيجابية، كما تقتضي من المتعلم أيضًا نشاطًا إيجابيًّا، ووعيًا بأبعاد الموقف التعليمي، وتفاعلاً معه”[10]؛ فالإيجابية في حياة الفرد من وجهة التربية الإسلامية ضرورة شرعية إذ دعت إليها التربية الإسلامية.
9 – اتصافه بالواقعية: وهذه الخاصية تجعل من عقل وتصور الفكر الإسلامي توازنًا في شتى مناحي الحياة؛ إذ إن منهج التربية الإسلامية أعطى للعقل إجلالاً في الفهم والتدبر والاعتبار، وكذلك أعطى هذا المنهج تعاملاً مع الحقائق الموجودة حقيقة، ولا يجعل من الخيال أحكامًا، فلم يجعل لهم سيرة من الهالات كسِيَر عباد الأصنام والآلهة من دون الله، ولم يجعل القدسية الإلهية على مخلوق، كما فعل أتباع المسيح عليه السلام، بل بما يوائم الواقع، وكل أمر حُكي عن الشرع المطهر إنما حكاه من رآه حقيقة، وكل أمر غيبي أمر الشرع باعتقاده إنما هو على كل المخلوقين غيب، فلم يكن لمخلوق غيب ولآخرَ حقيقة، وتنعكس الصورة الواقعية على الناحية التعليمية التربوية من خلال تقديم خبرة ما للمتعلم، فإنه بتصميمه سيتفاعل مع هذا الموقف التعليمي، فيتحسن به سلوكه، “والأصل في هذا أن التعلم لا يحدث وفقًا لتصور منهج التربية الإسلامية إلا بعد تمام خمس خطوات مرتبة ترتيبًا سببيًّا، وهي كما يلي:
وجود دافع فطري أو حاجة للنفس غريزية أو مكتسبة.
إحساس المتعلم بحاجته لهدى الله لإشباع حاجته.
اندفاعه إلى النشاط والتفاعل مع الأخذ بكل الأسباب للتعرف على تفاصيل ما يريد معرفته.
حدوث الفهم والتحصيل من خلال استعانته بربه، وأخذِه بالأسباب.
فإذا جاء السلوك بعد ذلك موافقًا للفهم والإدراك والتحصيل، فإن التعلم يكون قد تم”[11]؛ فواقعية هذا المنهج تختلف عن معتقدات الرومان واليونان من الاعتماد على الغيبيات والخرافة، أو بما يريد بحثه من فلاسفة تلك المعتقد، وعلى الفرض قد عرف هؤلاء القوة التي هي وراء الطبيعة، وتوصلوا إلى أنها تختلف عن البشر، ومسيطرة عليهم، وهم في احتياج إليها، فهل يستطيعون أن يصلوا إلى ما يرضيها وما يغضبها، وما تريد أن تأمر به من عبادات أو تنهى عنه من منهيات؟! لذلك كانت الواقعية في منهج التربية الإسلامية ذات أهمية في كينونة هذا المنهج وصلاحه، ووجوب التمسك به واتباعه.
10 – موافقته للفطرة: أنه المنهج الوحيد الموافق للفطرة: فلا يجعل من الرسالة والنبوة شيئًا خرافيًّا، ولا ينتقص من حق الرسالة والرسول شيئًا، وكذلك في مجال الغيبيات أوضح الطريق وأنار السبيل للباحثين عن حقيقة وجوهر هذا الدين؛ فعند تعرضه للأمور الغيبية (ما وراء الطبيعة) لم يأتِ بهرطقة أو خرص أو تخمين، إنما خاطب الفطرة مكتملة، خاطبها بكل معانيها؛ فما في الإنسان يسير مع منظومة الفطرة حثَّه على فعله، وما فيه خدش أو إخلال للفطرة حذر منه وأمر باجتنابه؛ فأوجب الإيمان بالله الخالق المستحق لجميع أنواع العبودية؛ إذ كيف يخلُقُ ويُعبَد غيرُه، ويَرزُق ويُشكر سواه؟!، وفي حياتنا الدنيا إن فعل إنسان لآخر معروفًا فإنه وحده المستحق بالشكر، وكذلك صاحب العمل يعطي أجورًا لمن يعمل عنده، لا لمن يعمل عند غيره؛ فهذا يصادم العقل والفطرة، ولله المثل الأعلى، فالله هو الوحيد المستحق لكل أنواع العبادة، وهذا ما نادت به الرسل؛ ولهذا فالفطرة السليمة تأبى المشاركة؛ لأنها لا تأتي بخير، كما خاطب هذا المنهج العقدي الفطرة بذلك في كتاب ربنا – جل وعلا -: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزمر: 29]، وفيه أيضًا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: 22]؛ لذلك أمر صاحب الفطرة السليمة – أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم – بالوحدانية بقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [النحل: 51]، وصاحب الفطرة السليمة في أي زمان أو مكان لا يصل إلا إلى دين الفطرة: الإسلام؛ كما قال الله سبحانه: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: 30]؛ فهو يدعو إلى الفطرة، ويحافظ عليها، وأكد عليها، وسد كل باب وكل منفذ يخدش جانبًا من جوانبها؛ فالله خلق الخلق كلهم لعبادته، وإن خَلْقَ الله لا بد لهم من عبادة؛ فالنفس مجبولة مفطورة على العبادة، فإن تركت وشأنها ما عبدت إلا الله سبحانه، وإن أثر فيها مؤثر خارجي تأثرت به؛ من الوالدين، أو صديق، أو بيئة، أو شيطان، وقد خلق الله الخلق كلهم حنفاء؛ كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ((إني خلقتُ عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم – وفي رواية: فأضلتهم – عن دِينهم))[12]، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه ويمجِّسانه))[13]؛ فكل خلق الله على الفطرة التي خلقهم الله عليها، وكل مولود يولد إنما يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها، وهي دين الإسلام، فلو مات صغير قبل سن التكليف، فإنما يموت على فطرة الله، وإن لم يكن أبواه مسلمين؛ لأن الفطرة واحدة في جميع الخلق، ولكن الكفر يتلبس به المرء بعد ذلك، وجميع المخلوقين دائمو الحاجة إلى العبادة المستحقة لله وحده لا شريك له؛ لأن الخلق بدون هداية الله لهم بالرسل على انحراف يؤدي بهم إلى النار؛ كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: 103]؛ فكل الخلق في حاجة إلى إفراد الله تعالى بالعبودية، وقد قرر هذا المعنى وأوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: “وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه كحاجتهم وأعظم في خَلْقه لهم، وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم؛ فليس في الكائنات ما يسكُنُ العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومَن عبَد غيرَ الله، وإن أحبه وحصل له به مودةٌ في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم، ولو حصل للعبد لذاتٌ أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت، وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، [وأحيانًا يكون عدوًّا له لا يأبه به ولا ينفعه]، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده، ويضره ذلك، وأما إلهه [الحق وهو الله سبحانه وتعالى] فلا بد لـه منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه”[14].
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
هذا وإن اتجاه الكائنات إلى إله يعبدونه قسمان:
♦ قسم يتجه إلى إله باطل.
♦ وقسم يتجه إلى إله حق.
فالذي لم تتأثر فطرته بمؤثِّر خارجي يتجه إلى الإله الحق، وهو الله رب العالمين، “وإذا كان للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إلا به، ولا تكمل إلا به، وذلك إلهها، فليس لها إلا إله يكون به صلاحها إلا الله؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 22]، وليس ذلك للإنسان فقط، بل للملائكة والجن، فإنهم أحياءٌ عقلاء ناطقون…؛ فلهذا إن دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له”[15]، فلا بد للإنسان من إله يعبده، وعبادة يتعبد بها، والإله الوحيد الذي يستحق العبادة بجميع أنواعها هو الذي خلَق تلك المخلوقات وغيرها – سبحانه وتعالى – على فطرةٍ ابتدأ بها الخليقة، وبها نجاتها، وعليها تسير منظومة حياتها لتسعد في الدارين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ذكره الذاكرون، أو غفَل عن ذكره الغافلون.
________________________________________
[1] د. علي أحمد مدكور، نظريات المناهج التربوية، ص 33، الأستاذ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، جـ1 ص33، الأستاذ سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص 44، د. يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، ص 7، الشيخ عبدالله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، جـ1 ص4.
[2] الأستاذ سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص 203.
[3] د. علي أحمد مدكور، نظريات المناهج التربوية، ص51.
[4] رواه البخاري، الإمام ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (10/ 240 – 241 فتح)، رقم (3442 – 3443)، ومسلم (4/ 1837) رقم (2365).
[5] نفس المرجع السابق.
[6] شيخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، جـ2 ص379.
[7] الأستاذ سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي، ص114 – 115 بتصرف يسير.
[8] عملاق الفكر الإسلامي المعاصر الشاعر الأديب الأستاذ سيد إبراهيم قطب، حفظ القرآن دون العاشرة، تخرج في دار العلوم، وترقى في بعض الوظائف، وبعث إلى أمريكا، ثم عاد وسلك طريق الدعوة إلى الله، له مؤلفات شهيرة ماتعة، منها: الظلال، ومعالم في الطريق، والعدالة الاجتماعية في الإسلام، وخصائص التصور الإسلامي، استشهد سنة 1386هـ – 1966م.
[9] د. علي أحمد مدكور، نظريات المناهج التربوية، ص 76.
[10] نفس المرجع السابق.
[11] نفس المرجع السابق، ص 81 – 82 بتصرف.
[12] رواه الإمام أحمد (4/ 162) ومسلم (4/ 2197) رقم (2865).
[13] رواه البخاري (4/ 477 فتح) رقم (1358)، ومسلم (4/ 2047) رقم (2658).
[14] الإمام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ1 ص23 – 25 بتصرف، مرجع سابق.
[15] شيخ الإسلام ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق مجدي قاسم، جـ4 ص132 بتصرف، مكتبة البلد الأمين، ط1، جدة – المملكة العربية السعودية، 1414هـ – 1993م.
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
المصدر:الألوكة





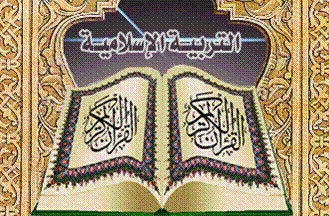










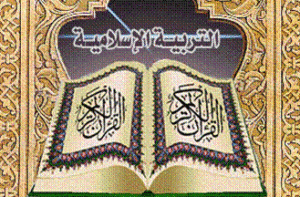






 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic