الجمعة،18 ذوالقعدة1435ه الموافق12 أيلول/سبتمبر2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
أؤكد على حقيقة هامة، وهي أن الدين في الإسلام علمٌ، والعلم في الإسلام دين، وتكريم الإسلام للعلم والعلماء شيء عظيم يعلمه القاصي والداني، ويكفي أن نقرأ قول الله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: 27، 28].
يقول ابن تيمية رحمه الله:
لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. ومن أقوال الشيخ المراغي رحمه الله: إن حقائق العلم لا تتنافى مع القرآن أبدًا، ولكن النظريات العلمية التي لم تستقر بعدُ بأدلة يقينية ثابته قد تختلف.
ويعرف الدكتور أحمد أبو حجر التفسير العلمي للقرآن على أنه: التفسير الذي يحاول فيه المفسر فَهْم عبارات القرآن الكريم في ضوء ما أثبته العلم، والكشف عن سرٍّ من أسرار إعجازه؛ من حيث تضمُّنه هذه المعلومات العلمية الدقيقة التي لم يعرفها البشر وقت نزول القرآن، ومن الضروري أن ينتبه المشتغل بالإعجاز العلمي للقرآن إلى قول الأستاذ الدكتور أحمد محمد الغمراوي رحمه الله: “أنه لا ينبغي في فَهْم الآيات الكونية في القرآن أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز، إلا إذا كانت القرائن الواضحة تمنع من حقيقة اللفظ، وتحمل على مجازه، كما لا ينبغي ألا نفسر كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العلم، لا بالفروض ولا بالنظريات التي لا تزال موضعَ فحصٍ أو تمحيص”.
وقديمًا قال الإمام أبو حامد الغزَّالي:
“لا يعرف كمال معنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ *الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 6 – 8]، إلا مَن عرَف تشريح الأعضاء من الإنسان”.
قراءة المزيد: آفاق البحث في علم التفسير
وكذا الحال على سبيل المثال: لا يعرف سر قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: 12 – 14]، إلا مَن درَس علم الأَجِنَّة وتخصَّص فيه.
تتلخص دعاوى المعارضين لقضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في ثلاث حُججٍ:
الأولى: الإعجاز القرآني يجب أن يكون لغويًّا يشمل نظْم القرآن.
الثانية: القرآن كتاب هداية وليس كتاب علمٍ.
حقائق العلم ليست سوى فروض ونظريات، تتغير صحتها من وقت لآخر، وقد تبطل فتضع النص القرآني في حرَجٍ، وهو ليس كذلك.
قراءة المزيد: مسارات الفاعلية في القرآن الكريم
ومما لا شك فيه أن أعظم وجوه الإعجاز في القرآن هو الإعجاز البياني؛ لأنه ينتظم القرآن كله. وإذا كان الإعجاز البياني يرجع فيه إلى النظم، فليس من المنطق أن يكون هذا النظم خاصًّا بالعرب وحدهم، فالعرب اليوم يحتاجون إلى أن يفسر لهم القرآن حتى يفهموه، فعلى سبيل المثال فإن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5].
يعني أن رزق هؤلاء ينبغي أن يكون من عائد الأموال لا من أساس المال، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: 14].
استعملت كلمة الإغراء بدلاً من الإلقاء؛ لتدل على الإلصاق والدوام، وهذا يعني أن البيان علمٌ ينضمُّ تحت الإعجاز العلمي للقرآن.
ويرى المعارضون لقضية الإعجاز العلمي في القرآن في القرآن، حتمية فَهْم ألفاظ القرآن الكريم في حدود الاستعمال الذي نزلت فيه، وَفْق ما فهِمه العرب الخُلَّص، والعجيب أن قول هؤلاء المعارضين يتناقض حتى مع أقوال المفسرين القدامى، الذي اعتُمِدت تفسيراتهم بالدرجة الأولى على لغة العرب الخُلَّص كما يقولون، وإلإ كيف يفسرون لنا التفسيرات السبعة التي أوردها القرطبي لكلمة “الحُبُك” في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ [الذاريات: 7]، ومثال آخر آراء المفسرين لكلمة “العالمين” عند تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، ويضيف المعارضون أن مهمة القرآن ليست علمية، وقد غاب عنهم أن القرآن نزل بالعلم: بعلم الله وبعلم سنن الكون الذي هو خلْق الله، هذا بالإضافة أن مَن لا علم له، لا حظَّ له يُذكَر من القرآن.
قراءة المزيد: آداب قراءة القرآن
قول المعارضين بعدم إقحام نظريات العلم على القرآن؛ حتى لا ينشأ الصراع بين العلم والدين قول له وجاهته، ولكن من المؤكد أن الصراع ينشأ بين العلم الظني والقرآن، أما العلم التجريبي اليقيني، فلا يمكن أن يتعارض مع القرآن، وفي هذا الشأن يمكن أن تراجع النظريات العلمية من خلال عرضها على القرآن؛ فإن وجدت النظرية سندًا لها في القرآن، فإنه يمكنها الحصول على جواز مرور، وحتى لا نطلق الكلام على عواهنه، نضرب مثالين للتوضيح:
المثال الأول: لو أن أصحاب نظرية التطور العضوي لدارون ومؤيديه، قد تَمَّ عرضها على آيات القرآن قبل أو بعيد ظهورها، لاستراح الناس من شرورها منذ ظهورها من 150 سنة مضت؛ وذلك لأن أساس النظرية القائم على توالد الأنواع بعضها من بعض باطل؛ لأنه لم يثبت حدوث ذلك التوالد المزعوم عبر زمان الحياة بأكملها، ولو عرضت النظرية السابقة على آيات خلق الأزواج في القرآن، ما قامت لها قائمة؛ لأن الأزواج أشياء، ورب العالمين يقول في كتابه الحكيم أنه خلَق من كل شيء زوجين، وهذا إثبات لحقيقة الخلق الخاص الذي لا يستطيع عالم محترم أن يقول بغيره، انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى في هذا الشأن: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: 36]، وقوله أيضًا: ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [الزخرف: 12]، ثم تأتي في هذا السياق الآية الجامعة التي تُبطل النظرية المزعومة، وهي آية عموم الزوجية في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: 49].
أما المثال الثاني – الذي تجد فيه النظرية مصداقيتها عند عرضها على القرآن – فهي نظرية الانفجار الأعظم التي تتحدث عن مولد القرآن، فبغضِّ النظر عن مسمى النظرية، أو كيفية أصل الكون من بيضة كونية أو مفردة غريبة، فإن النظرية قد تجد صحتها من حيث أنها تثبت أن أصل الكون بأرضه وسماواته كان شيئًا مُحيَّزًا، ثم انفجر، فمر عند بدايته بمرحلة تضخُّم، أعقبها اتساع مستمر للكون حتى يومنا هذا.
وبعرض النظرية على الحقائق القرآنية ذات الصلة نجد الآتي:
1- يحسب للنظرية أنها أثبتت أن الأصل كان شيئًا مضمومًا، وهذا يوافق النص القرآني “رتقًا”؛ وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: 30].
2- فكرة التضخم الكوني التي حدثت في الحظة الأولى لمولد الكون، تجد نفسها في قوله تعالى ((﴿ فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾)).
قراءة المزيد: الدعوة إلى العمل الصالح
3- في مقابلة مصطلح التضخم يظل اللفظ المشتق من القرآن، وهو “الفتق” هو الأحق بالاتباع.
4- يجب أن يرقى مفهوم اتساع الكون من مستوى النظرية إلى مستوى الحقيقة؛ حيث إن اتساع الكون حقيقة قرآنية نجدها في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: 47].
5- سترتقى النظرية ككل إلى مستوى الحقيقة، حينما تجد لها مُسمًّا مناسبًا أقرب إلى “فتق الرتق”؛ لأن مسمى “الانفجار الأعظم” تعبير متواضع لا يعبر عن حدث خطير نتج عنه كون عظيم أو أكوان عديدة.
6- هكذا نجد القرآن ضابطًا لما اختلف فيه من العلم.
قراءة المزيد: قصة موسى مع الخضر
ومن ثَمَّ، فإن مناقشة النظريات العلمية في مجال إعجاز القرآن تعد تمحيصًا ومراجعة لها. ويستند المؤيدون للإعجاز العلمي في القرآن الكريم على أن القرآن الكريم قد اشتمل على كل صغيرة وكبيرة، وأن كل ما دخل تحت نص قرآني عام يعتبر قد نص عليه القرآن، وأن القرآن حجة على كل العباد عربهم وعجمهم، كما أن إعجاز القرآن لا ينبغي أن يكون موقوفًا على فُصحاء العرب، ومَن على شاكلتهم في فَهْم اللغة فقط، وأخيرًا احتواء القرآن على آيات كونية.
وقد لا يتفق المسلم الذي يعيش عصر العلم اليوم مع رأى أشد المعارضين قديمًا للتفسير العلمي للقرآن، وهو الإمام الشاطبي الذي يرى أنه لا يجوز أن يبحث أحد في الآيات الكونية إلا في حدود علوم العرب وقت نزول القرآن، ويتساءل المرء: أي علوم كونية كانت عند العرب عند نزول القرآن؟!
وهذا تضييق لا تسيغه ولا تقره الشريعة، وليس من الحكمة إطلاقًا الترويج لمقالات أُمية الشريعة وأُمية الرسول باقتطاع الكلمات قصرًا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (نحن أمة أُمية لا نحسب ولا نكتب)؛ حيث إن هذا الحديث تقرير لحالة الأمة حينما نزل القرآن الكريم، وليس صفة ملازمة للأمة على مر الزمان.
ولا يسع المهتم بالإعجاز العلمي للقرآن إلا أن يحترم آراء بعض المعارضين: من أمثال الشيخ العلامة محمد رشيد رضا، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ سيد قطب، فقد رأى الأول أن أكثر ما كتب في التفسير العلمي يشغل قارئ القرآن عن مقاصد القرآن، ويقول الشيخ شلتوت – شيخ الجامع الأزهر – رحمه الله: “فلندع للقرآن عظمته، ونحفظ عليه قدسيته، وحسبنا أن القرآن لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق العلوم، تطمئن إليها العقول، ومع أن الشيخ سيد قطب لا ينكر الانتفاع بما يكشفه العلم حول الكون والحياة، ألا أنه يعجب لسذاجة المتحمسين للقرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه، وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها، وأحسب أنه في ذلك كان يحذر من الانبهار بالعلم لدرجة تؤدي إلى الإحساس بالانهزام النفسي أمام حضارة الغرب المعاصرة.
قراءة المزيد: تأثير الاستماع لصوت القرآن على القلب
ويؤكد الأستاذ العقاد أننا مطالبون بفَهْم القرآن الكريم، والاستفادة من علوم العصر الذي نعيشه، ولكن من الخطأ أن نتلقى كل نظرية علمية على أنها حقيقة دائمة نحملها على معاني القرآن، ويصف الدكتور على عبدالواحد التفسير العلمي بأنه خيانة، ويتفق معه الأستاذ إسماعيل مظهر في أن التفسير بدعة ضارة غير نافعة.
نعم قد نعيب على بعض التفسيرات الجانحة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من مثل تفسير ((﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾)) بجنس البعوض، أو تأييد نظرية دارون بزعم ورود أطوار الخلق في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ [نوح: 14]، أو تفسير النفس الواحدة في خلق الإنسان في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] بأنها البروتون وأن زوجها هو الإلكترون، أو القول بأفضلية البروتين الحيواني على البروتين النباتي من مجرد قراءة الآية: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 61]، أو تفسير الدابة التي تخرج من الأرض في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ [النمل: 82] بالأقمار الصناعية.
تلك الأمثلة وغيرها التي تعكس التسرع وعدم التمكن تسيء إلى الإعجاز العلمي للقرآن، وإن كان حسن النية والحماس للقرآن وراءها.
وأنا بدوري أرى أن قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هي اليوم جهاد بالقرآن في وقت يتكالب على القرآن أعداء الأمة الإسلامية، محاولين مَحْو الكتاب واستبداله بما أسموه “بالفرقان الحق” الأمريكي بالطبع؛ لذلك فإني أرى أن تسجيل العلم الوارد بالقرآن مسألة غاية في الأهمية، بل وأرى ضرورة سؤال الآخر أن يخرج الآن العلم المكتوب عنده، والسبب في ذلك أنني أستشفُّ أنهم في فرقانهم المزعوم سيسرقون ما في القرآن من علم، ثم ينسبونه إلى فرقانهم المزعوم، بعد إعادة صياغته بطريق ماكرة، ثم يقولون ما عندكم من العلم في القرآن، إنما هو مأخوذ مما كان عندنا في كتبنا المقدسة.
قراءة المزيد: ذكر الله .. علاج للأمراض النفسية
المصدر: الألوكة












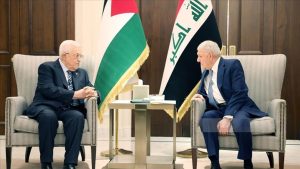










 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic