الخميس-7 ذوالقعدة 1434 الموافق 12 أيلول /سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
الشيخ نشأت كمال
المصدر: من كتاب “تعظيمُ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ووجُوبُ محبَّتِهِ وطاعتِهِ واتِّباعِ سُنَّتِهِ والذبِّ عن شريعتِهِ” للشيخ نشأت كمال
مقدمة المؤلف
إنَّ الحمد لله نحمَدُه، ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70، 71].
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
أمَّا بعدُ:
فإنَّ أصدَقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وشرَّ الأمورِ مُحدَثاتها، وكلَّ محدثة بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
وبعدُ:
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
فهذه رسالةٌ رشيقة، وعُجالة أنيقة، اسمها يُخبِر عن رسمها، وفَحواها يُشعِر بمعناها، فهي رسالةٌ صغيرة المبنى، عظيمة المعنى، وما عظم معناها إلا لشرَف مَن تتحدَّث عنه؛ وهو رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم، ولَسْنا في هذه الرسالة نتحدَّث عن أخلاق النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا سُلوكه ولا سِيرته وغَزواته وحجه، ولا متاعه وأولاده وأزواجه، بل نتحدَّث هنا عن تعظيم النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ووجوب محبَّته واتباع سنَّته – صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقد بعثَنِي على تأليفها الرَّغبة في نيل شفاعة صاحب اللواء المحمود، والحوض المورود، ولَمَّا رأيتُ من كثيرٍ من مسلمي عصري من رُكوبهم على متن عَمياء، وخبطهم كخبط العشواء، فتَراهُم في معرفة السُّنَّة وتعظيمها والعمل بها كالحُبارى في الصَّحارى، والسكارى في الصَّحارى؛ وما ذلك إلا لجهلهم بقدْر السُّنة وعدم وُصولهم إلى منازل المحبِّين المعظِّمين.
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
فأردتُ أنْ أكتُب في هذا الباب رسالةً شافية وعجالةً كافية، تشتَمِلُ على علالة فوائد المتقدِّمين، وسلالة فرائد المتأخِّرين؛ لتكون مفيدةً وهاديةً إلى الطريقة النقيَّة الصافية.
وليس المقصود ها هنا بالسُّنَّة المندوب أو المسنون أو المستحب، بل المراد أعمُّ من ذلك، فالمراد بالسُّنَّة: السيرة والطريقة، كما قال الحافظ ابن رجب[1]: “والسُّنة هي الطريق المسلوك، فيشمَلُ ذلك التمسُّك بما كان عليه – أي: النبي، صلَّى الله عليه وسلَّم – هو وخُلَفاؤه الرَّاشدون من الاعتِقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السُّنَّة الكاملة؛ ولهذا كان السلف قديمًا لا يُطلِقُون اسمَ السُّنة إلا على ما يشمَلُ ذلك كله“.
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
فالسُّنَّة بهذا المعنى هي ما كان عليه النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – من الأقوال والأفعال، هي طريقةُ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – في عبادة الله، هي حياةُ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – كلها، هي صفةُ عِبادته، وطاعته، وجهاده، وسِلمه، ونكاحه، ونومه، وقيامه، وأكله، وشربه، وقضاء حاجته، هي ذِكرُه، واستِغفاره، وتسبيحه، وحمده ومدحه لله – عزَّ وجلَّ – هي منهج النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – منذ بُعِث إلى أنْ توفَّاه الله – تعالى.
والمسلِمُ عليه أنْ يتَّبع رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – في ذلك كلِّه، وأنْ يلتزم بسنَّته وأنْ يُعظِّمها وأنْ يعمَلَ بها ويُطبِّقها كما هي من غير إفراطٍ ولا تفريط، فالمسلِمُ الذي يشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، عليه أنْ يفهَم أنَّ مُقتَضى ذلك هو عِبادةُ الله وحدَه على طريقة النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وكما عبَدَه النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – فالشهادة تَعنِي: توحيد الله في العبادة وإفراده بها وإفراد النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – بالاتِّباع والاقتِداء، فلا يكفي أنْ يُؤدِّي المسلم ما افتَرَضَه الله عليه من العبادات على أيِّ وجهٍ، بل عليه أنْ تكون عبادته على وفق ما صنَع رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كما قال: ((صلُّوا كما رأيتُمونِي أُصلِّي))، وقال: ((لتَأخُذوا عنِّي مناسِكَكُم)).
قراءة المزيد: أجمل دعاء في رمضان
وهذا يدلُّ على وُجوب فِعل العبادة، كما كان يفعَلُها النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – فنُصلِّي كما صَلَّى، ونصومُ كما صام، ونزكِّي كما زكَّى، ونحجُّ كما حجَّ، ونذكُر الله كما ذكَر، ونأمُر بالمعروف وننهى عن المنكر كما أمَر ونهى، ونُسبِّح الله كمَّا سبَّح، ونستغفرُ كما استغفَر، ونعتقدُ ما اعتقَدَه، لا نزيدُ على ذلك ولا ننقص، وهكذا في سائر العِبادات، بل والعقيدة كذلك، فإنَّ السُّنَّة تشملُ الأمور العَقَديَّة العلميَّة، والأمور التعبُّديَّة العمليَّة.
قال النووي في مقدمة كتابه “خلاصة الأحكام“: فإنَّه ينبغي لكلِّ أحدٍ أنْ يتخلَّق بأخْلاق رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام، وأنْ يعتمد في ذلك ما صحَّ، ويجتنبَ ما ضعف، ولا يغتر بِمُخالِفي السنن الصحيحة، ولا يُقلِّد مُعتَمِدي الأحاديث الضعيفة، فإنَّ الله – سبحانه وتعالى – قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7]، وقال – تعالى -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، وقال – تعالى -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31].
قراءة المزيد: توصية رمضان ١٤٣٨ ه
فهذه الآيات وما في مَعناهُنَّ حثٌّ على اتِّباعه – صلَّى الله عليه وسلَّم – ونهانا عن الابتداع والاختراع، وأمرنا الله – سبحانه وتعالى – عند التنازُع بالرُّجوع إلى الله والرسول؛ أي: الكتاب والسُّنَّة، وهذا كلُّه في سُنَّةٍ صَحَّتْ، أمَّا ما لم تصحَّ فكيف تكون سُنَّة؟! وكيف يُحكَم على رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه قاله أو فعَلَه من غير مُسوِّغ لذلك؟! ولا تغترن بكثْرة المتساهِلين، انتهى كلامه.
والواجب على المسلم أنْ يفهَمَ هذا المعنى، وأنْ يُحافِظ عليه حتى يكون بذلك مُتَّبِعًا لرسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – مُعظِّمًا لسُنَّته، مُقدِّمًا قولَه وفعلَه على كلِّ قول وفعلٍ؛ فلا يعتقدُ إلا ما اعتقَدَه رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا يتعبَّد بعبادةٍ لم يتعبَّدها رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فالقولُ قوله، والفعلُ فعله، والحكمُ حكمه، والرأيُ رأيه، والدين ما شرَعَه وبيَّنَهُ وفصَّلَهُ، فلا يُزاد على ذلك ولا ينقص منه، ولا يُعتَرض عليه، ولا يُردُّ قولُه وفعلُه، بل يُقابَل ذلك منه بالتسليم والقبول والرضا والمحبَّة والانقياد والإذعان؛ كما قال – تعالى -: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].
قراءة المزيد: أشياء يجب عليك توفيرها في موائد الرحمن خلال رمضان
وهذه الرسالة على صغر حجمها فإنها داعيةٌ إلى ذلك وهاديةٌ إليه، ودالَّة عليه من خِلال أبوابها الأربعة، وهي ما ورد من ذلك في كتاب الله، ثم في سنَّة رسوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين والأئمَّة من بعدهم، وكلُّ نصوصِها دائرةٌ على معنى واحد؛ ألا وهو تعظيمُ السُّنَّة والاتِّباع، وذم مخالفة السُّنَّة والابتِداع، وقد أسميتُها:
(تعظيم ُالنبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ووجُوبُ محبَّتِهِ وطاعتِهِ واتِّباعِ سُنَّتِهِ والذبِّ عن شريعتِهِ)
ولعلَّ هذه الرسالة تكون عونًا لإخواننا من طلبة العلم والدُّعاة والخطباء والوعَّاظ، وتكون مرجعًا لهم يتبيَّنون به عظم هذه المسألة، ووُجوب تبيينها للناس، ودلالتهم عليها، وإرشادهم وتوجيههم إليها، فكم رأينا في المسلمين من بِدَعٍ ومخالفات وبُعد عن السُّنَّة! وكم رأينا مِن المسلمين مَن يُعارِض السُّنة لشَهوةٍ أو لشُبهةٍ! وكم رأينا من المسلمين مَن يُهوِّن أمرَ السُّنة ولا يعبأ به ولا ينظر إليه! ولا حول ولا قوَّة إلا بالله.
قراءة المزيد: كيفية صلاة قيام الليل في رمضان
وقد دخَل على الناس في الدِّين دخَلٌ كثيرٌ وشُبهات وأهواء، والعِصمة من ذلك والنَّجاة في الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة.
قال ابن الجوزي: في “صيد الخاطر” (ص 193): تأملتُ الدَّخَلَ الذي دخَل في دِيننا من ناحيتي العلم والعمل، فرأيتُه من طريقين قد تقدَّما هذا الدِّين، وأنس الناس بهما، فأمَّا أصل الدَّخَل في العِلم والاعتِقاد فمن الفلسفة، وهو أنَّ خلقًا من العلماء في دِيننا، لم يقنعوا بما قنع به رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – من الانعِكاف على الكتاب والسُّنَّة، فأوغَلُوا في النَّظَرِ في مذاهب أهل الفلسفة، وخاضوا في الكلام الذي حملَهُم على مذاهب رديَّة أفسدوا بها العقائد.
قراءة المزيد: معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة
وأمَّا أصل الدَّخَلِ في باب العمل فمن الرهبانيَّة، فإنَّ خلقًا من المتزهِّدين، أخَذُوا عن الرُّهبان طريق التقشُّف، ولم ينظُروا في سِيرة نبيِّنا – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه، وسمعوا ذمَّ الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراضُ عن عِلم شرعنا مع سُوء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدعٌ قبيحة، فأوَّل ما ابتدأ به إبليس أنَّه أمرهم بالإعراض عن العلم، فدفنوا الكتب وغسلوها، وألزمهم زاوية التعبُّد فيما زعَم، وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعَل إلههم هواهم، ولو عَلِمُوا أنهم منذ دفَنوا كتبهم وفارَقوا العلم انطفأ مصباحهم، ما فعلوا، لكن إبليس كان دقيق المكر، يوم جعَل علمَهم في دفينٍ تحت الأرض، وبالعلم يُعلَمُ فسادُ الطريقين ويُهتدَى إلى الأصوب؛ نسأل الله – عزَّ وجلَّ – ألاَّ يحرمنا إياه، فإنَّه النور في الظُّلَمِ، والأنيس في الوَحدة، والوزير عند الحادثة، انتهى.
والواجب على المسلم تَتَبُّعُ سُنَّةِ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – والسؤال عنها وعن الصحيح منها، والحِرص على معرفتها وتعلُّمها والعمل بها في كلِّ عبادة يقومُ بها قوليَّة أو فعليَّة، لا يخرم عنها شيئًا في كبير أو صغير، وهذا هو تحقيق الاتِّباع الذي أُمِرْنا به، وهذا هو تحقيقُ الأسوة بالنبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وهذا هو تعظيم قدر السُّنَّة، الذي يتحقق به الأمن من الضَّلال والشَّقاء.
قال ابن الجوزي في “صيد الخاطر” (ص112): تأمَّلت قوله – تعالى -: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: 123]:
قال المفسِّرون: ﴿هُدَايَ﴾ رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وكتابي، فوجدتُه على الحقيقة أنَّ كلَّ مَن اتَّبع القُرآن والسُّنَّة وعمل بما فيهما، فقد سَلِمَ من الضلال بلا شكٍّ، وارتفع في حقِّه شقاء الآخِرة بلا شك إذا مات على ذلك، وكذلك شَقاء الدنيا فلا يشقى أصلاً.
ويُبيِّن هذا قوله – تعالى -: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2]، فإنْ رأيته في شدَّةٍ فله من اليقين بالجزاء ما يصيرُ المصاب عنده عسلاً، وإلا غلب طيب العيش في كلِّ حال، والغالب أنَّه لا ينزل به شدَّة إلا إذا انحرف عن جادَّة التقوى، فأمَّا المُلازِمُ لطريق التقوى فلا آفة تطرقه، ولا بلية تنزل به، هذا هو الأغلب، فإنْ وجد مَن تطرقه البلايا مع التقوى، فذاك في الأغلب لتقدُّم ذنبٍ يُجازَى عليه، فإنْ قدرنا عدمَ الذنب فذاك لإدخال ذَهَبِ صبرِهِ كيرَ البَلاء؛ حتى يخرج تبرًا أحمر، فهو يرى عُذوبة العذاب.
وقال أيضًا في “صيد الخاطر” (ص 188-189): وقَع بيني وبين أرباب الولايات نوعُ معاداةٍ لأجل المذهب؛ فإنِّي كنتُ في مجلس التذكير أُناظِر أنَّ القرآن كلام الله وأنَّه قديم[2]، وأُقدِّم أبا بكر، واتَّفق في أرباب الولايات مَن يميل إلى مذهب الأشعري، وفيهم مَن يميلُ إلى مذهب الروافض، وتمالَؤُوا في الباطن، فقلت يومًا في مناجاتي للحق – سبحانه وتعالى -: سيدي، نَواصِي الكلِّ بيدك، وما فيهم مَن يقدر لي على ضرٍّ إلا أنْ تجريه على يده، وأنت قلتَ – سبحانك -: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 102]، وطيَّبتَ قلب المُبتَلى بقولك: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: 51]، فإنْ أجريت على أيدي بعضهم ما يُوجِب خذلاني كان خوفي على ما نصرتُه أكثرَ من خوفي على نفسي، لئلا يقال: لو كان على حقٍّ ما خُذل، وإن نظرتُ إلى تقصيري وذُنوبي فإنِّي مستحقٌّ للخذلان، غير أنِّي أعيشُ بما نصرتُه من السُّنة، فأدخِلني في خفارته، وقد استودعني إيَّاك خلق من صالحي عبادك، فإنْ لم تحفظني بي فاحفَظْني بهم.
سيدي، انصُرني على مَن عاداني؛ فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي، وهم مُعرِضون عنك على كلِّ حال، وأنا على تقصيري إليك أُنسَبُ، انتهى كلامُه – رحمه الله – فما أحلاه!
وهذه الرسالة قد جمعتُ نُصوصها من عدَّة مصادر مثل: الصحيحين، والسنن، والمسانيد، وكتب العقيدة، والكتب التي أُلِّفتْ عن البدع، إلا أنَّني لم أر كتابًا مستقلاًّ صُنِّفَ في هذه المسألة على هذه الطريقة؛ ممَّا دفعني إلى جمْع هذه النُّصوص الكثيرة المتناثرة في كتابٍ واحد.
وقد اجتمع عندي في ذلك مِئاتُ النُّصوص عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأصحابه والتابعين والأئمَّة المتبوعين، وقد جمعتها ورتبتها في هذا التصنيف الجديد، وقد قسمتُه إلى أبوابٍ وفصول ومباحث، وقبل الدُّخول في الباب الأوَّل مهَّدت بين يدي الكتاب بتمهيدٍ ذكرت فيه كلماتٍ جامعة لمحدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – والعلامة الشيخ محمد محمد أبو شهبة وهو من علماء الأزهر الشريف.
الباب الأول: سياق الآيات الواردة في كتاب الله في تعظيم النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ووجوب محبَّته، وطاعته واتِّباع سنته، والذب عن شريعته، وتحريم أذى النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وشتمه والاستهزاء به، وبيان أنَّ ذلك كلَّه من الكُفر الأكبر, وفيه تمهيدٌ وفصلان.
الباب الثاني: في تفضيل طريقِ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – على غيره وضَرورة اتِّباعه – صلَّى الله عليه وسلَّم – وبَيان خَصائصه وعدم الغلوِّ فيه – صلَّى الله عليه وسلَّم.
البابُ الثالث: سياقُ الأحاديثِ الواردةِ في تعظيم النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وطاعته ووجوب محبَّته واتِّباع سنَّته والذب عن شريعته.
الباب الرابع: وجوب محبَّته – صلَّى الله عليه وسلَّم – أكثر من كلِّ الخلق، وبَيان مفهوم المحبَّة وعلاماتها وثمراتها.
الباب الخامس: ذكر عدَّة أحاديث في جوازِ التبرُّك بالنبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأنَّ ذلك من فضله وشرفه وتعظيمه وتوقيره، وبيان خطأ مَن قاس غيره عليه.
الباب السادس: سياقُ ما رُويَ عن أصحابِ رسولِ اللهِ – صلَّى الله عليه وسلَّم – في تعظيمِ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ووجوب محبَّته وطاعته واتِّباع سنَّته والذب عن شريعته.
الباب السابع: سياق ما رُوِي عن التابعين في تعظيم النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وتوقيره، ووجوب محبته، وطاعته واتِّباع سنته، والذب عن شريعته.
وأَوَدُّ أنْ ألفت نظَر القارئ الكريم إلى أنَّه قد يفوتُني بعضُ الأشياء، وقد أسوقُ خبرًا لا يشعُر بعض القراء بأنَّه يدلُّ على ما أريدُ، وقد يكون لدى أحدِ إخواننا القُرَّاء ما يدلُّ على ما أريدُه ولكنَّه غاب عنِّي ولم أذكُرْه، وما التوفيق في ذلك كلِّه إلا من الله – تعالى.
كما أودُّ الإشارة إلى أنِّي قد أعرضت عن ذكر بعض الآثار المرفوعة والموقوفة لضَعْفِها ووهنها، ولكن أحيانًا أذكُر بعضَ الآثار عن واحدٍ من الصحابة أو التابعين أو قول إمام، ويكون إسناد ذلك ضعيفًا، ولكنِّي رأيت أنَّ المصلحة في ذكره، والأمر في ذلك سهلٌ، أمَّا الأحاديث المرفوعة فلا.
فدونَك كتابًا يروي كلَّ غَليل، ويشفي كلَّ عَليل، ويُرشد إلى الطريق، ويُنجي – بحول الله – من الحريق.
وأرجو من كلِّ مَن ينتفعُ به أنْ يدعو لي بِحُسن الخاتمة، وخيرِ الدنيا والآخِرة، وأسأل الله أنْ يتقبَّل ذلك بقَبولٍ حسن، وأنْ يحشُرَني في زُمرة العالِمين العامِلين المُجاهِدين في سبيل إعزاز دِينه وكتابه ونبيِّه – صلَّى الله عليه وسلَّم – ونصْر الكتاب والسُّنَّة، والدعوة لهما على طريق السلف الصالح، وأنْ يرزُقني بذلك شَفاعةَ النبيِّ الكريم – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأنْ ينفَعَ به المسلمين أجمعين، وأنْ يردَّنا بفضله وكرَمِه للعمل بكتابه وسُنَّة نبيه – صلَّى الله عليه وسلَّم – وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تمهيد
كلمات جامعة بين يدي الكتاب
[1]
كلمات العلامة الألباني – رحمه الله –
لقد كتَب الشيخ الألباني – رحمه الله – في هذا الصَّدد كثيرًا في مُختلف كتبه ورسائله، وقد جمَعَه في موضعٍ واحد الشيخ أحمد بن سليمان بن أيوب في كتابه “منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني“، وقد لخَّصته وهذَّبته لك هاهنا، فجاء فيه (ص24-58):
1- تعريفات حديثيَّة:
لفظ (السُّنَّة): فإنه في اللغة: الطريقة، وهذا يشمَلُ كلَّ ما كان عليه الرَّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – من الهدى والنُّور فرضًا كان أو نفلاً، وأمَّا اصطلاحًا فهو خاصٌّ بما ليس فرضًا من هديِه – صلَّى الله عليه وسلَّم – فلا يجوزُ أنْ يُفسَّر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ (السُّنَّة) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة؛ كقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وعليكم بسنتي))، وقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فمَن رَغِبَ عن سنَّتي فليس منِّي)).
ومثله الحديثُ الذي يُورِده بعضُ المشايخ المتأخِّرين في الحضِّ على التمسُّك بالسُّنَّة بمعناها الاصطلاحي وهو: ((مَن ترك سنَّتي لم تنَلْه شفاعتي))، فأخطَؤُوا مرَّتين:
الأولى: نسبتهم الحديث إلى النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا أصل له فيما نعلمُ.
الثانية: تفسيرهم للسُّنَّة بالمعنى الاصطلاحي غفلةٌ منهم عن معناها الشرعي، وما أكثر ما يُخطِئ الناس فيما نحنُ فيه بسبب مثل هذه الغفلة!
ولهذا أكثر ما نبَّه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم – رحمهم الله – على ذلك، وأمَرُوا في تفسير الألفاظ الشرعيَّة بالرُّجوع إلى اللغة لا العُرف، وهذا في الحقيقة أصلٌ لما يُسمُّونه اليوم بـ(الدراسة التاريخيَّة للألفاظ).
2- وظيفة السُّنَّة في القُرآن:
تعلمون جميعًا أنَّ الله – تبارك وتعالى – اصطَفَى محمَّدًا – صلَّى الله عليه وسلَّم – بنبوَّته واختصَّه برسالته، فأنزَل عليه كتابَه (القُرآن الكريم)، وأمَرَه فيه في جملة ما أمَرَه به أنْ يُبيِّنه للناس؛ فقال – تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، والذي أراهُ أنَّ هذا البَيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتملُ على نوعين من البيان:
الأول: بَيان اللفظ ونظْمه، وهو تبليغُ القُرآن وعدَم كِتمانه، وأداؤه إلى الأمَّة كما أنزَلَه الله – تبارك وتعالى – على قلبِه – صلَّى الله عليه وسلَّم – وهو المراد بقوله – تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: 67]، وقد قالت السيدة عائشة – رضِي الله عنها – في حديثٍ لها: ومَن حدَّثكم أنَّ محمدًا كتَم شيئًا أُمِرَ بتبليغه، فقد أعظم على الله الفِرية، ثم تَلَتْ الآية المذكورة[3].
وفي روايةٍ لمسلم: لو كان رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كاتمًا شيئًا أُمِرَ بتبليغه لكتَم قوله – تعالى -: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37].
والآخَر: بيان معنى اللَّفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاجُ الأمَّة إلى بَيانه، وأكثَر ما يكونُ ذلك في الآيات المجملة أو العامَّة أو المطلقة، فتأتي السُّنَّة فتُوضِّح المجمل، وتُخصِّص العام، وتُقيِّد المطلق، وذلك يكونُ بقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كما يكونُ بفِعله وإقرارِه.
3- ضرورة السُّنَّة لفهْم القُرآن، وأمثلة على ذلك:
وقوله – تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] مثالٌ صالِحٌ لذلك؛ فإنَّ السارق فيه مُطلَق كاليد، فبيَّنتِ السُّنَّة القوليَّة الأوَّل منهما وقيَّدته بالسارق الذي يسرق رُبع دينار بقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا قطْع إلا في رُبع دِينار فصاعدًا))[4]، كما بيَّنت الآخَر بفِعله – صلَّى الله عليه وسلَّم – أو فِعل أصحابه وإقراره؛ فإنهم كانوا يقطَعُون يدَ السارق من عند المِفصَل كما هو معروفٌ في كتب الحديث، وبيَّنت السُّنَّة القوليَّة اليد المذكورة في آية التيمُّم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43]، بأنَّها الكف أيضًا بقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((التيمُّم ضربةٌ للوجه والكفَّيْنِ))[5].
وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لم يمكن فهمُها فهمًا صحيحًا على مُراد الله – تعالى – إلا من طريق السُّنَّة:
1 – قوله – تعالى -: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82]، فقد فَهِمَ أصحابُ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قوله: ﴿بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: 82] على عُمومه الذي يشمَلُ كلَّ ظلمٍ ولو كان صغيرًا؛ ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول الله، أيُّنا لم يلبسْ إيمانَه بظُلمٍ؟! فقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس بذلك؛ إنما هو الشِّرك، ألا تسمَعُوا إلى قول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13])).
2 – قوله – تعالى -: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، فظاهِرُ هذه الآية يقتضي أنَّ قصْر الصلاة في السفر مشروطٌ له الخوف؛ ولذلك سأل بعضُ الصحابة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقالوا: ما بالُنا نقصر وقد أمنَّا؟ قال: ((صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبَلُوا صَدَقتَه))[6].
3 – قوله – تعالى -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، فبيَّنت السُّنَّة القوليَّة أنَّ ميتة الجراد والسمك والكبد والطِّحال من الدَّم حلال؛ فقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودَمان: الجراد والحوت (أي: السَّمك بجميع أنواعه)، والكَبِدُ والطِّحال))[7].
4 – قوله – تعالى -: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، ثم جاءَتِ السُّنَّة فحرَّمت أشياء لم تُذكَرْ في هذه الآية؛ كقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ ذي نابٍ من السِّباع وكلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّيْرِ حرامٌ)).
وفي الباب أحاديثُ أخرى في النَّهي عن ذلك؛ كقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يوم خيبر: ((إنَّ الله ورسولَه يَنْهَيانِكم عن الحُمر الإنسيَّة؛ فإنها رجسٌ))[8].
5 – قوله – تعالى -: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، فبيَّنت السُّنَّة أيضًا أنَّ من الزينة ما هو محرَّم، فقد ثبَت عن النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه خرَج يومًا على أصْحابه وفي إحدى يديه حريرٌ وفي الأخرى ذهبٌ، فقال: ((هذان حَرامٌ على ذُكور أمَّتي حِلٌّ لإناثِهم))[9].
والأحاديث في مَعناه كثيرةٌ معروفةٌ في الصحيحين وغيرهما إلى غير ذلك من الأمثلةِ الكثيرةِ المعروفة لدى أهل العِلم بالحديث والفقه.
وممَّا تقدَّم يتبيَّن لنا أهميَّة السُّنَّة في التشريع الإسلامي، فإنَّنا إذا أعَدْنا النظَر في الأمثلة المذكورة فضلاً عن غيرها ممَّا لم نذكُر، نتيقَّن أنَّه لا سبيلَ إلى فهْم القُرآن الكريم فهمًا صحيحًا إلا مَقرونًا بالسُّنَّة.
ففي المثال الأوَّل: فَهِمَ الصحابة (الظُّلم) المذكور في الآية على ظاهِرِه، ومع أنهم كانوا – رضِي الله عنهم – كما قال ابن مسعود: “أفضل هذه الأمَّة؛ أبرها قُلوبًا، وأعمقها عِلمًا، وأقلها تكلُّفًا“، فإنهم مع ذلك قد أخطؤوا في ذلك الفهْم، فلولا أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ردَّهم عن خطَئِهم، وأرشدهم إلى أنَّ الصواب في (الظُّلم) المذكور إنما هو الشِّرك لاتَّبعناهم على خطَئِهم، ولكنَّ الله – تبارك وتعالى – صانَنا عن ذلك بفضْل إرشادِه – صلَّى الله عليه وسلَّم – وسنَّته.
وفي المثال الثاني: لولا الحديثُ المذكور لبقينا شاكِّين على الأقلِّ في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن، إنْ لم نذهبْ إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهرُ الآية، وكما تبادَر ذلك لبعض الصحابة، لولا أنهم رأوا رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقصر ويقصرون معه وقد أمِنُوا.
وفي المثال الثالث: لولا الحديثُ أيضًا لحرَّمنا طيباتٍ أُحِلَّتْ لنا: الجراد والسمك والكبد والطِّحال.
وفي المثال الرابع: لولا الأحاديثُ التي ذكَرْنا فيه بعضها لاستحلَلْنا ما حرَّم الله علينا على لسان نبيِّه – صلَّى الله عليه وسلَّم – من السباع وذوي المخلب من الطير.
وكذلك المثال الخامس: لولا الأحاديثُ التي فيه لاستحلَلْنا ما حرَّم الله على لسان نبيِّه من الذهب والحرير، ومن هنا قال بعضُ السَّلَفِ: السُّنَّة تقضي على الكتاب.
4- ضلال المستغنين بالقُرآن عن السُّنَّة:
ومن المؤسِف أنَّه قد وُجِدَ بعض من المفسِّرين والكُتَّاب المعاصرين مَن ذهَب إلى جَواز ما ذكر في المثالين الأخِيرين من إباحة أكْل السِّباع ولبس الذهب والحرير؛ اعتِمادًا على القُرآن فقط، بل وُجِدَ في الوقت الحاضر طائفةٌ يتسمَّوْن بـ(القُرآنيين)؛ يُفسِّرون القُرآن بأهوائهم وعُقولهم، دُون الاستعانة على ذلك بالسُّنَّة الصحيحة، بل السُّنَّة عندهم تبعٌ لأهوائهم، فما وافَقهم منها تشبَّثوا به، وما لم يُوافِقْهم منها نبَذُوه وراءهم ظِهريًّا.
وكأنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قد أشارَ إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح: ((لا أُلفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أريكتِه، يَأتِيه الأمرُ من أمري ممَّا أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقولُ: لا أدري، ما وجَدْنا في كتاب الله اتَّبَعْناه))[10].
وفي روايةٍ لغيره: ((ما وجَدْنا فيه حَرامًا حرَّمناه، ألا وإنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ ومِثلَه معه)).
وفي أُخرى: ((ألا إنَّ ما حرَّم رسولُ الله مثل ما حرَّم الله)).
بل إنَّ منَ المؤسِف أنَّ بعض الكُتَّاب الأفاضل ألَّف كتابًا في شريعة الإسلام وعقيدته، وذكَر في مقدمته أنَّه ألَّفَه وليس لديه من المراجع إلا القُرآن، فهذا الحديث الصحيح يدلُّ دلالةً قاطعةً على أنَّ الشريعة الإسلاميَّة ليست قرآنًا فقط، وإنما قُرآن وسُنَّة، فمَن تمسَّك بأحدهما دُون الآخَر لم يتمسَّكْ بأحدهما؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يأمُر بالتمسُّك بالآخَر؛ كما قال – تعالى -: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80].
وقال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].
وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].
وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وبمناسبة هذه الآية يُعجِبني ما ثبَت عن ابن مسعود – رضِي الله عنه – وهو أنَّ امرأةً جاءَتْ إليه فقالت له: أنت الذي تقولُ: لعَن الله النامصات والمتنمِّصات، والواشمات… الحديث؟ قال: نعم، قالت: فإنِّي قرأتُ كتابَ الله من أوَّله إلى آخِره فلم أجدْ فيه ما تقولُ، فقال لها: إنْ كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أمَا قرأت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7] قالت: بلى، قال: فقد سمعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((لعَن الله النامِصات…)) الحديث[11].
5- عدم كفاية اللغة لفهْم القُرآن:
وممَّا سبق يبدو واضحًا أنَّه لا مجالَ لأحدٍ مهما كان عالِمًا باللغة العربية وآدابها أنْ يفهَم القُرآن الكريم دُون الاستعانة على ذلك بسُنَّة النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – القوليَّة والفعليَّة؛ فإنَّه لم يكن أعلم في اللغة من أصحاب النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – الذين نزَل القُرآن بلُغتهم، ولم تكنْ قد شابَتْها لوثة العجمة والعاميَّة واللحن، ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهْم الآيات السابقة حين اعتمَدُوا على لغتهم فقط.
وعليه فمن البدهي أنَّ المرء كلَّما كان عالِمًا بالسُّنَّة كان أحرى بفهْم القُرآن واستِنباط الأحكام منه ممَّن هو جاهلٌ بها، فكيف بِمَن هو غير مُعتَدٍّ بها، ولا ملتفت إليها أصلاً؟!
ولذلك كان من القواعد المتَّفق عليها بين أهل العلم: أنْ يُفسَّر القُرآن بالقُرآن والسُّنَّة، ثم بأقوال الصحابة… إلخ.
ومن ذلك يتبيَّن لنا ضلالُ عُلَماء الكلام قديمًا وحديثًا ومخالفتهم للسَّلَفِ – رضِي الله عنهم – في عَقائدهم، فضلاً عن أحكامهم، وهو بُعدُهم عن السُّنَّة والمعرفة بها، وتحكيمهم عقولَهم وأهواءَهم في آيات الصِّفات وغيرها، وما أحسن ما جاء في “شرح العقيدة الطحاوية” (ص212 الطبعة الرابعة):
“وكيف يتكلَّم في أصول الدِّين مَن لا يتلقَّاه من الكتاب والسُّنَّة، وإنما يتلقَّاه من قول فلان؟ وإذا زعَم أنَّه يأخُذه من كتاب الله لا يتلقَّى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا ينظُر فيها، ولا فيما قالَه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النُّقَّاد، فإنهم لم ينقلوا نظْم القُرآن وحدَه، بل نقلوا نظمَه ومعناه، ولا كانوا يتعلَّمون القُرآن كما يتعلَّم الصِّبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومَن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلَّم برأيه، ومَن يتكلم برأيه وبما يظنُّه دِين الله، ولم يتلقَّ ذلك من الكتاب فهو مأثومٌ وإنْ أصاب، ومَن أخَذ من الكتاب والسُّنَّة فهو مأجورٌ وإنْ أخطأ، لكن إنْ أصاب يُضاعف أجره“.
ثم قال (ص 217): “فالواجب كمالُ التسليم للرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – والانقيادُ لأمره، وتلقِّي خبره بالقبول والتصديق، دون أنْ نُعارِضه بخيالٍ باطلٍ نُسمِّيه معقولاً، أو نحمله شبهةً أو شكًّا أو نُقدِّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنُوحِّده – صلَّى الله عليه وسلَّم – بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نُوحِّد المرسِل – سبحانه وتعالى – بالعبادة والخُضوع والذلِّ والإنابة والتوكُّل“.
وجملة القول: إنَّ الواجب على المسلمين جميعًا ألاَّ يُفرِّقوا بين القُرآن والسُّنَّة من حيث وُجوب الأخْذ بهما كليهما، وإقامة التشريع عليهما معًا؛ فإنَّ هذا هو الضَّمان لهم ألاَّ يميلوا يمينًا ويسارًا، وألاَّ يرجعوا القَهقَرى ضلالاً.
كما أفصح عن هذا رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – بقوله: ((تركتُ فيكم أمرَيْن لن تضلُّوا ما إنْ تمسَّكتُم بهما: كتاب الله وسنَّتي، ولن يتَفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ))[12].
تنبيه مهم:
ومن البدهي بعد هذا أنْ نقول: إنَّ السُّنَّة التي لها هذه الأهميَّة في التشريع إنما هي السُّنَّة الثابتة عن النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – بالطُّرق العلميَّة والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله، وليست هي التي في بُطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها، فإنَّ فيها كثيرًا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، وبعضها ممَّا يتبرَّأ منه الإسلام؛ مثل حديث هاروت وماروت وقصة الغرانيق.
فالواجب على أهل العلم ولا سيَّما الذين ينشُرون على الناس فقهَهم وفتاويهم ألاَّ يتجرَّؤُوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكُّد من ثبوته، فإنَّ كتب الفقه التي يَرجِعون إليها عادةً مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصلَ له كما هو معروفٌ عند العلماء.
6- ضعف حديث معاذ في الرأي وما يُستَنكر منه:
وقبل أنْ أنهي كلمتي هذه أرى أنَّه لا بُدَّ لي مِن أنْ ألفت الانتباه إلى حديثٍ مشهور قلَّما يخلو منه كتابٌ من كُتُب أصول الفقه لضَعفِه من حيث إسناده، ولتعارُضِه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جَواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسُّنَّة، ووجوب الأخْذ بهما معًا، ألا وهو حديث معاذ بن جبل – رضِي الله عنه – أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال له حين أرسَلَه إلى اليمن: ((بِمَ تحكُم؟)) قال: بكتاب الله، قال: ((فإن لم تجدْ؟))، قال: بسنَّة رسول الله، قال: ((فإن لم تجدْ؟))، قال: أجتهدُ رأيي ولا آلُو، قال: ((الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يحبُّ رسولُ الله)).
أمَّا ضعْف إسناده فلا مجالَ لبيانه الآن، وحسبي أنْ أذكُر أنَّ أمير المؤمنين في الحديث؛ الإمام البخاري – رحمه الله تعالى – قال فيه: (حديث منكر)، وبعد هذا يجوزُ لي أنْ أشرع في بَيان التعارُض الذي أشرت إليه فأقول:
إنَّ حديث معاذ هذا يَضَعُ للحاكم منهجًا في الحُكم على ثلاث مراحل: لا يجوزُ أنْ يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد ألا يجده في السُّنَّة، ولا في السُّنَّة إلا بعد ألا يجده في القُرآن، وهو بالنسبة للرأي منهجٌ صحيحٌ لدى كافَّة العلماء، وكذلك قالوا: إذا ورَد الأثر بطَل النظَر، ولكنَّه بالنسبة للسُّنَّة ليس صحيحًا؛ لأنَّ السُّنَّة حاكمة على كتاب الله ومبيِّنة له، فيجب أنْ يبحث عن الحكم في السُّنَّة، ولو ظنَّ وجوده في الكتاب لما ذكرنا، فليست السُّنَّة مع القُرآن كالرأي مع السُّنَّة، كلا ثم كلا، بل يجبُ اعتبار الكتاب والسُّنَّة مصدرًا واحدًا لا فصْل بينهما أبدًا؛ كما أشار إلى ذلك قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألا إنِّي أُوتِيت القُرآنَ ومثلَه معه))؛ يعني: السُّنَّة، وقوله: ((لن يتفرَّقَا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ)).
فالتصنيفُ المذكورُ بينهما غير صحيح؛ لأنَّه يقتضي التفريقَ بينهما، وهذا باطلٌ لما سبق بيانه، فهذا هو الذي أردت أنْ أنبِّه إليه، فإنْ أصبت فمن الله، وإنْ أخطأت فمن نفسي، والله – تعالى – أسأَلُ أنْ يعصمنا وإيَّاكم من الزلَل، ومن كلِّ ما لا يرضيه، وآخِر دَعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.
7- وجوب الرُّجوع إلى السُّنَّة وتحريم مخالَفتها:
إنَّ من المتَّفق عليه بين المسلمين الأوَّلين كافَّةً أنَّ السُّنَّة النبويَّة – على صاحبها أفضَلُ الصَّلاة والسَّلام – هي المرجِع الثاني والأخير في الشَّرع الإسلامي في كلِّ نواحي الحياة من أمورٍ غيبيَّة اعتقاديَّة، أو أحكام عمليَّة أو سياسيَّة أو تربويَّة، وأنَّه لا يجوزُ مخالفتها في شيءٍ من ذلك لرأيٍ أو اجتهادٍ أو قياسٍ؛ كما قال الإمام الشافعي – رحمه الله – في آخر “الرسالة“:”لا يحلُّ القياس والخبَرُ موجودٌ“، ومثله ما اشتهر عند المتأخِّرين من علماء الأصول: “إذا ورَد الأثر بطل النظَرُ“، و“لا اجتهادَ في مورد النصِّ“، ومستندُهم في ذلك الكتاب الكريم والسُّنَّة المطهَّرة.
8- القُرآن يأمُر بالاحتكام إلى سُنَّة الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم:
أمَّا الكتاب ففيه آياتٌ كثيرة أجتَزِئ بذِكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذِّكرى؛ فإنَّ الذكرى تنفَعُ المؤمنين.
1 – قال – تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].
2 – وقال – عزَّ وجلَّ -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 1].
3- وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 32].
4 – وقال – عزِّ مِن قائل -: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا *مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 79-80].
5 – وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59].
6 – وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 46].
7 – وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: 92].
8 – وقال: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
9 – وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: 24].
10 – وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13، 14].
11 – وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: 60، 61].
12 – وقال – سبحانه -: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: 51، 52].
13 – وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7].
14 – وقال – تعالى -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].
15 – وقال: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 1 – 4].
16 – وقال – تبارك وتعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].
الأحاديث الداعية إلى اتِّباع النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – في كلِّ شيء:
وأمَّا السُّنَّة ففيها الكثيرُ الطيِّب ممَّا يُوجِبُ علينا اتِّباعه – عليه الصلاة والسلام – اتِّباعًا عامًّا في كلِّ شيءٍ من أمور دِيننا، وإليكم النُّصوص الثابتة منها:
1 – عن أبي هريرة – رضِي الله عنه – أنَّ رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((كلُّ أمَّتي يدخُلون الجنَّة إلا مَن أبَى))، قالوا: ومَن يأبَى؟ قال: ((مَن أطاعَنِي دخَل الجنَّة، ومَن عَصاني فقد أبى))؛ أخرجه البخاري في“صحيحه” كتاب الاعتصام.
2 – عن جابر بن عبدالله – رضِي الله عنهما – قال: “جاءت ملائكةٌ إلى النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وهو نائمٌ، فقال بعضهم: إنَّه نائم، وقال بعضهم: إنَّ العين نائمةٌ والقلب يقظان، فقالوا: إنَّ لصاحبكم هذا مثلاً فاضرِبُوا له مَثَلاً، فقالوا: مثَلُه كمَثَلِ رجلٍ بنى دارًا، وجعَل فيها مَأدُبةً، وبعث داعيًا، فمَن أجاب الداعي دخَل الدار وأكَل من المأدُبة، ومَن لم يجبِ الدَّاعِي لم يَدخُلِ الدار ولم يَأكُل من المأدُبة، فقالوا: أوِّلُوها يفقهها، فقال بعضهم: إنَّه نائم، وقال بعضهم: إنَّ العين نائمةٌ والقلب يَقظان، فقالوا: فالدار الجنَّة، والدَّاعي محمدٌ – صلَّى الله عليه وسلَّم – فمَن أطاع محمدًا – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقد أطاع الله، ومَن عصَى محمدًا – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقد عصَى الله، ومحمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – فرقٌ بين الناس”؛ أخرجه البخاري أيضًا.
3 – عن أبي موسى – رضِي الله عنه – عن النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((إنما مثَلِي ومثَل ما بعثَنِي الله به كمثَل رجلٍ أتى قومًا، فقال: يا قوم، إنِّي رأيتُ الجيش بعيني، وإنِّي أنا النَّذيرُ العُريان، فالنَّجاءَ النَّجاءَ، فأطاعَه طائفةٌ من قومه فأَدْلَجُوا، فانطلَقُوا على مهلهم فنجوا، وكذَّبت طائفةٌ منهم فأصبحوا مَكانهم فصبَّحهم الجيشُ فأهلكهم واجتاحَهم، فذلك مثَل مَن أطاعني فاتَّبع ما جِئتُ به، ومثل مَن عَصاني وكذَّب بما جئتُ به من الحق))؛ أخرجه البخاري ومسلم.
4 – عن أبي رافعٍ – رضِي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا أُلفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أريكته، يَأتِيه الأمرُ من أمري ممَّا أمرتُ به أو نهيتُ عنه فيقولُ: لا أدري، ما وجَدْنا في كتاب الله اتَّبَعْناه، وإلا فلا))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحَّحه وابن ماجه والطحاوي وغيرهم بسندٍ صحيح.
5 – عن المقدام بن مَعدِي كَرِب – رضِي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألا إنِّي أُوتِيتُ القُرآن ومثله معه، ألا يُوشِك رجلٌ شبعان على أريكته يقولُ: عليكم بهذا القُرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه، وإنَّ ما حرَّم رسولُ الله كما حرَّم الله، ألا لا يحلُّ لكم الحمار الأهلي، ولا كلُّ ذي نابٍ من السِّباع، ولا لُقَطة مُعاهد إلا أنْ يستغنِي عنها صاحبُها، ومَن نزل بقومٍ فعليهم أنْ يَقرُوه، فإنْ لم يَقرُوه فله أنْ يُعقِبَهم بمثْل قِراه))؛ رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصحَّحه، وأحمد بسندٍ صحيح.
6 – عن أبي هريرة – رضِي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تركتُ فيكم شيئين لن تضلُّوا بعدَهما ما تمسَّكتُم بهما: كتاب الله وسُنَّتي، ولن يتَفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ))؛ أخرجه مالك مرسلاً، والحاكم مسندًا وصحَّحه.
ما تدلُّ عليه النصوص السابقة:
وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمورٌ مهمَّة جِدًّا يمكن إجمالها فيما يلي:
1 – أنَّه لا فرْق بين قَضاء الله وقَضاء رسوله، وأنَّ كلاًّ منهما ليس للمؤمن الخيرة في أنْ يُخالِفَهما، وأنَّ عِصيان الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – كعِصيان الله – تعالى – وأنَّه ضلالٌ مبين.
2 – أنَّه لا يجوزُ التقدُّم بين يدي الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – كما لا يجوزُ التقدُّم بين يدي الله – تعالى – وهو كنايةٌ عن عدم جَواز مُخالَفة سنَّته – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال الإمام ابن القيِّم في “إعلام الموقعين“(1/58): أي: لا تقولوا حتى يقول، وتأمُروا حتى يأمُر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطَعُوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكُم فيه ويمضي.
3 – أنَّ المطيع للرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – مطيعٌ لله – تعالى.
4 – أنَّ التولِّي عن طاعة الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – إنما هو من شأن الكافِرين.
5 – وُجوب الردِّ والرُّجوع عند التنازُع والاختِلاف في شيءٍ من أمور الدِّين إلى الله وإلى الرَّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال ابن القيِّم – رحمه الله – (1/54): فأمَر – تعالى – بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل (يعني قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾) إعلامًا بأنَّ طاعته تجبُ استقلالاً من غير عرض ما أمَر به على الكتاب، بل إذا أمَر وجبت طاعته مُطلقًا؛ سواء كان ما أمَر به في الكتاب أو لم يكنْ فيه فإنَّه أُوتِي الكتاب ومثله معه، ولم يأمرْ بطاعة أولي الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضِمن طاعة الرسول.
ومن المتَّفق عليه عند العلماء أنَّ الردَّ إلى الله إنما هو الردُّ إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، وإلى سنَّته بعد وفاته، وأنَّ ذلك من شُروط الإيمان.
6- أنَّ الرضا بالتنازُع بترْك الرُّجوع إلى السُّنَّة للخَلاص من هذا التنازُع سببٌ مهمٌّ في نظَر الشرع لإخْفاق المسلمين في جميع جُهودهم ولذَهاب قوَّتهم وشَوْكتهم.
7- التحذير من مُخالَفة الرَّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – لما لها من العاقبة السيِّئة في الدُّنيا والآخِرة.
8- استِحقاق المخالفين لأمْره – صلَّى الله عليه وسلَّم – الفتنة في الدُّنيا والعَذاب الأليم في الآخِرة.
9- وُجوب الاستِجابة لدَعوة الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأمره، وأنها سببُ الحياة الطيِّبة والسَّعادة في الدنيا والآخِرة.
10- أنَّ طاعة النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – سببٌ لدُخول الجنَّة والفوز العظيم، وأنَّ معصيتَه وتجاوز حُدوده سببٌ لدخول النار والعذاب المهين.
11- أنَّ من صِفات المنافقين الذين يتظاهَرُون بالإسلام ويُبطِنون الكُفر أنهم إذا دُعوا إلى أنْ يتحاكَمُوا إلى الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – وإلى سنَّته، لا يستَجِيبون لذلك بل يصدُّون عنه صُدودًا.
12- وأنَّ المؤمنين على خِلاف المنافقين؛ فإنهم إذا دُعوا إلى التحاكُم إلى الرَّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – بادَرُوا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم ومَقالهم: (سمعنا وأطعنا)، وأنهم بذلك يَصِيرون مُفلِحين، ويكونون من الفائزين بجنَّات النعيم.
13- كلُّ ما أمَرَنا به الرسولُ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يجبُ علينا اتِّباعه فيه، كما يجبُ علينا أنْ ننتهي عن كلِّ ما نَهانا عنه.
14- أنَّه – صلَّى الله عليه وسلَّم – أسوَتُنا وقُدوتنا في كلِّ أمور دِيننا إذا كنَّا ممَّن يرجو الله واليومَ الآخِر.
15- وأنَّ كلَّ ما نطَق به رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ممَّا له صلةٌ بالدِّين والأمور الغيبيَّة التي لا تُعرَف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحيٌ من الله إليه ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: 42].
16- وأنَّ سنَّته – صلَّى الله عليه وسلَّم – هي بيانٌ لما أنزَل إليه من القُرآن.
17- وأنَّ القُرآن لا يُغنِي عن السُّنَّة، بل هي مِثْلُه في وُجوب الطاعة والاتِّباع، وأنَّ المستغنِي به عنها مخالفٌ للرسول – عليه الصلاة والسلام – غير مُطِيعٍ له، فهو بذلك مخالفٌ لما سبَق من الآيات.
18- أنَّ ما حرَّم رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – مثل ما حرَّم الله، وكذلك كلُّ شيء جاءَ به رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ممَّا ليس في القُرآن فهو مثل ما لو جاء في القُرآن لعُموم قوله: ((ألا إنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ ومثلَه معه)).
19- أنَّ العصمة من الانحِراف والضَّلال إنما هو التمسُّك بالكتاب والسُّنَّة، وأنَّ ذلك حكمٌ مستمرٌّ إلى يوم القيامة، فلا يجوزُ التفريق بين كتاب الله وسنَّة نبيِّه – صلَّى الله عليه وسلَّم – تسليمًا كثيرًا.
لُزوم اتباع السُّنَّة على كلِّ جيلٍ في العقائد والأحكام:
هذه النُّصوص المتقدِّمة من الكتاب والسُّنَّة كما أنها دلَّت دلالةً قاطعةً على وُجوب اتِّباع السُّنَّة اتِّباعًا مُطلَقًا في كلِّ ما جاء به النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأنَّ مَن لم يرضَ بالتحاكُم إليها والخضوع لها فليس مؤمنًا، فإنِّي أريدُ أنْ ألفت نظَرَكم إلى أنها تدلُّ بعُموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخَرين مهمَّيْن أيضًا:
الأول: أنَّها تشمَلُ كلَّ مَن بلغَتْه الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريحٌ في قوله – تعالى -: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19]، وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28].
وفسَّرَه – صلَّى الله عليه وسلَّم – بقوله في حديث: ((وكان النبيُّ يُبعَثُ إلى قَوْمِه خاصَّةً وبُعِثتُ إلى الناس كافَّة))؛ متفق عليه، وقوله: ((والذي نفسي بيَدِه لا يسمَعُ بي رجلٌ من هذه الأمَّة، ولا يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم لم يؤمنْ بي، إلا كان من أهل النار))؛ رواه مسلم وابن منده وغيرهما، راجع“الصحيحة” 157.
والثاني: أنها تشمَلُ كلَّ أمرٍ من أمور الدِّين، لا فرْق بين ما كان منه عقيدة عِلميَّة أو حُكمًا عمليًّا أو غير ذلك، فكما كان يجبُ على كلِّ صحابيٍّ أنْ يؤمن بذلك كلِّه حين يبلغه من النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أو من صحابيٍّ آخَر عنه، كان يجب كذلك على التابعي حين يبلُغه عن الصحابي، فكما كان لا يجوزُ للصحابي مثلاً أنْ يردَّ حديثَ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – إذا كان في العقيدة بحجَّة أنَّه خبرُ آحادٍ سمعَه عن صحابيٍّ مثله عنه – صلَّى الله عليه وسلَّم – فكذلك لا يجوزُ لِمَن بعدَه أنْ يردَّه بالحجَّة نفسها ما دام أنَّ المخبِر به ثقةٌ عنده، وهكذا ينبغي أنْ يستمرَّ الأمر إلى أنْ يَرِثَ الله الأرضَ ومَن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمَّة المجتهدين كما سيأتي النصُّ بذلك عن الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى.
تحكُّم الخلف بالسُّنَّة بدلاً منَ التَّحاكُم إليها:
ثم خلَف من بعدِهم خلفٌ أضاعوا السُّنَّة النبويَّة، وأهمَلُوها بسبب أصولٍ تبنَّاها بعضُ عُلَماءِ الكلام وقواعد زعَمَها بعضُ عُلَماء الأصول والفُقَهاء المقلِّدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدَّى بدوره إلى الشكِّ في قسمٍ كبير منها، ورد قسمٍ آخَر منها لِمُخالَفتها لتلك الأصول والقواعد، فتبدَّلت الآية عند هؤلاء، فبدلاً من أنْ يَرجِعُوا بها إلى السُّنَّة ويتحاكَموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجَعُوا بالسُّنَّة إلى قَواعِدهم وأصولهم، فما كان منها مُوافِقًا لقواعدهم قَبِلُوه وإلا رفَضُوه، وبذلك انقطعت الصلة التامَّة بين المسلم وبين النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وخاصَّة عند المتأخِّرين منهم، فعادوا جاهِلين بالنبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وعقيدته وسِيرته، وعِبادته وصِيامه وقيامه، وحجه وأحكامه وفتاويه، فإذا سُئِلُوا عن شيء من ذلك أجابُوك إمَّا بحديثٍ ضعيف أو لا أصل له، أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتَّفق أنَّه مخالفٌ للحديث الصحيح وذُكِّروا به لا يَذكُرون ولا يقبَلُون الرُّجوع إليه لشُبهاتٍ لا مجالَ لذِكرها الآن، وكلُّ ذلك سببُه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبًا ذِكرُ بعضها – إن شاء الله تعالى.
ولقد عمَّ هذا الوَباء، وطمَّ كلَّ البلاد الإسلاميَّة والمجلات العلميَّة والكتب الدينيَّة إلا نادرًا، فلا تجدُ مَن يفتي فيها على الكتاب والسُّنَّة إلا أفرادًا قليلين غُرَباء، بل جماهيرهم يعتَمِدُون فيها على مذهبٍ من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحةً – كما زعَمُوا – وأمَّا السُّنَّة فقد أصبحت عندهم نسيًا منسيًّا، إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخْذ بها كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباسٍ في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنَّه كان على عهْد النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – طلقة واحدة، فقد أنزَلُوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا قبل أنْ يتبنوه يُحارِبُونه ويُحارِبون الداعي إليه.
9- غُربة السُّنَّة عند المتأخِّرين:
وإنَّ ممَّا يدلُّ على غُربة السُّنَّة في هذا الزَّمان وجهْل أهل العلم والفتوى بها جَواب إحدى المجلات الإسلاميَّة السيَّارة عن سؤال: هل تُبعَث الحيوانات… ونصه:
قال الإمام الألوسي في “تفسيره“: ليس في هذا الباب – يعني: بعْث الحيوانات – نصٌّ من كتابٍ أو سنَّةٍ يُعوَّل عليه يدلُّ على حشْر غير الثَّقلَين من الوحوش والطيور.
هذا كلُّ ما اعتَمَده المجيب، وهو شيءٌ عجيب يدلُّكم على مَبلَغِ إهمال أهلِ العلم فضلاً عن غيرهم لعِلم السُّنَّة؛ فقد ثبت فيها أكثرُ من حديث واحد يُصرِّح بأنَّ الحيوانات تُحشَر ويقتصُّ لبعضها من بعض، من ذلك حديث مسلم في “صحيحه“: ((لتُؤَدُنَّ الحقوقَ إلى أهلها حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القَرْناء))، وثبت عن ابن عمرٍو وغيره أنَّ الكافر حين يَرى هذا القصاص يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبأ: 40].
أصول الخَلَفِ التي تُرِكت السُّنَّة بسببها:
فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامَها الخَلَفُ حتى صرفَتْهم عن السُّنَّة دراسةً واتِّباعًا؟
وجوابًا عن ذلك أقولُ: يمكن حَصْرُها في الأمور الآتية:
الأول: قول بعض عُلَماء الكلام: إنَّ حديث الآحاد لا تثبُت به عقيدةٌ، وصرَّح بعض الدُّعاة الإسلاميِّين اليوم بأنَّه لا يجوزُ أخْذ العقيدة منه، بل يحرُم!
الثاني:بعض القواعد التي تبنَّتْها بعض المذاهب المتَّبَعة في (أصولها)يحضرني الآن منها ما يلي:
أ– تقديم القياس على خبر الآحاد (“الإعلام” 1 / 327 و300، “شرح المنار” ص 623).
ب– رد خبر الآحاد إذا خالَف الأصول (“الإعلام” 1 / 329، “شرح المنار” ص 646).
ج– رد الحديث المتضمِّن حكمًا زائدًا على نصِّ القُرآن؛ بدعوى أنَّ ذلك نسخٌ له، والسُّنَّة لا تنسخ القُرآن (“شرح المنار” ص 647، “الأحكام” 2 / 66).
د– تقديم العامِّ على الخاصِّ عند التعارُض أو عدم جَواز تخصيص عُموم القُرآن بخبر الواحد (“شرح المنار” ص 289 – 294، “إرشاد الفحول” 138 – 139 – 143 – 144).
هـ– تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح.
الثالث: التقليد واتِّخاذه مذهبًا ودينًا.
10- بُطلان تقديم القياس وغيره على الحديث:
إنَّ ردَّ الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبَق ذكرُها مثل ردِّه بِمُخالفة أهل المدينة له لهو مخالفةٌ صريحةٌ لتلك الآيات والأحاديث المتقدِّمة القاضية بوجوب الرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة عند الاختلاف والتَّنازُع.
وممَّا لا شكَّ فيه عند أهل العلم أنَّ ردَّ الحديث لمثْل ما ذكَرْنا من القواعد ليس ممَّا اتَّفق عليه أهلُ العلم كلُّهم، بل إنَّ جماهير العلماء يُخالِفون تلك القواعد ويُقدِّمون عليها الحديث الصحيح اتِّباعًا للكتاب والسُّنَّة، كيف لا، مع أنَّ الواجب العمل بالحديث ولو مع ظنِّ الاتفاق على خِلافه أو عدم العلم بِمَن عَمِلَ به.
قال الإمام الشافعي في “الرسالة” (ص 463 / 464): ويجبُ أنْ يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإنْ لم يمضِ عملٌ من الأئمَّة بمثْل الخبر.
وقد قال العلاَّمة ابن القيِّم في “إعلام الموقعين” (1/32 – 33): ولم يكن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – يُقدِّم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قولَ صاحب، ولا عدم عِلمه بالمخالف الذي يُسمِّيه كثيرٌ من الناس إجماعًا، ويُقدِّمونه على الحديث الصحيح.
وقد كذَّب أحمد مَن ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسوِّغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضًا نصَّ في رسالته الجديدة على أنَّ ما لا يعلم فيه بخلافٍ لا يُقال له: إجماع، ونصوص رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – أجلُّ عند الإمام أحمد وسائر أئمَّة الحديث من أنْ يُقدِّموا عليها ما توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطَّلت النُّصوص، وساغ لكلِّ مَن لم يعلم مُخالِفًا في حُكم مسألة أنْ يُقدِّم جهله بالمخالف على النُّصوص.
وقال ابن القيِّم أيضًا (3/464 – 465): وقد كان السلف الطيِّب يشتدُّ نكيرهم وغضبُهم على مَن عارَض حديث رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – برأيٍ أو قياسٍ أو استحسان أو قول أحدٍ من الناس كائنًا مَن كان، ويهجرون فاعل ذلك، ويُنكِرون على مَن ضرَب له الأمثال، ولا يُسوِّغون غيرَ الانقياد له – صلَّى الله عليه وسلَّم – والتسليم والتلقِّي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقُّف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يُوافِق قول فلان وفلان، بل كانوا عامِلين بقوله – تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36] وأمثاله (ممَّا تقدم) فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه قال كذا وكذا، يقول: مَن قال بهذا؟ دفعًا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجَّة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعَلِمَ أنَّ هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنَّه لا يحلُّ له دفع سُنَنِ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – بمثْل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عُذره في جهله؛ إذ يعتقدُ أنَّ الإجماع منعقدٌ على مخالفة تلك السُّنَّة، وهذا سُوء ظنٍّ بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتِّفاقهم على مخالفة سنَّة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأقبح من ذلك عُذره في دَعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بِمَن قال بالحديث، فعاد الأمرُ إلى تقديم جهله على السُّنَّة، والله المستعان.
قلت: وإذا كان هذا حال مَن يُخالِف السُّنَّة، وهو يظنُّ أنَّ العلماء اتَّفقوا على خِلافها، فكيف يكونُ حال مَن يُخالِفها إذا كان يعلم أنَّ كثيرًا من العلماء قد قالوا بها، وأنَّ مَن خالَفَها لا حجَّةَ له إلا من مثْل تلك القَواعد المشار إليها أو التقليد.
سبب الخطأ في تقديم القياس وأصولهم على الحديث:
ومَنشَأُ الخطأ في تقديمهم القواعد المُشار إليها على السُّنَّة في نظَرِي إنَّما هو نظرتهم إلى السُّنَّة أنها في مَرتَبةٍ دُون المرتبة التي أنزَلَها الله – تبارك وتعالى – فيها من جهةٍ، وفي شكِّهم في ثُبوتها من جهةٍ أخرى، وإلا فكيف جازَ لهم تقديمُ القياس عليها علمًا بأنَّ القياس قائمٌ على الرأي والاجتهاد، وهو مُعرَّض للخطأ كما هو معلومٌ؛ ولذلك لا يُصار إليه إلا عِند الضرورة، كما تقدَّم في كلمة الشافعي – رحمه الله -: لا يحلُّ القياس والخبر موجودٌ؟
وكيف جازَ لهم تقديمُ عملِ أهل بعض البلاد عليها وهم يعلَمُون أنهم مأمورون بالتحاكُم إليها عند التَّنازُع كما سلَف؟
وما أحسن قول الإمام السبكي في صَدَدِ المُتَمذهب بمذهب يجدُ حديثًا لم يأخُذ به مذهبه، ولا عَلِمَ قائلاً به من غير مذهبه: والأَولى عندي اتِّباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وقد سمع ذلك منه، أيَسَعُه التأخُّر عن العمل به؟ لا والله، وكلُّ أحدٍ مُكلَّف بحسب فهمه.
قلت: وهذا يُؤيِّد ما ذكَرْنا من أنَّ الشكَّ في ثُبوت السُّنَّة هو ممَّا رَماهم في ذاك الخطأ، وإلا فلو كانوا على علمٍ بها وأنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قد قالها لم يتفوَّهوا بتلك القواعد فضلاً عن أنْ يُطبِّقوها، وأنْ يُخالِفوا بها مِئات الأحاديث الثابتة عن النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا مُستَندَ لهم في ذلك إلا الرَّأي والقياس واتِّباع عمل طائفةٍ من الناس كما ذكرنا، وإنما العمل الصحيح ما وافَق السُّنَّة، والزيادة على ذلك زيادةٌ في الدِّين، والنَّقص منه نقصٌ في الدِّين، قال ابن القيم (1/299) مُفسِّرًا للزيادة والنَّقص المذكورين:
فالأول: القياس، والثاني: التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدِّين، ومَن لم يقفْ مع النُّصوص فإنَّه تارة يزيدُ في النصِّ ما ليس منه، ويقول: هذا قياس، ومرَّة ينقص منه بعض ما يقتَضِيه ويخرجه عن حُكمه ويقول: هذا تخصيص، ومرَّة يترُك النصَّ جملةً ويقول: ليس العمل عليه، أو يقول: هذا خِلافُ القياس أو خِلاف الأصول.
(قال): ونحن نرى أنَّه كلَّما اشتدَّ توغُّل الرجل في القياس اشتدَّت مخالفته للسنن، ولا نرى خِلاف السنن والآثار عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سُنَّةٍ صحيحةٍ صريحةٍ قد عُطِّلَتْ به! وكم من أثرٍ درس حكمه بسببه! فالسنن والآثار عند الآرائيِّين والقياسيِّين خاويةٌ على عُروشها، مُعطَّلة أحكامها، معزولة عن سُلطانها وولايتها، لها الاسمُ ولغيرها الحكمُ، لها السكَّة والخطبة ولغيرها الأمرُ والنهي، وإلا فلماذا تُرِكت؟!
11- وجوب اتِّباع السُّنَّة:
إنَّ الأمَّة قد انقسَمتْ إلى فِرَقٍ ومذاهب لم تكنْ في القرن الأوَّل، ولكلِّ مذهبٍ أصولُه وفروعُه، وأحاديثُه التي يستدلُّ بها ويعتمد عليها، وأنَّ المتمذهِب بواحدٍ منها يتعصَّب له ويتمسَّك بكلِّ ما فيه، دون أنْ يلتفتَ إلى المذاهب الأخرى وينظُر؛ لعلَّه يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلَّده، فإنَّ من الثابت لدى أهل العلم أنَّ في كلِّ مذهبٍ من السُّنَّة والأحاديث ما لا يُوجَد في المذهب الآخَر، فالمتمسِّك بالمذهب الواحد يضلُّ، ولا بُدَّ عن قسمٍ عظيم من السُّنَّة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى، وليس على هذا أهلُ الحديث؛ فإنهم يأخُذون بكلِّ حديثٍ صحَّ إسنادُه في أيِّ مذهبٍ كان، ومن أيِّ طائفةٍ كان راويه ما دامَ أنَّه مسلم ثقة، حتى لو كان شيعيًّا أو قدريًّا أو خارجيًّا، فضلاً عن أنْ يكون حنفيًّا أو مالكيًّا أو غير ذلك، وقد صرَّح بهذا الإمامُ الشافعي – رضِي الله عنه – حين خاطَب الإمام أحمد بقوله: “أنتم أعلَمُ بالحديث منِّي، فإذا جاءكم الحديث صحيحًا فأخبرني به حتى أذهب إليه، سواء كان حجازيًّا أم كوفيًّا أم مصريًّا“، فأهل الحديث – حشَرَنا الله معهم – لا يتعصَّبون لقول شخصٍ مُعيَّن مهما علا وسما، حاشا محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – بخِلاف غيرهم ممَّن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصَّبون لأقوال أئمَّتهم – وقد نهوهم عن ذلك – كما يتعصَّب أهل الحديث لأقوال نبيِّهم! فلا عجب بعد هذا البيان أنْ يكون أهلُ الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، بل والأمَّة الوسط، الشهداء على الخلق.
ويُعجِبني بهذا الصَّدد قولُ الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه “شرف أصحاب الحديث” انتصارًا لهم وردًّا على مَن خالفهم: “ولو أنَّ صاحب الرأي المذموم شُغِلَ بما ينفعه من العُلوم، وطلب سنن رسول ربِّ العالمين، واقتفى آثارَ الفُقَهاء والمحدِّثين – لوجَد في ذلك ما يُغنِيه عن سِواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه؛ لأنَّ الحديث يشتملُ على معرفة أصول التوحيد، وبَيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات ربِّ العالمين – تعالى عن مقالات الملحدين – والإخبار عن صفة الجنَّة والنَّار، وما أعدَّ الله فيها للمتَّقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسماوات وصُنوف العجائب وعظيم الآيات، وذِكر الملائكة المقرَّبين، ونعت الصافِّين والمسبِّحين.
وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزُّهَّاد والأولياء ومواعظ البلغاء، وكلام الفُقَهاء، وسير ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدِّمين من الأمم، وشرح مغازي الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – وسَراياه، وجمل أحكامه وقَضاياه، وخطبه وعِظاته، وأعلامه ومُعجزاته، وعدَّة أزواجه وأولاده، وأصهاره وأصحابه، وذِكر فضائلهم ومَآثرهم، وشرح أخبارهم ومَناقبهم، ومَبلَغ أعمارهم، وبَيان أنسابهم.
وفيه تفسيرُ القُرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذِّكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية مَن ذهب إلى قول كلِّ واحدٍ منهم من الأئمَّة الخالفين، والفُقَهاء المجتهِدين.
وقد جعَل الله أهله أركان الشريعة، وهدَم بهم كلَّ بدعةٍ شنيعة، فهُم أُمَناء الله في خليقته، والواسطة بين النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأمَّته، والمجتهدون في حِفظ ملَّته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومَذاهبهم ظاهرة، وحُجَجهم قاهرة، وكلُّ فئةٍ تتحيَّز إلى هوى تَرجِعُ إليه، وتستحسنُ رأيًا تعكُف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإنَّ الكتاب عدَّتهم، والسُّنَّة حجَّتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء.
يقبل منهم ما رووا عن الرَّسول، وهم المأمونون عليه العُدول حفَظَة الدِّين وخزَنته، وأوعية العلم وحمَلَته، إذا اختلف في حديثٍ كان إليهم الرُّجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كلُّ عالمٍ فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ مُتقِن، وخطيب مُحسِن.
وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكلُّ مبتدعٍ باعتقادهم يتظاهَر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر.
مَن كادهم قصَمَه الله، ومَن عاندهم خذَلَه الله، لا يضرُّهم مَن خذلهم، ولا يُفلِحُ مَن اعتزلهم، المحتاط لدِينه إلى إرشادهم فقير، وبَصَرُ الناظر بالسُّوء إليهم حسير، وإنَّ الله على نصرهم لقدير، (ثم ساق الحديث من رواية قرَّة ثم روى بسنده عن عليِّ بن المديني أنَّه قال: هم أهل الحديث والذين يتعاهَدون مذاهب الرسول، ويذبُّون عن العلم، لولاهم لم تجدْ عند المعتزلة والرافضة والجهميَّة وأهل الإرجاء والرأي شيئًا من السنن).
قال الخطيب: فقد جعَل ربُّ العالمين الطائفة المنصورة حرَّاس الدِّين، وصرَف عنهم كَيْدَ المعاندين، لتمسُّكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار، وقطع المفاوز والقفار، ورُكوب البَرارِي والبِحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأيٍ ولا هوى، قبلوا شريعته قولاً وفعلاً، وحرَسُوا سنته حِفظًا ونَقلاً، حتى ثبتوا بذلك أصلَها، وكانوا أحقَّ بها وأهلَها، وكم من ملحدٍ يَرُومُ أنْ يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله – تعالى – يذبُّ بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفَّاظ لأركانها، والقوَّامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدِّفاع عنها، فهم دُونها يُناضِلون، أولئك حزبُ الله، ألا إنَّ حزبَ الله هم المفلحون.
ثم ساق الخطيب – رحمه الله تعالى – الأبوابَ التي تدلُّ على شرَف أصحاب الحديث وفضلهم، ولا بأسَ من ذِكر بعضها، وإنْ طال المقال؛ لتتمَّ الفائدة، لكني أقتصرُ على أهمِّها وأمسِّها بالموضوع:
1- قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نضَّر الله امرءًا سمع منَّا حديثًا فبلَّغَه)).
2- وصيَّة النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – بإكرام أصحاب الحديث.
3- قول النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحملُ هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عدولُه)).
4- كون أصحاب الحديث خُلَفاء الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – في التبليغ عنه.
5- وصف الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – إيمان أصحاب الحديث.
6- كون أصحاب الحديث أَوْلَى الناس بالرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – لدَوام صَلاتهم عليه.
7- بشارة النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – أصحابه بكون طلبة الحديث بعدَه واتِّصال الإسناد بينهم وبينه.
8- بيان أنَّ الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة.
9- كون أصحاب الحديث أُمَناء الرسل – صلَّى الله عليهم وسلَّم – لحِفظهم السنن وتبيينهم لها.
10- كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبِّهم عن السنن.
11- كون أصحاب الحديث ورَثَة الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – ما خلفه من السُّنَّة وأنواع الحكمة.
12- كونهم الآمِرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
13- كونهم خيار الناس.
14- مَن قال: إنَّ الأبدال والأولياء أصحاب الحديث.
15- مَن قال: لولا أهل الحديث لانْدَرسَ الإسلامُ.
16- كون أصحاب الحديث أَوْلَى الناس بالنَّجاة في الآخِرة، وأسبق الخلق إلى الجنَّة.
17- اجتماع صَلاح الدنيا والآخِرة في سَماع الحديث وكَتبه.
18- ثبوت حجَّة صاحب الحديث.
19- الاستدلال على أهل السُّنَّة بحبِّهم أصحاب الحديث.
20- الاستدلال على المبتدِعة ببُغْضِ الحديث وأهله.
21- مَن جمَع بين مدْح أصحاب الحديث وذمِّ أهل الرأي والكلام الخبيث.
22- مَن قال: طلب الحديث من أفضل العبادات.
23- مَن قال: رواية الحديث أفضل من التسبيح.
24- مَن قال: التحديث أفضلُ من صلاة النافلة.
25- مَن تمنَّى رواية الحديث من الخلفاء، ورأى أنَّ المحدِّثين أفضل العلماء.
وأختمُ هذه الكلمة بشهادةٍ عظيمةٍ لأهل الحديث من عالمٍ من كبار علماء الحنفيَّة في الهند، ألا وهو أبو الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي (1264 – 1304) قال – رحمه الله -:
ومَن نظَر بنظَر الإنصاف، وغاصَ في بحار الفقه والأصول مُتجنِّبًا الاعتِساف، يعلم علمًا يقينيًّا أنَّ أكثر المسائل الفرعيَّة والأصليَّة التي اختلف العلماء فيها، فمذهبُ المحدِّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإنِّي كلَّما أسيرُ في شعب الاختلاف أجدُ قول المحدِّثين فيه قريبًا من الإنصاف، فلله درُّهم، وعليه شُكرهم، كيف لا وهم ورَثَةُ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – حَقًّا، ونوَّاب شَرعِه صِدقًا، حشَرَنا الله في زُمرتهم، وأماتَنا على حبِّهم وسِيرتهم.
انتهى كلام العلامة المحدِّث الألباني.
[2]
كلمات العلامة الشيخ محمد أبو شهبة – رحمه الله –
منزلة السُّنَّة من الدِّين
القُرآن الكريم هو الأصل الأوَّل للدِّين، والسُّنَّة هي الأصل الثاني، ومنزلة السُّنَّة من القُرآن أنها مُبيِّنةٌ وشارحةٌ له؛ تُفصِّل مُجمَلَه، وتُوضِّح مُشكَلَه، وتُقيِّد مُطلَقه، وتُخصِّص عامَّه، وتبسط ما فيه من إيجاز؛ قال – تعالى -: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]، وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: 52، 53].
وقد كان النبي – صلوات الله وسلامه عليه – يُبيِّن تارَةً بالقول وتارَةً بالفعل وتارَةً بهما، وقد ثبَت عنه – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه فسَّر الظُّلم في قوله – سبحانه -: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82] بالشِّرك، وفسَّر الحساب اليسير بالعرْض في قوله – سبحانه -: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا *وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: 7 – 9].
وأنَّه قال: ((صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي))؛ رواه البخاري، وأنَّه قال في حجَّة الوداع: ((لتَأخُذوا مَناسِككم؛ فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجَّتي هذه))، وفي روايةٍ: ((خُذُوا عنِّي مَناسِكَكم))؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت في قوله – تعالى -: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: 15] أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((خُذوا عنِّي، خُذوا عنِّي، خُذوا عنِّي، قد جعَل الله لهنَّ سبيلاً، البكر بالبكرِ جلد مائة وتغريب عام، والثيِّب بالثيِّب جلدُ مائة والرَّجم)).
مثلٌ من بَيان السُّنَّة للقُرآن:
قال الله – تعالى -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43].
ولكنَّه لم يُبيِّن عددَ الصلوات ولا كيفيَّتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجباتها من سننها، فجاءت السُّنَّة المحمديَّة فبيَّنت كلَّ ذلك.
وكذلك لم يُبيِّن متى تجبُ الزكاة وأنصبتها؟ ومِقدار ما يخرُج فيها وفي أيِّ شيءٍ تجبُ، فجاءت السنة فبيَّنت كلَّ ذلك.
وكذلك قال الله – تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].
ولم يُبيِّن ما هي السرقة وما النِّصاب الذي يُحَدُّ فيه السارق، وما المراد بالأيدي، ومن أيِّ موضعٍ يكونُ القطع، فبيَّنت السُّنَّة كلَّ ذلك.
وقال الله – تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
ولم يُبيِّن الحدَّ فجاءت السُّنَّة فبيَّنته.
وقال الله – تعالى -: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2].
ولم يُبيِّن لِمَن هذا الحُكم، فبيَّنت السُّنَّة أنَّ هذا الحُكم للزاني غير المحصن، أمَّا المحصن فحَدُّه الرجم.
استقلال السُّنَّة بالتشريع:
وقد تستقلُّ السُّنَّة بالتشريع أحيانًا؛ وذلك كتحريم الجمْع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها، وتحريم سائر القَرابات من الرضاعة – عدا ما نصَّ عليه في القُرآن – إلحاقًا لهنَّ بالمحرَّمات من النَّسب، وتحريم كلِّ ذي نابٍ من السِّباع ومِخلَب من الطير، وتحليل ميتة البحر، والقضاء باليمين مع الشاهد… إلى غير ذلك من الأحكام التي زادتها السُّنَّة عن الكتاب.
حجيَّة السُّنَّة:
وقد اتَّفق العلماء الذين يُعتَدُّ بهم على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البَيان أو على سبيل الاستقلال.
قال الإمام الشوكاني: “إنَّ ثُبوت حجيَّة السُّنَّة المطهَّرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينيَّة، ولا يُخالِف في ذلك إلا مَن لا حَظَّ له في الإسلام“.
وصدَق الشوكاني فإنَّه لم يخالفْ في الاحتِجاج بالسُّنَّة إلا الخوارج والرَّوافض، فقد تمسَّكوا بظاهر القُرآن وأهمَلُوا السنن، فضلُّوا وأضلُّوا، وحادُوا عن الصِّراط المستقيم.
وقد استَفاض القُرآن والسُّنَّة الصحيحة الثابتة بحجيَّة كلِّ ما ثبَت عن الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال – تعالى -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31].
وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59].
قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرُّجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرُّجوع إليه في حَياته وإلى سنَّته بعد وَفاته.
وقال – سبحانه -: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].
وما قضَى به النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يشمَلُ ما كان بقُرآنٍ أو بسُنَّةٍ، وقد دلَّت الآية على أنَّه لا يَكفِي في قبول ما جاء به القُرآن والسُّنَّة الإذْعان الظاهري بل لا بُدَّ من الاطمئنان والرضا القلبي.
وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80].
فقد جعَل – سبحانه وتعالى – طاعةَ الرَّسول من طاعته.
وحذَّر من مُخالَفته فقال – عزَّ شأنه -: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
فلولا أنَّ أمرَه حجَّةٌ ولازمٌ لما توعَّد على مخالفته بالنار.
وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].
وقال – سبحانه -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
فقد جعَل – سبحانه – أمرَ رسولِه واجب الاتِّباع له، ونهيه واجب الانتهاء عنه.
وأمَّا الأحاديث فكثيرةٌ؛ منها: ما رواه أبو داود في “سننه” عن المقداد بن مَعدِي كرب أنَّ رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((ألا إنَّي أُوتِيتُ الكتابَ ومثله معه، ألا يُوشِك رجلٌ شَبعان مُتَّكئ على أريكته يقولُ: عليكم بالقُرآن؛ فما وجدتم فيه من حَلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حَرام فحَرِّموه، ألا لا يحلُّ لكم الحمار الأهلي، ولا كلُّ ذي نابٍ من السِّباع، ولا لُقَطة مُعاهَد إلاَّ أنْ يستَغنِي عنها صاحبُها، ومَن نزَل بقومٍ فعليهم أنْ يَقرُوه، فإنْ لم يَقرُوه فعليه أنْ يُعقِبهم بمِثْلِ قِراه)).
قال الإمام الخطابي: قوله: ((أُوتِيت الكتابَ ومثلَه معه)) يحتَمِلُ وجهين:
أحدهما: أنَّ معناه أنَّه أُوتِي من الوحي الباطن غير المتلوِّ مثلَ ما أُعطِيَ من الظاهر المتلوِّ.
والثاني: أنَّه أُوتِي الكتاب وحيًا يُتلَى، وأُوتِي من البَيان مثله؛ أي: أَذِنَ له أنْ يُبيِّن ما في الكتاب فيعم ويخص، ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوبِ العمل به ولُزوم قبوله كالظاهر المتلوِّ من القُرآن.
وقوله: ((يُوشِك رجلٌ شَبعان…)) يُحذِّر بهذا القول من مُخالَفة السنن التي سنَّها ممَّا ليس له من القُرآن ذكر، على ما ذهبَتْ إليه الخوارج والرَّوافض؛ فإنهم تمثَّلُوا بظاهر القُرآن وترَكُوا السنن التي قد ضمنت بَيان الكتاب، فتحيَّروا وضلُّوا، وأراد بقوله: ((مُتَّكئ على أريكته)) أنَّه من أصحاب الترفُّه والدَّعة الذين لَزِمُوا البُيوت ولم يطلبوا العلم من مَظانِّه.
وقد دلَّ الحديث على مُعجِزةٍ للنبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقد ظهَرتْ فئةٌ في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة؛ وهي الاكتفاء بالقُرآن عن الأحاديث، وغرَضُهم هدْم نِصف الدِّين أو إنْ شئت فقُلْ: تقويض الدين كلِّه؛ لأنَّه إذا أُهمِلَتِ الأحاديث والسُّنن فسيُؤدِّي ذلك ولا ريب إلى استِعجام كثيرٍ من القُرآن على الأمَّة وعدم معرفة المراد منه، وإذا أُهمِلت الأحاديث واستُعجِم القُرآن فقُلْ على الإسلام العفاء.
وفي حديث العرباض بن سارية مرفوعًا: ((عليكم بسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي، عضُّوا عليها بالنَّواجِذ))؛ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وروى الحاكم عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – خطَب في حجَّة الوَداع فقال: ((إنَّ الشيطان قد يئس أنْ يُعبَدَ بأرضكم، ولكنْ رَضِيَ أنْ يُطاع فيما سِوى ذلك ممَّا تحقرون من أمركم فاحذَرُوا، إنِّي ترَكتُ ما إنِ اعتصَمتُم به فلن تضلُّوا أبدًا؛ كتاب الله وسنَّة نبيِّه))، وروى مثلَه الإمامُ مالك في “الموطأ“.
وهي صريحةٌ في أنَّ السُّنَّة كالكتاب يجبُ الرُّجوع إليها في استِنباط الأحكام، وقد أجمع الصحابة – رضِي الله عنهم – على الاحتِجاج بالسُّنن والأحاديث والعمل بها، ولو لم يكن لها أصلٌ على الخُصوص في القُرآن، ولم نعلم أحدًا خالَف ذلك قطُّ؛ فكان الواحد منهم إذا عرَض له أمرٌ طلَب حُكمَه في كتاب الله، فإنْ لم يجدْه طلَبَه في السُّنَّة، فإنْ لم يجدْه اجتَهَدَ في حُدود القُرآن والسُّنَّة وأصول الشريعة.
وقد فَهِمَ الصَّحابة رُجوع جميعِ ما جاءت به السُّنَّة إلى القُرآن من قوله – تعالى -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
روى البخاري في “صحيحه” عن عبدالله بن مسعود قال: لعَن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمِّصات والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلْق الله، فقالت أمُّ يعقوب: ما هذا؟ فقال عبدالله: وما لي لا ألعَنُ مَن لعَن رسولُ الله، وفي كتاب الله، قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، فقال: والله لئنْ كنتِ قَرأتِيه لقد وجدتيه؛ قال الله – تعالى -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وهذه الآية تُعتَبر أصلاً لكلِّ ما جاءَتْ به السُّنَّة ممَّا لم يردْ له في القُرآن ذِكرٌ، وعلى هذا الدرب والطريق الواضح مَن جاء بعدَ الصحابة من أئمَّة العلم والدِّين.
رُوِيَ عن الإمام الشافعي أنَّه كان جالسًا في المسجد الحرام يحدِّث الناس فقال: لا تسألوني عن شيءٍ إلا أجَبتُكم فيه من كتاب الله، فقال الرجل: ما تقول في المحرم إذا قتَل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه، فقال الرجل: أين هذا من كتاب الله؟ فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، ثم ذكر إسنادًا إلى سيدنا عمر أنَّه قال: للمحرم قتلُ الزنبور؟
وذكر ابن عبدالبرِّ في “كتاب العلم” له عن عبدالرحمن بن يزيد: أنَّه رأى مُحرِمًا عليه ثِيابه، فقال: ائتني بآيةٍ من كتاب الله تنزع ثِيابي، قال: فقرأ عليه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
[1] في “شرح الأربعين النووية” (ح82).
[2] يعني: أنَّه غير مخلوق، والأَوْلَى عدم استِخدام هذا الوصف، فلا يُقال: قديم، ولا غير قديم، وإنما يُقال: القرآن كلام الله غير مخلوق
[3] أخرجه الشيخان.
[4] أخرجه الشيخان.
[5] أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم، من حديث عمار بن ياسر – رضِي الله عنهما.
[6] رواه مسلم.
[7] أخرجه البيهقي وغيره مرفوعًا وموقوفًا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حُكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقال من قِبَلِ الرَّأي.
[8] أخرجه الشيخان.
[9] أخرجه الحاكم وصحَّحه.
[10] رواه الترمذي.
[11] متفق عليه.
[12] رواه مالك بَلاغًا، والحاكم موصولاً بإسنادٍ حسن.













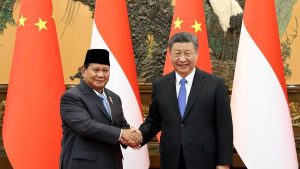






 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic