السبت-2 ذوالقعدة 1434 الموافق7أيلول /سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [البقرة: 208]
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾. نداء عميق الدلالة، مشرق الجمال، للجماعة المؤمنة بأحب صفاتهم المميّزة لهم، وأوضح علاماتهم التي يتفرّدون بها بين العالمين. ذلك لأنّ الإيمان ليس في معناه الحقيقي إلا صلة قويّة ورابطة عميقة تصل العبد المؤمن بخالقه العظيم. إنّها صلة تهدي تفكيره بعقائده وتصوّراته، وتهذب شعوره بدواخله ودوافعه، وتضبط سلوكه بحركاته وعلاقاته، وترسم له مساراً معيّناً في الحياة، لا يند عن عقيدة الإيمان ولا يتحلل من أخلاق الإيمان ولا ينحرف عن أهداف الإيمان.. ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ [طه: 124، 126]. ومن ثمَّ فنداء الإيمان طاقة هائلة تجدد في العبد المؤمن روح الإيمان وتشيع فيه أنوار الإيمان وتسكب فيه جمال الإيمان، فإذا به يرتقي درجات بعد درجات في معاني الإنسانيّة الكريمة والإيمان السامي. إنّها مستويات تخوّل العبد المؤمن أن يتحرك في أفقها حركته المنشودة في واقع الحياة وروحه ترّف رفرفاتها الجميلة في عالم النور الخالد.. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: 172].
من أجل ذلك، كان هذا النداء الإلهي حبيباً إلى قلب المؤمن، لأنّه يذكّره بقيمته الجلّى عند خالقه تبارك وتعالى من بين شتى كائنات الوجود.. ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: 28، 30]. وهو حبيب إلى العبد المؤمن لأنّه يذكّره بميثاقه الجليل مع خالقه العظيم ومهمّته في هذا العالم.. ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: 111]. ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
وأخيراً، هو حبيب إلى العبد المؤمن لأنّه يذكّره بمصيره بعد الموت ورحيله عن عالم الدنيا الفاني.. ﴿ لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [سبأ: 4].
من أجل تمثّل الدعوة بصفة الإيمان في حسّ الإنسان المؤمن – والجماعة المؤمنة بالتبع – شهادة إلهيّة، رحيبة الدلالة شديدة الإيحاء يفتخر ويعتزّ بها بين العالمين.. ﴿ لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [النور: 46]. فلا يجد العبد المؤمن في كلّ مرّة يسمع هذا النداء الحبيب ويتلقاه من ربّه الجليل إلا استجماع طاقات كينونته كلّها ليسمع ما يأتي بعده، لأنّه يدرك – بحاسّة الإيمان في أعماقه – أنّ كل ما سيأتي بعده إنّما هو من مقتضيات الإيمان وبراهينه، وأنّه من متطلّبات الميثاق والصلة التي تربطه بخالقه. كما أنّه يدرك أنّ كل ما سيأتي بعده إنّما هو تعاليم إلهيّة مقصدها النهائي هو توجيه العبد المؤمن ومساعدته على تبيّن معالم الصراط المستقيم، وبالتّالي توجيهه نحو أفضل سبل التّسامي في مدراج الإيمان.. ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ [يونس:108]. ولذا فهذا النداء يفتح في قلب العبد المؤمن وعقله أبواب اليقظة الواضحة والتنبه البصير. إنّها اليقظة الخاشعة أمام جلال وعظمة المنادي – سبحانه وتعالى -، وإنّها اليقظة المدركة لقيمة التعاليم الرّبانيّة التي يريد الحق تعالى التوجه بها إليه. وعسى أن يكون هذا بعض السرّ في ذلك المد الواقع – بحسب الرسم العثماني – في حرف النداء: ﴿ يَاأَيُّهَا ﴾.
﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾. هذا هو مقتضى الإيمان، بل رأس متطلّباته: الدخول في السلم كافة، أي الانضواء تحت راية الوحي الإلهي بكل الكينونة الشخصيّة، والالتزام بتعاليم منهجه في شتى مظاهر الحياة ومجالاتها، حتّى لا تبقى ذرة واحدة في شخصيّة المؤمن، ولا تبقى ناحية واحدة في حياة الجماعة المسلمة شاردة عن تعاليم ذلك المنهج الرّباني إلا وصبغها صبغته الإيمانيّة. صبغة الاستسلام الراضيوالخضوع المقتنع والقبول المطمئن لأحكام الله تعالى وأقداره وتعاليمه.. ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65].. ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (لا يُؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به).
والدعوة للدخول في السلم كافة، ليست دعوة مرتبطة بفترة زمنية محددة في حياة العبد المؤمن والمجتمع المسلم، بل بالحري أنّها دعوة لممارسة هذا الدخول الخاضع المطمئن بصورة مستمرة. ذلك لأنّ طريق الإيمان – طريق التّسامي إلى آفاق الإنسانيّة الفاضلة – طريق محفوفة بشتى المعوقات ومختلف العراقيل، وطافحة بهول مغريات الانحراف عن مسار الإيمان واتباع تعاليمه في الحياة.. يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (حُفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره ).. ولهذا صار لزاماً على العبد المؤمن أن يجدد مبثاقه الإيماني كل لحظة، وأن يمارس الدخول – بإخلاص أصدق وتجرّد أصفى – في التجاوب مع مقتضيات الإيمان، بكل حمولته العقيديّة والأخلاقيّة والسلوكيّة والتشريعيّة في مقتضياته بشكل مستمر ودائم.. ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: 99]. فلا قيمة للمؤمن – وللجماعة المسلمة – إلا بمدى التزامه بمتطلبات الإيمان.. ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [المائدة: 64]. إذ هذه الإقامة لتكاليف الإيمان بشتى مكوناته هي البرهان الساطع والدليل التطبيقي على معنى الإيمان في قلبه وضميره.
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
إنّ طمأنينة العبد المؤمن الواثقة بالإيمان واستسلامه الخاشع لدخوله في السلم كافة وإعلانه الانضواء تحت راية القرآن بكلّيته الشخصيّة، نابع من طبيعة تصوره لحقيقة الألوهيّة بجلالها المطلق وحقيقة الإنسانيّة بضآلتها الفانية. فهذا التصور الواضح والعميق هو الذي يفيض في أعماق شخصيّته دفقات هائلة جداً من الإصرار على الالتزام بمقتضيات الإيمان في حياته كلّها، وهو الذي يساعده بطاقات هائلة جدّاً على الثبات في مساره مهما امتدت به العمر وتقلّبت به الملابسات في هذا العالم. لتكون النتيجة التلقائيّة لتلك الدفقات والطاقات أنّ حياته بأفكارها وأهدافها وأشواقها وأحلامها تتسم بسمة واحدة، هي سمة: السلام بجماله المشرق وروعته الأخاذة. هذا السلام المطمئن يفتح في عقله وقلبه حاسّة الجمال، فلا يرى ولا يتعامل إلا بمعانيه الدفاقة الفيّاضة: مع وجود الله تعالى وضرورة عبوديّته. مع ذاته الشخصيّةوأعماقه المكنونة. مع شريكة حياته ورفيقة دربه. مع أفراد مجتمعه وأطيافه المختلفة. مع عناصر الكون وأشيائه البديعة. مع طغيان الباطل وانتفاشه. مع مصيره بعد الموت ونهاية رحلته في هذا العالم. وهذا ما يعيد إليه توازنه واستقراره، ويعصمه من حيرة العقل فلا يتيه، ومن قلق الروح فلا يضطرب، ومن شرود الأخلاق فلا تتحلّل، ومن ضغوط ملابسات الواقع فلا تطغى. ومن ثمَّ ينطلق هذا الإنسان المؤمن – وقد امتلأ سلاماً وانسجاماً وتدفق بسمة وحيويّة – بين جموع المؤمنين في مسارات الحياة يضفي عليها معانيها الجميلة ويسكب فيها قيمها السامية ويشيع فيها حقائقها المقدسّة.. يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيّباً ولا تضع إلا طيّباً).
والمؤمن حينما يرتقي هذا المرتقى الصاعد ويتحرك في هذا الأفق الوضئ، حينها فقط يستطيع أن يكون لبنة صالحة وقويّة في مجتمعه، فيمارس مهمّته في الحياة ويقوم بدوره كاملة بلا عجز ولا ترّدد. إذ أنّه لا يفتأ يستشعر عظمة المهمّة المنوطة به والمسؤولية الكبيرة الواجب عليه القيام بها، إذ أنّه يعتبر نفسه جنديّاً على ثغر من ثغور الإسلام، فهو يحرص أن لا يؤتى الإسلام من قِبَلِه، من خلال ممارسة تعاليمه والحرص على إشاعتها بين المجتمع. وهو شعور بقدر ما يملأه بالهيبة والجلال، بقدر ما يفعمه اعتزازاً وافتخاراً.
ومن ثمَّ تصلح أحوال الجماعة المسلمة ويستقيم أمرها ويشيع السلام بين أفرادها، فإذا هي جماعة قويّة ومتماسكة بين عناصرها. لأن طبيعة الإيمان الذي تؤمن به حدد لها هدفاً واحداً، هو هدف: إقامة العبوديّة الخالصة لله تعالى، من خلال إشاعة تعاليم شريعته في مختلف مظاهر الحياة. ولذا فهو مجتمع متعاون ومتكافل بين أفراده لتحقيق هذه الغاية الساميّة، فلا تنافر بين أطيافه: حاكم ومحكوم، عالم وجاهل، شريف ووضيع، رجل وامرأة. الكل يقوم بدوره المنوط به بدقة وإتقان، بحسب طبيعة موقعه وقدراته، لأنّ الكل له ينشد نفس الهدف.. يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه * إن الله كتب الإحسان على كل شيء).
والأمة المسلمة حينما تكون على هذه الشاكلة الإيمانيّة المشرقة، وحينما يتحرّك أفرادها في هذا المستوى المتألق الكريم، حينها فقط تستحق – بجدارة – أن تقوم بمهمّتها التي أخرجت لها، مهمّة القيام على الإنسانيّة لهدايتها من ضلالها الشرود وإرشادها من تيهها البائس النكود.. ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110]. فهذه الخيريّة للبشريّة لا يمكن تحققها إلا أن يكون الفرد المؤمن خيّراً في نفسه أولاً: عقيدة وخلقاً، سلوكاً وهدفاً. وإلا أن يكون المجتمع المسلم خيّراً بشتى أطيافه وطبقاته: تنظيماً وتشريعاً، تواصلاً وارتباطاً. إنّه قدر الأمة المسلمة: الحرص الأكيد على منفعة الإنسانيّة: عقائديّاً وأخلاقيّاً وماديّاً.
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
هذه الحقيقة الكبيرة، استطاع المنهج الإسلامي أن يحققها واقعاً على الأرض بطريقة عجيبة جداً وبمستوى رائع جداً، أثار انتباه الأعداء قبل الأصدقاء. وهو قادر على إعادة الكرّة كلما صادف قابليّة صادقة من العقول والضمائر.. ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 55].. يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة).
وإذا تأملنا سرّ هذه القوة في المجتمع المسلم وأساس تماسكه فيما بين أفراده بالرغم من اختلاف طاقاتهم ومواهبهم ومواقعهم، سنجد أنّ الأمر يرجع إلى طبيعة الآصرة التي تربط بعضهم ببعض. إنّها ليست آصرة اللون أو اللغة أو التراب أو غيرها من الأواصر التي تتمسك بها الجاهليّة وهي بعيدة عن الله، بل هي آصرة واحدة: آصرة الدين الحق. وهي آصرة تتعالى عن تختزل إنسانيّة الإنسان في لونه أو لغته أو وطنه، لأنّها تتعامل فقط مع جوهر الإنسانيّة المكنون في أعماق الإنسان. ولا شك أن الفرد حينما يعيش في مثل هذا المجتمع المصبوغ بصبغة الإيمان والمؤطر بإطار الإيمان والمتماسك بآصرة الإيمان، سيندفع لتفتيق طاقاته كلّها للعمل والكشف والإبداع لأجل هذا المجتمع الذي كفل له كل الضمانات والإمكانيّات. وعسى أن يكون هذا بعض السر في ذلك المد – كما هو في الرسم العثماني – الواقع في كلمة:﴿كَافَّةً ﴾ ، للإشارة – والله أعلم – إلى وجوب الخضوع المستسلم لتعاليم المنهج الرّباني بكل طاقات الإنسان: العقليّة والنفسيّة والماديّة، وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة: السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والتربويّة.
ثم إنّ هذه الدعوة الإلهيّة الجليلة ليست نابعة من منطلق الرغبة فقط في دعوة المسلم والجماعة المؤمنة للالتزام بتعاليم الوحي وتكاليف الشريعة. بل بالحريّ أنّها نابعة من معرفة عميقة بطبيعة النفس البشريّة وقوانين الاشتغال فيها، ولذا فهي تعاليم وتكاليف تراعي الفطرة في الإنسان، وتتعامل معها بطبيعتها التي فطرها الله عليه، بلا تكلّف ولا اعتساف، وبلا إفراط ولا تفريط.. ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]. ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَالَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 30]. يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (بُعثتُ بالحنيفيّةِ السمحة). حنيفيّة في العقائد، سمحة في الأخلاق والشرائع. ولذلك يستقبل الفرد المؤمن والجماعة المؤمنة تعاليم المنهج الرّباني برضا واقتناع، بل بحرص شديد على تفعيل حقائقه في ذات أنفسهم وشتى علاقاتهم، وذلك لعلمهم أنّه منهج صادر عن إله عليم خبير، بر رحيم، ودود كريم. وبهذا لا تجد الجماعة المؤمنة إلا الأخذ بشموليّة المنهج الرّباني: عقيدة وأخلاقاً وتشريعات، وتطبيقه بين أفرادها كافة. وبالتّالي لا تسقط في حمأة الفصام النكد والتمزّق المرير والقلق الضاغط، رغبة منها في استيراد عناصر أخرى من مناهج غريبة عن المنهج الإسلامي. ذلك لأنّ هذه المحاولة وهذا التلقي – ولو تلبّس بمظاهر التزييف الخادع – يعتبر نقضاً منها لميثاق الإيمان الذي قرّرت الالتزام به كنظام ومنهج في الحياة.. ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60]. ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]. ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85].
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾. بعد دعوة الجماعة المؤمنة بالدخول في السلم كافة، وتذكيرها عبر النداء بصفة الإيمان بأنّ ذلك هو مقتضى الإيمان الذي تؤمن به، تجيء الدعوة الثانيّة في صورة النهي عن اتباع ليس الشيطان بل عن خطواته!! وثمَّ فهذا النهي بمثل هذه الصيغة الدقيقة لا يصدر إلا عن عليم بخبايا النفوس وأعماقها المجهولة، ولا يصدر إلا عن عليم بحقيقة الشيطان وقدراته الهائلة على التّسلّل إلى مداخل النفس البشريّة الخفية.. ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَاإِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 27].
إنّ الشيطان اللعين ليس له مهمّة في هذه الحياة إلا إضلال الإنسان عن منهج الله تعالى.. ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 62]. غير أنّه يدرك أنّ الإيمان والإلتزام بمقتضياته: عقيديّاً وأخلاقيّاً وتشريعيّاً ومنهجيّاً، صمام أمان للمؤمن من شرّه وحاجز متين يمنعه عن الاستجابة لإغواءاته، ولذلك لا يجد إلا بذل الجهد الجهيد في الكيد له والمكر به رغبة لإيقاعه في مصايده ولدفعه إلى حبائله.. ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: 16 ،17].. يقول رب العزّة في الحديث القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم). على أنّ هذا التصميم الحازم والإصرار المطلق من الشيطان لإضلال الإنسان وإبعاده عن الله تعالى، إنّما ينبع عن حقيقة واضحة في عقل الشيطان، ألا وهي: أنّ المؤمن يوم يقع – باتباع الخطوات الماكرة المزيّفة – في حبائل الشيطان، فإنّه ينقض عناصر ميثاق الإيمان مع خالقه الجليل.. ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 30]. ومن ثمَّ يخبو وهجه في قلبه وتضعف قوّته في نفسه، فلا يبقى له من الإيمان إلا اسمه ولا من الإلتزام إلا رسمه.. ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: 104]. فتتحول حياته: بأفكارها، وأهدافها وأشواقها وعلاقاتها، من السكينة إلى القلق، ومن النظام إلى الفوضى، ومن الاستقرار إلى الاضطراب، ومن السعادة إلى الشقاء. وما ذلك إلا بسبب التشوّه الفظيع والانحراف الهائل الذي يحدث في فطرة الإنسان كلّما اتبع خطوات الشيطان ونسي منهج خالقه تباركوتعالى.. ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف:28]. ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: 124]. فمن أجل هذه الحقيقة التي يدركها الشيطان بوضوح، لا يفتأ – لعنه الله لعناً كبيراً – يغري المؤمن باتباع خطواته الماكرة الخادعة. ولذلك كانت خطة ” الخطوات ” هي الطريقة المحبّبة للشيطان في التعامل مع العبد المؤمن: خطوات سريعة ومتلاحقة، يدفع بعضها إلى بعض ويغري بعضها ببعض ويفتح بعضها باب بعض. وهكذا يستمر العمل الشيطاني حتّى لا يدع للمؤمن مجالاً لإعادة النظر والتفكّر في أمره، حتّى يقع في المصيدة، مصيدة الخروج من: ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾. إلا أن يتداركه الله بلطفه وعصمته. وعسى أن يكون هذا بعض السرّ في حذف الألف الممدودة – في الرسم العثماني – في كلمة: ﴿ كَافَّةً ﴾.
إنّ خطة الخطوات التي يتعامل بها الشيطان مع الإنسان المؤمن، تتجلّى في كل شيء:
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
في العقيدة: بالعمل على تشويه جمالها في عقل والضمير. وذلك من خلال الدفع – بدعوى العقل والدليل – للخوض في ما ليس العقل البشري مؤهلاً للخوض فيه والبحث عنه. وهذا ما حدث مع فتنة ما يسمى « علم الكلام »، فبعد أن كانت العقيدة بسيطة واضحة، تناسب الفطرة وتتجاوب مع العقل، صارت ألغازاً مبهمة وأسراراً معجزة وتشقيقات عجيبة.
في الأخلاق: بالعمل على طمس إشراقاتها في النفس والروح. وذلك من خلال الدفع – بدعوى التهذيب والتزكيّة – لسلوك مسارات وتطبيق مناهج غريبة عن طبيعة الوحي الرّباني السامي. وهذا ما حدث مع فتنة ما يسمى « التصوف »، فبعد أن كانت الأخلاق تتدفق نوراً وتشع جمالاً، تعمل عملها الحبيب في النفس والمجتمع، صارت قيوداً ثقيلة وتنطعات مقيتة.
في التشريع: بالعمل على إبعاد حقائقه وطمس مقاصده. وذلك من خلال الدفع – بدعوى العقل والعلم والتطور – لطرح جمهرة من الأحكام التكليفيّة والتعاليم التشريعيّة. وهذا ما حدث مع بعض أشباه الفقهاء قديماً، حين رفعوا العقل والقياس والمصلحة فوق الحكم التشريعي، وحدث حديثاً مع جمهور الجاهليين / العلمانيين ورفاقهم، وكذا المتأثرين بالغرب ممن يسمون أنفسهم “علماء ومفكرين ودعاة“، الذين أباحوا لأنفسهم التنازل عن كثير أو قليل من الأحكام بدعوى التطور أو الظروف العالميّة.
و لئن كانت هذه الخطوات تتجلّى بشكل أوضح في حياة الأمة في مجال التشريع والعلاقات الدولية، فإنّ تأثير هذه الخطوات يتجلّى في حياة العبد المؤمن في كل شيء يتعلّق به، سواء في أهدافه أم في سلوكياته أم في علاقاته. ولأجل ذلك ما زال الله تعالى يوصي العبد المؤمن – كيفما كان موقعه وقدراته – بضرورة المسارعة إلى التوبة النصوح والعودة إلى حمى الله الآمن أي العودة إلى الدخول في السلم كافة.. ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 31]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: 8]، بل قرّر تبارك اسمه أنّ من لم يسارع بالتوبة فإنّه ظالم: ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: 11] لأنّه رضي متابعة إغواءات الشيطان والإنسلاخ من تعاليم الشريعة وأحكامها.. يقول الرسول الكريم– صلى الله عليه وسلم -: ( إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها). ويقول أيضاً – صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة ).
قراءة المزيد: أجمل دعاء في رمضان
إنّ خاتمة الآية الكريمة: ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ ذات مغزى كبير، فهي واضحة جداً في تقرير حقيقة أنّ عداوة الشيطان للعبد المؤمن عداوة واضحة تبرهن على الإصرار المطلق في استدراج المؤمن والكيد له والمكر به، لتحقيق هدف واحد هو: الانحراف به عن منهج الله في الحياة. ومن ثم يكون هذا النهي الإلهي تنبيهاً قويّاً ودلالة واضحة على ضرورة اليقظة الدائمة والحذر الدقيق من اتباع خطوات الشيطان، عبر التزام الجماعة المؤمنة والعمل على إشاعة وتطبيق تعاليم الشريعة بين أفرادها، لأنّ المعركة بين المؤمن والشيطان لن تنتهي إلا بالموت. فهذا الالتزام بتعاليم الوحي في إطار الجماعة المؤمنة هو القوة الجبارة والطاقة الفائقة في توهين كيد الشيطان ودحر جهوده، التي ترمي لتشويه معاني الإيمان في العقل والضمير وتدمير كل مقتضياته في الحياة. وعسى أن يكون هذا بعض السر في حذف الألف الممدودة –في الرسم العثماني – من كلمة: ﴿ الشَّيْطَانِ ﴾.
إنّه خيار أمام المؤمن: فإما قرار الخضوع لمنهج الله بشموليّتها كلّها في توجيه شخصيّته وتنظيم مجتمعه وتحديد مساراته في الحياة، وذلك يعني الأمن والسلام والهداية والنور والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وإما التلكؤ في دخول حمى الله تعالى الآمن أو استجداء بعض تصورات العقيدة ومناهج الأخلاق وأنساق التشريع من أديان وفلسفات أخرى، وذلك يعني القلق والحيرة والضلال والشرود والبؤس والشقاء.
و الله أعلم
قراءة المزيد: توصية رمضان ١٤٣٨ ه
المصدر : الألوكة
قراءة المزيد: أشياء يجب عليك توفيرها في موائد الرحمن خلال رمضان













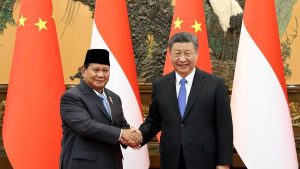






 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic