الأحد- 8 ذوالحجة1434 الموافق13 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
عندَ حديثنا عن التسامُح، يُتناول أصحابُ المشْرَب المتحد، والمنبع الصافي، وكانت كثيرٌ من القواسم المشتركة تجمعُهم مِن الأُخوَّة، والانتماء لهذا الدِّين والعمل لنهضته، ونحو ذلك، فأثرُ المعوقات داخلَ الصفِّ أبلغُ في التأثير على المجتمع، ومسيرة الصَّحْوة، والعمل الإسلاميّ.
فلا يُطلب التسامحُ في جانب التصوُّرات والعقائد تُجاهَ البعيد، بقدر ما هو مُلِحٌّ في جانب المعاملات والسُّلوك نحو القريب، فيُقرَّر على مفهوم الدِّين والحنيفيَّة السمحاء، وما استقاه الجيل الأوَّل، دون التجاوز الشرعيِّ فيه أو التنكُّر له، فيتجرَّد عن الإملاءات من الغَيْر وضغوطاته، وما تقتضيه المصالِح الخاصَّة لزُمرة من البشر بمنأًى عن مصالِح الأمَّة، غير ذلك لا يعدو أن يكون مناقضًا للواقع، فيؤثِّر سلبًا، ويُثير حفيظةَ الكثيرين، ممَّا ينتج عنه ردودُ أفعال غير مدروسة، ويكون الواقع مكلومًا بالجِراح.
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
حينما نريد أن نُشيعَ مفهومَ التسامح الإيجابي، فلنجعلْ له من أنفسنا منطلقًا، وبين مجتمعنا مَدخلاً، وبين قادتنا وعلمائِنا نبراسًا، وفي أعمالنا وتصرُّفاتنا مبرهنًا، علينا أن نتركَ أعمالَنا تتحدَّث نيابةً عنَّا، وأن نرتقيَ بذواتنا، ونتخلَّص من أنانيتنا.
فأنَّى لنا استيعابُ مفهوم التسامُح المأمول، ونحن لم نزرعْه فينا، ولم يَنْمُ في محيطنا؛ حيث لم نرَ إلاَّ الإقصاء للغير، والإلغاء لِمَن نختلف معه، والإبعاد لِمَن أظهر نصحَه، سواء في ميدان البيت والأسرة، أو ميدان الدعوة والعِلم والتربية، أو ميدان القيادة والعمل، وميدان الكلمة والحوار والفِكر؟!
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
في حين أنَّ التلاحم والنجاح في هذه الميادين مرهونٌ بالتسامح والتطاوع والسمو، والتخلُّص من القيود والأغلال الناتجة عن ركونِ الإنسان إلى أصْل خلقتِه ومادته الأولى من الطِّين، في حين تجذبه وتشدُّه إلى أسفل، فيصدر منه ما لا يليق.
الحديثُ له حاجتُه الماسة لا سيَّما في هذا العصر المليء بالمكدِّرات، ووجود المعكِّرين لصفوِ ساحة العمل، وميادين العلاقات، حيث لم تسرِ في الأرواح السماحةُ والمُطاوَعَةُ في مدِّ جُسور الشراكة والتعاون، وإذْكاء الرُّوح الإيجابيَّة لشركاء البيت والعمل.
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
ويكتسب الحديثُ عن هذا الخُلق أهميةً خاصَّةً في ظلِّ غياب التلاحم الأُسَري والأخوي، فكم من أُسَرٍ تفككت، وعلاقاتٍ تقطَّعت أواصرها، وتحوَّلت المحبة إلى عداوة، وأضحت الشراكة في العمل الدعوي والدنيوي متشرذمةً ومتمزقةً! وكم من مشروعات وأفكار أُجهِضَت؛ بل وانفرط عقدُ كثير من الكيانات والمؤسَّسات! وكان لضعف خُلُق التسامح والتطاوع حظٌّ وافر من ذلك.
فالمرء حينما يتَّصل بمَن حوله بنفس زكية واسعة، ويكون هيِّنًا لينًا، ويتجاوز حظوظَ نفسه، ويُسيِّر الأمورَ بتيسير وملاينة – فقد جعل من نفسه ظرفًا لقوله – عليه الصلاة والسلام -: ((ألاَ أُخبِركم بمَن يَحرُم على النار، أو تَحرُم النار عليه، على كلِّ قريبٍ هيِّن سهْل))، وأذكى في نفسه الرُّوح الإيجابيَّة.
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
فالقلوب لن تُفتح إلاَّ عندما نكون ظرفًا لقوله – عليه الصلاة والسلام -: ((اللهمَّ اهْدِ دوسًا وأْتِ بهم مسلمين))، وقوله: ((اذهبوا فأنتم الطُّلقاء))، وقوله: ((اللهمَّ اغفِرْ لقومي، فإنَّهم لا يعلمون)).
والدعوة لن تأخذَ مسارَها، وتتمكَّن من الدخول إلى بيت المدر والحجر؛ ما لم تكن سِير الأعلام والأئمَّة ظرفًا لنا في دعوتنا.
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
فعندما نعيش قصَّة الإمام أحمد – رحمه الله – في عهد المعتصم، بعد أن لَقِيَ ما لقي من الضَّرْب والجَلْد، حتى قال بعضهم: لو جُلِد جملٌ كما جُلِد الإمام أحمد لمات – تجده لا يدور حولَ نفسه وذاته؛ بل أخذ يقول: “مَن ذَكَرني فهو في حِلٍّ، وقد جعلتُ أبا إسحاق – المعتصم – في حِلٍّ، ورأيتُ الله يقول: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22]، وما ينفع أن يُعذِّب الله أخاك المسلِم في سبيلك“.
وقصَّة شيْخ الإسلام ابن تيمية مع ألدِّ أعدائه – ابن مخلوف – لَمَّا مات جاءه تلميذُه ابن القيم يُبشِّره بموته، فنهَرَه وتنكَّر له واسترجع، ثم قام إلى بيْت أهله، فعزَّاهم ودَعَا لهم، وقال: أنا لكم مكان أبيكم، وما يكون لكم مِن أمرٍ تحتاجون فيه إلى مساعدة إلاَّ ساعدتكم فيه، فَسُرُّوا واستبشروا، ووعدوا خيرًا.
قراءة المزيد: أجمل دعاء في رمضان
ولن تهبَّ رياحُ النصر على المسلمين اليومَ في شتَّى ميادينهم – لا سيَّما ميدان القيادة والعمل – ما لم يكونوا ظرفًا لمواقفِ أصحاب النُّفوس الكبيرة، منهم أبو عُبيدة عندَ تولِّيه الإمارة، وعزلِ خالد بخِطابٍ من أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب – رضي الله عنهم أجمعين – فكَتَم أبو عبيدة الخبرَ عشرين ليلة، فيأتيه خالد – وقد عَلِم الخبر من غير أبي عُبيدة – قائلاً: يرحمك الله، ما منعك أن تُعلِّمني حينَ جاءك؟ فيأتي الجواب من أبي عبيدة – الهيِّن السهل -: “إني كرهتُ أن أكْسِر عليك حربك، وما سلطان الدنيا أُريد، وما ترى سيَصير إلى زوالٍ وانقطاع، وإنَّما نحن إخوة، وما يضرُّ الرَّجلَ أن يليَه أخوه في دِينه أو دنياه“.
أيُّ مشاعر كانت تغمر خالدًا وهو يرى هذا النورَ يتدفَّق من فم أبي عبيدة، وهو يرى هذا التسامحَ، وهذا الخُلق العالي، الذي لم يجعل لنفسه حظًّا؟!
قراءة المزيد: توصية رمضان ١٤٣٨ ه
|
وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ |
إضفاء خُلق التسامُح على النفس وإصباغها به كفيلٌ بتعزيز أواصرِ الأخوة،والتلاحم الأُسريِّ، واستمرارية كثيرٍ من الأعمال ودوامها، وحصول الثمرة المرجوَّة، وتكون الأمور كلُّها على قَدْر من اليُسر والسهولة.
والنأيُ عن هذا الخُلُق الرفيع يُشكِّل خطرًا على السلوك والأعمال، وتعصِف بهما رياحُ الجدل والانتقام للنفس وحبِّ الذات، ويتشتت عِشُّ الحياة الأُسريَّة، وتنطفئ شمعتُها، ويكون مطيةً لإجهاض كثيرٍ من المشروعات النهضويَّة للأمَّة.
قراءة المزيد: أشياء يجب عليك توفيرها في موائد الرحمن خلال رمضان
المصدر : الألوكة







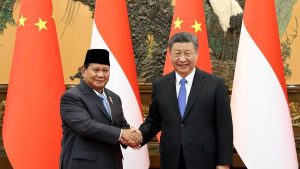











 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic