السبت4 صفر 1435 الموافق 7 كانون الأول / ديسمبر2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
أحمد حسين أنه
ملخص الرسالة
تقديم
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
الحمد لله ولي الحمد والتوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
وبعدُ:
فإنَّ الله – تعالى – أرسل رسوله بالهدى ودِين الحق ليظهره على الدين كله، وهو دين البشر جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم؛ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 85]، فلا دِين حقًّا بعدَه كما لا نبي بعد خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
والمسلمون مأمورون بنشْر هذا الدِّين وتعاليمه بين الناس؛ مسلمين كانوا أو غير المسلمين، ومُكلَّفون بإبلاغ هذه الدعوة إلى البشر أجمعين حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور، فالقيام بهذا الواجب يستلزم من المسلم أنْ يختلط بغيره؛ سَواء كان هذا الغير مسلمًا أو غير مسلم؛ إذ الدعوة لا تتمُّ إلا بذلك، وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب؛ وعليه: فإنَّ الاختلاط بغير المسلمين قد يكون ضرورة شرعية، هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى أنَّ مقتضيات الحياة تفرض على الإنسان أنْ يكون على علاقة وصلةٍ دائمةٍ بآخَرين؛ إذ الإنسان وحدَه لا يقدر على تحقيق كلِّ ما يحتاج إليه ويلزمه لقوام حياته، بل هو بحاجةٍ إلى التعاون والتساند مع آخَرين؛ ولذلك يُقال: “إن الاجتماع الإنساني ضروري“[1].
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
ومن خِلال هذه العلاقات البشرية الضروريَّة فالمسلم قد يلتقي بأناسٍ دِينُهم يخالف دِينَه، فإنَّ المجتمع الإسلامي لم يخلُ قطُّ من غير المسلمين في عصرٍ من العصور؛ لأنَّ الإسلام لم يكرههم أنْ يكونوا مسلمين، ولا أمر المسلمين أنْ يعتزلوهم، بل أَذِنَ لهم أنْ يعيشوا مع المسلمين في بلاد الإسلام بصفة أهل الذمَّة آمِنين مطمئنِّين على أنفُسهم وأموالهم بما بذلوه من الجزية ما لم ينقضوا العهد، فهذه المعيَّة والمجاورة وغيرها من الأسباب تقتضي نُشوء العلاقات ودَوامها بين المسلمين وغير المسلمين؛ كما نراه في عهد النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فإنَّ المسلمين كانوا يتعاملون مع اليهود قبل إجلائهم من المدينة المنورة:
فقد رُوِي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: اشترى رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – من يهودي طعامًا ورهنه درعه[2].
ورُوِي عن عبدالرحمن بن أبى بكر – رضِي الله عنهما – أنه قال: كنَّا مع النبي – عليه الصلاة والسلام – ثم جاء رجلٌ مشرك مشعان طويل بغنم يسوقُها، فقال – عليه الصلاة والسلام -: ((أبيعًا أم عطية؟ – أو قال: أم هبة؟)) قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة[3].
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
ورُوِي عن عبدالله قال: أعطى رسول الله – عليه الصلاة والسلام – خيبر اليهود أنْ يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها[4].
ورُوِي عن أسماء بنت أبى بكرٍ قالت: قدمتْ عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله – عليه الصلاة والسلام – فاستفتيت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قلت: وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: ((نعم، صِلِي أمَّك))[5].
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
ورُوِي عن أنس بن مالك – رضِي الله عنه – قال: إنَّ يهودية أتت النبي – عليه الصلاة والسلام – بشاةٍ مسمومة فأكل منها[6].
ورُوِي عن عبدالله أنَّه قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن حلف على يمينٍ وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان))، قال: فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – فقال لي رسول الله: ((ألك بيِّنة؟)) قلت: لا، قال: فقال لليهودي: ((احلف)) قال: قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله – تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا… ﴾ [آل عمران: 77] إلى آخِر الآيات[7].
قراءة المزيد: أجمل دعاء في رمضان
فهذه الأحاديث وغيرها تُفِيد أنَّ العلاقات في مختلف المجال كانت قائمةً بين المسلمين وغير المسلمين في عهد النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – كذلك كان الأمر في العصور التي تَلِيه.
ثم إنَّ تلك العلاقات قد تكونُ بين دولتين: دولة إسلامية ودولة كافرة، التي ذكر الفقهاء إحكامها في أبواب الجهاد والسير، واستُوفِيت الكتابة عنها قديمًا وحديثًا.
قراءة المزيد: توصية رمضان ١٤٣٨ ه
وقد تكون بين أفراد من غير المسلمين وبين دولةٍ إسلاميَّة التي يذكر تفاصيلها في أبواب وأحكام أهل الذمة والمستأمنين، وكذلك استُوفِيت الكتابة عنها قديمًا وحديثًا.
وقد تكون بين أفرادٍ من المسلمين وغير المسلمين من بيع وشراء وإجارة ووكالة وشركة وشهادة ومناكحات وعيادة كافر وتعزيته، وأمثال ذلك من العلاقات التي تقع بين اثنين، مسائلها متناثرة ومتفرِّقة في أبواب الفقه المختلفة.
قراءة المزيد: أشياء يجب عليك توفيرها في موائد الرحمن خلال رمضان
فهذا النوع الأخير هو الذي أعنيه بالعلاقات الفرديَّة بين المسلم وغير المسلم، وهو الذي سأُورِده بالتفصيل في هذه الرسالة – إن شاء الله – لما له من أهميَّة في حياة المسلمين بعامَّة، وواقعنا المعاصر بخاصَّة.
الأمر الذي جعلني أختار هذا الموضوع وأقدِّمه على ما سواه لأنَّ الحاجة إليه ماسَّة؛ إذ العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين بعد أنْ تطورت وسائل النقل وتغيَّرت ظروف الحياة في العالم بعامَّة، قد توسَّعت وتنوَّعت، فذهب الكثير من أبناء المسلمين إلى بلاد الكفار لغرض الدعوة أو التجارة أو الدراسة أو العمل، وكذلك جاء الكثير منهم إلى بلاد الإسلام لأغراضٍ شتَّى، فكلُّ ذلك يؤدِّي إلى تزايُد العلاقات الفردية بين المسلمين وغير المسلمين.
قراءة المزيد: كيفية صلاة قيام الليل في رمضان
وكلُّ مسلم له صلة وعلاقة بغير المسلمين ينبغي له أنْ يعرف مَدَى الحكم الشرعي لعلاقاته هذه ومعاملاته الفردية معه؛ ليصبح داعيةَ خيرٍ ورشادٍ كما كان سلَف هذه الأمَّة، فإنَّ كثيرًا من البلدان قد اعتنق أهله الإسلام بسبب التجار المسلمين الملتزِمين؛ إذ شاهدوا فيهم مَحاسن الإسلام ومَزاياه الطيِّبة الحسنة من صدقٍ وأمانةٍ ووفاءٍ في معاملاتهم التجارية والإنسانية معهم، فأعجبهم دينهم فأقبلوا إليه واعتنقوه؛ ولذلك ينبغي للمسلم أنْ يجعل هذه العلاقات – بجانب المصالح الدنيوية – وسيلةً لدعوتهم إلى الحق قولاً وعملاً، فحينئذٍ يُؤجَر على نيَّته وعمله، فإنَّ هداية رجل منهم بسببه خيرٌ له من حمر النَّعَمِ؛ كما قاله – عليه الصلاة والسلام – لعلي حين سلم الراية إليه في غزوة خيبر: ((فوالله لأنْ يهدي بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حُمُرِ النَّعَمِ))[1].
ومن هنا تظهر أهميَّة هذا البحث الذي اخترتُه موضوعًا لرسالتي في هذه المرحلة.
قراءة المزيد: معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة
أمَّا خطة البحث:
فقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثمانية عشر فصلاً وخاتمة:
ففي المقدمة تكلمت عن ماهيَّة البحث، وأهميَّته، والمنهج الذي اتَّبعته فيه.
وفي التمهيد تحدثت بإيجازٍ عن تقسيم البشر إلى اثنين: إمَّا مسلم وإمَّا غير مسلم، ثم ذكرت أصناف غير المسلمين؛ فهم إمَّا أنْ يكونوا من أهل الكتاب، وإمَّا ممَّن لهم شبهة كتاب، وإمَّا ممن ليس لهم كتاب أصلاً، وكلٌّ منهم إمَّا أنْ يكون ذِميًّا، وإمَّا حَربيًّا، وإمَّا مُستأمَنًا، وختمتُ التمهيد بذِكر شيءٍ من أحكام المرتد.
الفصل الأول: في العلاقة بين المسلم وغير المسلم في أمور العبادات، ويتألَّف من خمسة مباحث:
المبحث الأول: حكم الصلاة في معابد غير المسلمين.
المبحث الثاني: دخول غير المسلم المساجد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دخوله المسجد الحرام.
المطلب الثاني: دخوله سائر المساجد.
المبحث الثالث: حضور أهل الذمَّة للاستسقاء.
المبحث الرابع: دفع الصدقات والكفَّارات لغير المسلم.
المبحث الخامس: العلاقة بينهما في القيام بأمور الموتى، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: عيادة غير المسلم.
المطلب الثاني: غسل الكافرِ المسلمَ.
المطلب الثالث: غسل المسلمِ الكافرَ.
المطلب الرابع: الصلاة على الكافر.
المطلب الخامس: إتباع جنازته.
المطلب السادس: في التعزية.
المطلب السابع: زيارة قبور الكفار.
الفصل الثاني: في حكم نكاح غير المسلمات، والاستمتاع بهنَّ بملك اليمين، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نكاح المسلم نساءَ وأهل الكتاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نكاح الحرَّة الكتابية.
المطلب الثاني: نكاح الأمَة الكتابية.
المبحث الثاني: نكاح المسلم نساءَ مَن لهم شُبهة كتاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زواج المسلم بالصابئة.
المطلب الثاني: زواج المسلم بالمجوسية.
المبحث الثالث: في المسائل المتفرِّقة المترتبة على جَواز نكاح الكتابيَّات، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: نفقة الزوجة الكتابية.
المطلب الثاني: إجبار الزوجة الكتابية على الغُسل.
المطلب الثالث: منعها من الذهاب إلى معابد أهل دِينها وأكْل لحم الخنزير وشُرب الخمر.
المطلب الرابع: الزوجة الكتابية في الطلاق والعدة والحداد.
المطلب الخامس: إذا ماتَتْ وهي حامل أين تُدفَن.
المبحث الرابع: الاستمتاع بغير المسلمات بملك اليمين.
أمَّا الفصل الثالث: ففي حكم النكاح بعد اختلاف الزوجين في الدِّين، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين.
المبحث الثاني: الآثار المترتِّبة على الفرقة باختلاف الدِّين، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: العدة.
المطلب الثاني: المهر.
المطلب الثالث: نفقة الزوجة بعد الفرقة.
المطلب الرابع: حضانة الطفل وكفالته.
المطلب الخامس: تبعيَّة الأولاد.
المبحث الثالث: حُكم النكاح إذا ارتدَّ أحد الزوجين.
الفصل الرابع: العلاقة بينهما في البيع والشراء والإجارة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في البيع والشراء.
المبحث الثاني: في الإجارة.
الفصل الخامس: الربا بين المسلم وغير السلم.
الفصل السادس: العلاقة بينهما في الشفعة.
الفصل السابع: العلاقة بينهما في الوكالة والشركة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في الوكالة.
المبحث الثاني: في الشركة.
الفصل الثامن: العلاقة بينهما في القصاص والدِّية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم القصاص بين المسلم وغير المسلم.
المبحث الثاني: حكم الدِّية ومقدارها بين المسلم وغير المسلم.
الفصل التاسع: العلاقة بينهما في الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: العلاقة بينهما في الإحصان وعقوبة الزنا، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: العلاقة بينهما في الإحصان.
المطلب الثاني: العلاقة بينهما في عقوبة الزنا.
المبحث الثاني: العلاقة بينهما في حدِّ القذف.
المبحث الثالث: العلاقة بينهما في حدِّ السرقة.
الفصل العاشر: العلاقة بينهما في اللعان.
الفصل الحادي عشر: العلاقة بينهما في ضمان المغصوب.
الفصل الثاني عشر: العلاقة بينهما في الولاية والشهادة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في حكم الولاية بينهما في النكاح والمال.
المبحث الثاني: في حكم الشهادة بينهما.
الفصل الثالث عشر: العلاقة بينهما في التوارث، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التوارث بين المسلم والكافر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إرث الكافر من المسلم.
المبحث الثاني: إرث المسلم من الكافر.
المبحث الثالث: التوارث بين المسلم والمرتد.
الفصل الرابع عشر: العلاقة بينهما في التبرُّعات، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في حكم الهبة والتهادي بين المسلم وغير المسلم.
المبحث الثاني: في حكم الوصية بينهما.
المبحث الثالث: في حكم الوقف بينهما، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وقف المسلم على الكافر.
المطلب الثاني: وقف الكافر على المسلم.
الفصل الخامس عشر: العلاقة بينهما في الذبيحة والصيد والأضحية، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ذبيحة غير المسلم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ذبيحة أهل الكتاب.
المطلب الثاني: ذبيحة سائر الكفار.
المبحث الثاني: صيد غير المسلم.
المبحث الثالث: في الأضحية، وفية ثلاثة أمور:
المطلب الأول: الاستنابة.
المطلب الثاني: اشتراك الكافر في الأضحية.
المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من لحوم الأضحية.
الفصل السادس عشر: يتكون من ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: السلام على الكافر.
المبحث الثاني: رد السلام عليه.
المبحث الثالث: في المصافحة والتشميت والاستئذان.
الفصل السابع عشر: المشاركة في أعياد غير المسلمين والحضور لها.
الفصل الثامن عشر: الفصل الجامع، فيه ست مسائل متفرقة:
المبحث الأول: حجاب المرأة المسلمة عن الكافرة.
المبحث الثاني: حكم طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم وثيابهم.
المبحث الثالث: بر الوالدين والأقربين ونفقاتهم عند اختلاف الدِّين.
المبحث الرابع: الاحترام والتعظيم لغير المسلم.
المبحث الخامس: الإجابة لدعوة غير المسلم.
المبحث السادس: استطباب غير المسلم.
والخاتمة:
تحدَّثت فيها عن بعض الأمور التي يجب على المسلم أنْ يلتزم ويهتمَّ بها في علاقاته بغير المسلم.
أمَّا منهجي في البحث:
1- لما كانت مسائل هذا البحث متناثرة ومتفرقة في مختلف أبواب الفقه وموضوعاتها متنوعة ومتشعبة، كان من العسير أنْ تنسق في أبواب متقاربة الحجم والكبر، فرأيت أنَّ ترتيبها على الفصول أنسب.
2- جعلت لمعظم الفصول والمباحث تمهيدًا ذكرتُ فيه ما رأيت ذكره ضروريًّا: من تعريف الموضوع، أو مشروعيَّته، أو أركانه وشروطه، وغير ذلك ممَّا يلزم تقديمه في هذا المقام؛ وذلك لتقريب الموضوع إلى الأفهام.
ثم أوردت المسألة مع أدلَّتها، وناقشتُ الأدلَّة مع بَيان ما ترجَّح لديَّ من الآراء والأقوال، وما لم يظهر لي رجحانه سكتُّ عنه واكتفيت بذكر الخلاف فيه؛ إذ لا ينبغي الترجيح بلا مُرجِّح.
3- وعند عرض المسائل: فإنْ كان الأمر حكمه يختلف باختلاف الدارين، أو بكون غير المسلم كتابيًّا أو غير كتابي، أو بكونه ذميًّا أو حربيًّا أو مستأمنًا، بيَّنت حكم كلٍّ منهم على حِدَةٍ، وإلاَّ فاكتفيت بإطلاق ذِكر الحكم بين مسلم وغير مسلم.
4- ولم أتعرَّض في هذه الرسالة لحكم العلاقات الفرديَّة بين مسلم وبين مَن هو من أهل مذهب يكفر به معتقده من الفرق الإسلاميَّة؛ إذ هو يستلزم منِّي أولاً إثبات كفره ثم حكم العلاقة معه، فهذا أمرٌ لا يسعه هذا البحث، وليس الذي أريده.
5- واقتصرتُ في هذا البحث على المذاهب الأربعة المتَّبَعة، وأخذتُ رأي كلِّ مذهب من مصادره، إلا إذا لم يتيسَّر ذلك، فعندئذٍ أخذته حيث وجدته، وأشرت إلى مرجعه، ولكنَّ هذا نادر.
6- خرَّجت الأحاديث، وحرصت على بَيان درجة كلٍّ منها – ما تيسَّر لي ذلك – من صحَّة أو ضعف عزوًا إلى أهل العلم.
7- ترجمتُ للأعلام غير المشهورة الواردة في الرسالة، ولم أترجم للمشهور منهم.
وبعدُ:
فإنِّي إنْ أنسَ لا أنسى فضل سِيادة المشرف على هذه الرسالة أستاذنا الجليل د. أحمد عبدالرزاق الكبيسي، فقد كان له فضلٌ كبيرٌ في إتمامها بما بذله من وقت كثيرٍ في مراجعاتها، وبما أبداه من توجيهات كريمة وملاحظات قيِّمة، من إعداد خطَّة البحث حتى الفراغ من كتابتها، فجزاه الله خيرَ جزاء.
وأخيرًا:
أقدِّم شكري وتقديري للمسؤولين في هذه الجامعة، وأخصُّ بالذكر معالي رئيسها وعميد وإدارة كلية الشريعة فيها؛ لما أتاحوه لي من فرصة الدراسة في هذه الجامعة الرشيدة وفي هذا البلد الأمين، فلهم منِّي شكر ومن الله مثوبة وأجر، وآخِر دعواي أنِ الحمد لله رب العالمين.
الخاتمة:
وقد تَمَّ – بحمد لله – هذا البحث الذي تناوَلت فيه جانبًا من جوانب العلاقات بغير المسلمين.
وفي الختام أودُّ أنْ أُذكِّر بعض الأمور التي ينبغي للمسلم أن يهتمَّ ويلتزم بها في علاقاته ومعاملاته مع غير المسلمين؛ كي يحافظ على عصمة دِينه وعزَّته، وعلى القِيَم الإسلاميَّة في نفسه وأهله:
أولاً:
أنَّ الإسلام أمَر المسلمين بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد، ونهاهُم عن الكذب والغشِّ وسائر الأخلاق المذمومة في جميع مُعامَلاتهم مع الآخَرين، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، بل الأمر يأخُذ أهميَّة أكثر إنْ كانت العلاقة والمعاملة بغير المسلمين؛ وذلك لأنَّ غير المسلم لا يعرف شيئًا عن الإسلام في غالب الأحوال، ومن خلال علاقاته بالمسلمين يتعرَّفون على الإسلام، فإنْ كان المسلم ملتزمًا بدينه وعالِمًا بأحكامه، وصادقًا وأمينًا في قوله وعمله، ووَفِيًّا بوعده وعهده، ويُمثِّل الإسلام تمثيلاً يليق بشأنه – فحينئذٍ يكون معكسًا ومرآة طيبًا لجميع محاسن الإسلام ومزاياه، وقد يكون سببًا لهدايتهم وإقبالهم إلى الحق كما نرى ذلك في سلف هذه الأمة؛ إذ الإسلام دخل بعض البلدان بسبب التجار المسلمين؛ حيث شاهد أهلها فيهم الصدق والأمانة وسائر الأخلاق الإسلامية الطيِّبة في معاملاتهم التجارية والإنسانية معهم فأعجبهم دينهم فاعتنقوه، والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم.
أمَّا إن كان المسلم لا يلتزم بالقيم الإسلامية بل ذهب يغشه ويكذب عليه ويخلف وعده، فحينئذ لا يكون إلا سببًا لكراهته الإسلامَ وابتعاده عنه، فلا يحلُّ له ذلك؛ لأنَّه إساءة في سمعة الإسلام والمسلمين وإعطاء صورة مشوَّهة في حقِّهم.
ثانيًا:
إنَّ الإنسان بطبيعته يتأثَّر بغيره، وخُصوصًا إذا كان على صلةٍ دائمةٍ به، فإنْ كان هذا الغير من أهل الخير والصلاح يتأثَّر بما هو عليه، وإلا فبالشر والفساد إنْ كان من أهلهما؛ ولذلك ينبغي للمسلم أنْ يختار صاحبه من الصالحين، وأنْ يجتنب – مهما أمكن – مصاحبة الكفار والمنافقين ومعاشرتهم؛ لما فيه من احتمال التأثُّر بهم سيرةً وسُلوكًا؛ قال – عليه الصلاة والسلام -: ((لا تُصاحِب إلا مؤمنًا))[2]، قال في “عون المعبود“: “فيه نهيٌ عن مصاحبة الكفار والمنافقين؛ لأنَّ مصاحبتهم مضرَّة في الدِّين“[3].
وقال في حديثٍ آخَر: ((الرجل على دِين خليله فلينظُر أحدكم مَن يخالل))[4].
أي: إنَّه على عادة صاحبه وطريقته وسيرته؛ لتأثُّره به مع طول صحبته، فليتأمَّل مَن يُخالل: فمَن رضي دِينه وخُلُقه خالَلَه، وإلا فليجتنبه؛ فإنَّ الطباع سرَّاقة[5].
والظاهر أنَّ العلة في كراهة مصاحبتهم احتمال التأثُّر بهم عقيدةً وأخلاقًا؛ ولذلك يجبُ على المسلم أنْ يكون على يقظة تامَّة في علاقاته ومعاملاته الفرديَّة بغير المسلم؛ حتى لا يتأثَّر به من معتقداته وأخلاقه وعاداته الفاسدة والباطلة، فإنْ لم يأمن ذلك على نفسه وأهله فعليه أنْ يقطع تلك العلاقات معه، وألاَّ يعرض دينه وقيمته الإسلاميَّة على الخطورة؛ لأنَّ ما أُجِيزَ فيه من العلاقات مقيَّدة بما إذا لم يتضرَّر بها الإسلام والمسلمون عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا، وإلاَّ فلا يجوزُ له ذلك.
ثالثًا: ألاَّ تُؤدِّي هذه العلاقات إلى نُشوء المودَّة والمحبَّة القلبيَّة نحو الكافر؛ فإنَّ ذلك منهيٌّ عنه بنصِّ القرآن:
قال الله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الممتحنة: 1]، قال القرطبي: ” هذه السورة (يعني: الممتحنة) أصلٌ في النهي عن موالاة الكفار“[6].
قال – تعالى -: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 28]، قال ابن عباس – رضِي الله عنه – في الآية: “نهى الله – تعالى – المؤمنين أنْ يلاطفوا الكفار فيتَّخذوهم أولياء[7].
وقال – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [المائدة: 51]؛ أي: لا تصادفوهم ولا تعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم[8].
فهذه الآيات وغيرها تدلُّ على أنَّ المودَّة والمحبَّة للكفار محرَّمة على المسلم.
أمَّا ما رأيناه من إباحة العلاقات في بعض الأمور فمشروطٌ بعد وجود المودَّة الباطنية لهم.
قال في “تفسير الخازن“: “فإنْ قلت: قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم، فما هذه المودة المحظورة؟
قلت: المودة المحظورة هي مُناصَحتهم وإرادة الخير لهم دِينًا ودُنيا مع كُفرهم، فأمَّا سوى ذلك فلا حظر فيه“[9].
وفي “روح البيان“: “أمَّا المعاملة للمبايعة العاديَّة أو للمجاورة أو للمرافقة بحيث لا تضرُّ بالدِّين، فليست بمحرَّمة“[10].
فإنَّ سماحة الإسلام في بعض الأمور شيء، واتِّخاذهم أولياء شيء آخَر، فالأوَّل مسموحٌ ومودَّتهم ممنوعة ومحظورة.
وقد عقد القرافي بابًا في “فروقه” بيَّن فيه الفرق بين قاعدة برِّ أهل الذمة وبين قاعدة التودُّد لهم وقال فيه:
“اعلم أنَّ الله – تعالى – منَع من التودُّد لأهل الذمة بقوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الممتحنة: 1] فمنع الموالاة والتودُّد.
وقال في الآية الأخرى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾ [الممتحنة: 8].
وقال في حقِّ الفريق الآخَر: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ… ﴾ [الممتحنة: 9] الآية.
وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((استوصوا بأهل الذمَّة خيرًا))، وقال في حديثٍ آخَر: ((استوصوا بالقبط خيرًا))[11].
فلا بُدَّ من الجمْع بين هذه النصوص، وأنَّ الإحسان لأهل الذمَّة مطلوب، وأنَّ التودُّد والموالاة منهيٌّ عنهما، والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق.
وسرُّ الفرق: أنَّ عقد الذمَّة يُوجِب حقوقًا علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمَّة الله وذمَّة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ودِين الإسلام، فمَن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذيَّة أو أعان على ذلك، فقد ضيَّع ذمَّة الله – تعالى – وذمَّة رسوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وذمَّة دِين الإسلام“.
“وإذا كان عقد الذمَّة بهذه المثابة تعيَّن علينا أنْ نبرَّهم بكلِّ أمرٍ لا يكون ظاهره يدلُّ على مَودَّات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدَّى إلى أحدٍ هذين امتنع وصار من قِبَلِ ما نُهِي عنه في الآية وغيرها، ويتَّضح ذلك بالمثل، فإخلاء المجالس لهم عند قُدومهم علينا والقيام لهم حينئذٍ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفْع شأن المنادى بها، هذا كله حرام.
وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وضيقها، كما جرت العادة أنْ يفعل ذلك المرء مع الرئيس، والولد من الوالد، والحقير مع الشريف – فإنَّ هذا ممنوع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر، وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه، واحتقار أهله…”.
“وأمَّا ما أمر به من برِّهم من غير مودة باطنية:
فالرفق بضعيفهم وسد خلة (حاجة) فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذيَّتهم في الجوار مع القُدرة على إزالته؛ لطفًا منَّا بهم لا خوفًا وتعظيمًا، والدعاء لهم بالخير بالهداية، وأنْ يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دِينهم ودُنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرَّض أحدٌ لأذيَّتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأنْ يعانوا على دفْع الظُّلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم، وكل خير يحصل من الأعلى مع الأسفل أنْ يفعله، ومن العدو أنْ يفعله مع عدوه… فأنَّ ذلك من مكارم الأخلاق، فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أنْ يكون من هذا القبيل لا على وجه العزَّة والجلالة منَّا، ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم.
وينبغي لنا أنْ نستحضر في قلوبنا ما جُبِلوا عليه من بُغضنا وتكذيب نبيِّنا – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا، واستولوا على دِمائنا وأموالنا، وأنهم من أشدِّ العُصاة لربنا ومالكنا – عزَّ وجلَّ – ثم نُعامِلهم بعد ذلك بما تقدَّم ذكره؛ امتثالاً لأمر ربنا – عزَّ وجلَّ – وأمر نبينا – صلَّى الله عليه وسلَّم – لا محبَّة فيهم ولا تعظيمًا لهم، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صِفاتهم الذميمة؛ لأنَّ عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا من الرد الباطني لهم المحرَّم علينا خاصة…”.
وبالجملة فبرُّهم والإحسان إليهم مأمورٌ به، وودُّهم وتولِّيهم منهيٌّ عنه، فهما قاعدتان: إحداهما محرَّمة، والأخرى مأمورٌ بها، وقد أوضحتُ لك الفرق بينهما بالبيان والمثل، فتأمَّل ذلك“[12].
وهناك أمرٌ آخَر له صلة قوية بأمر محبَّتهم ومودَّتهم المنهي عنهما، وهو: أنَّ من طبيعة الإنسان أنَّه لا يحبُّ أنْ يلاقي أحدًا فظًّا غليظًا قاسيًا، سيِّئ الخلق خشن الكلام عابس الوجه؛ ولذلك فلا بُدَّ من اللطافة والليونة والبشاشة إلى حدٍّ ما لقيام العلاقات ودَوامها مع غيره، فهذا أمرٌ مطلوب بين المسلمين، لكنْ هل هذا يحرم على المسلم عند علاقاته بغير المسلم؛ لما فيه ممَّا يدلُّ على العودة والمحبة المحرَّمة عليه؟
والجواب: أنَّ هذه اللطافة والبشاشة لا يمنع منها الإسلام؛ لأنها ممَّا لا بُدَّ منه في العلاقات الاجتماعيَّة، ولأنها لا تدلُّ دائمًا على المحبَّة والعودة، فإنَّ كم من أهل الشر يُبَشُّ في وجوههم ولكنَّ القلوب تلعنهم، كما روي ذلك عن أبي الدرداء – رضي الله عنه – حيث قال: “إنَّا لنكشر في وُجوه أقوام وإنَّ قلوبنا لتلعَنُهم“[13].
ليس هذا نفاقًا ولا مداهنة، بل هي مُداراة مع الناس، وهي جائزةٌ عند العلماء، قال في “فتح الباري“: “المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، وظنَّ بعضهم أنَّ المداراة هي المداهنة، فغلط؛ لأنَّ المداراة مندوبٌ إليها والمداهنة محرَّمة.
والفرق: أنَّ المداهنة من الداهن؛ وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسَّرَها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكارٍ عليه.
والمداراة هي: الرفق بالجاهل في التعلُّم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه؛ حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلُطف القول والفعل، ولا سيَّما إذا احتِيج إلى تألفه“[14].
قال الحارث المحاسبي: “دارِ الناسَ ما سلم لك الدِّين، واحذر المداهنة أصلاً“[15].
وعلى هذا:
فيجوزُ للمسلم أنْ يداري غير المسلم ويعامله معاملةً طيِّبة في علاقاته به من غير مداهنة ومن غير مودَّة قلبيَّة، فإنَّ ما عليه غير المسلم من كفرٍ وضلالٍ يستلزم منَّا الحقد والبُغض نحوه، لكنَّ العلاقات الاجتماعيَّة تفرض علينا ألاَّ نظهر هذا الحقد والبغض، وإلا فلا يمكن إقامة العلاقات معهم من أيِّ نوع كانت.
وأخيرًا:
فإذا تنبَّه المسلم إلى هذه الأمور وغيرها ممَّا يحافظ به على عقيدته وعلى قيمه الإسلامية بالجملة، فلا بأس بإقامته علاقات فرديَّة بغير مسلمٍ في حُدود ما أجازَه الإسلام وفُقَهاء المسلمين.
والله أعلم بالصواب.
والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
[1] “مقدمة ابن خلدون” 41.
[2] أخرجه البخاري/ الرهن/ باب الرهن عند اليهود وغيرهم (2/888).
[3] أخرجه البخاري/ البيوع/ باب الشراء البيع مع المشركين وأهل الحرب (2/772)، مشعان؛ أي: منتفش الشعر، ثائر الرأس، (“النهاية” 2/884).
[4] أخرجه البخاري/ الشركة/ باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة (2/884).
[5] أخرجه البخاري/ الهبة/ باب الهدية للمشركين (2/924).
[6] أخرجه البخاري/ الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين (2/924).
[7] أخرجه البخاري/ الخصومات/ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (2/851).
[1] أخرجه البخاري/ الجهاد/ باب دعاء النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – إلى الإسلام والنبوة (3/1077).
حمُر النعَم: بفتحتين؛ أي: الإبل، وحمرُها أفضلُها (“مقدمة فتح الباري”/ 192).
[2] رواه أبو داود/ الأدب/ باب مَن يؤمر أن يجالس (5/167).
[3] “عون المعبود” 13/179.
[4] رواه أبو داود/ الأدب/ باب من يؤمر أن يجالس، والترمذي/ كتاب الزهد/ باب: 45، وقال: حسن غريب (4/589).
[5] “عون المعبود” 13/179.
[6] “تفسير القرطبي” 18/52.
[7] “تفسير القرطبي” 4/57.
[8] “تفسير أبي السعود” 2/72.
[9] “تفسير الخازن” 4/243.
[10] “روح البيان”؛ للبرسوي 9/412.
[11] متن الحديث : ((إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم؛ فإنَّ لهم ذمَّة، وإنَّ لهم رحمًا))؛ رواه عبدالرزاق في “مصنفه” 6/58.
[12] “الفروق”؛ للقرافي في 3/14 وما بعده، القرافي هو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي، ومن مؤلفاته: “الفروق”، “التنقيح في أصول الفقه”، و”الذخيرة”، توفي 684هـ (الشجرة/188).
[13] رواه البخاري تعليقًا موقوفًا على أبي الدرداء/ الأدب / باب المداراة مع الناس (5/2271).
وصله ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي في “غريب الحديث” والدينوري في “المجالسة” من طريق أبي الزاهر، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، وروي في “فوائد أبي بكر بن المقري” من طريق منقطع، وأخرجه أبو نعيم في “الحلية” من طريق منقطع أيضًا (“فتح الباري” 10/434).
[14] “فتح الباري” 10/424، راجع أيضًا لمعنى المداراة والمداهنة “رسالة المسترشدين”؛ بتحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 138، 139.
[15] “رسالة المتسرشدين” /138.
الحارث المحاسبي هو الحارث بن أسد المحاسبي العارف، صاحب التواليف، توفي ببغداد سنة 243هـ، (“ميزان الاعتدال” 1/430، رقم الترجمة: 1606).
المصدر:الألوكة







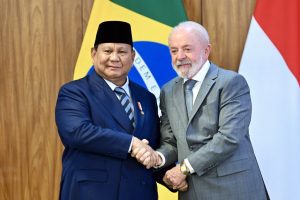





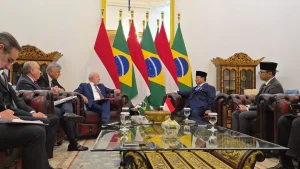






 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic