الأربعاء-23 رمضان 1434 الموافق31 تموز/ يوليو.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
النصيحة هي كلُّ قول طيِّب سديد، وكلِم نافع مفيد، فيه حثٌّ على صَلاح، ونَهي عن طلاح؛ لأنَّ فيها سدًّا للخَلل، وعلاجًا للأدواء والعِلل، وتَنقية للشوائب، ودرءًا للعيوب والمَثالِب، كما أنَّها كلمة جامِعة تَحمِل في طيَّاتها حِيازة الخير للمنصوح، وقد قيل: ليس في كلام العرب كلمة جامِعة أجْمع للخير في الدارَين من (النصيحة)، والنصيحة لله وفي الله وبالله أمرٌ جَلل وذاتُ شأن عظيم، بل هي الدِّين كلُّه، حصَره النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فيها فقال: ((الدين النصيحة))، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابِه، ولرَسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم))[1].
ومن هنا اشتملتِ النصيحة على خِصال الإسلام ودعائم الإيمان، كما أنَّها من وظائف الأنبياء والرُّسل، ومن بعدهم الصالِحون فالتَّابعون منذ قديم الزمان؛ فقد ذكَر الله – تعالى – على لسان نوح – عليه السلام – قوله لقومه: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 62]،وقال – سبحانه – على لسان هود: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [الأعراف: 68]، وعلى لسان صالح قال: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: 79]، وقال على لسان شُعيب: ﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ [الأعراف: 93]، وكأنِّي بهذا لا أكون قد أخطأتُ إذ أُسمِّي سورة الأعراف بسورة النُّصح؛ لما تَكرَّر فيها من نُصْح الأنبياء لأقوامهم، وقال – تعالى – على لسان نبيِّنا محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ﴿ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِين ﴾ [النمل: 92]؛ أي: من الناصحين المُخوفين من عذاب الله ربِّ العالمين، وقد اعترَضوا عليه فيما حَكى القرآن في قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [ص: 4] – صلَّى الله عليه وسلم – فأمَرَه – تعالى – بتوضيح الأمر في نفْس السورة بقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [ص: 65]، ولعلَّك أخي القارئ أنَّ النصيحة في الله وبالله ولله إنَّما هي تَبليغ الخير للناس برسالة الله، وهذا ما قد بيَّنتْه الآيات السَّابِقات؛ لأن النصيحة بتبليغ رسالة الله رب العالمين هي أَجَلُّ الأمور وأعظمُها وأبينُها وأحسنُها، وقد مدَح الله القائمين على هذا العمل بقوله – تعالى -: ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: 39]، وقد رُوي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنَّه قال: “لا خير في قوم ليَسوا بناصِحين، ولا خيرَ في قوم لا يُحبُّون الناصحين”، وهكذا هي طريقة كلِّ من سار على درْبِهم من العلماء والأولياء وسائر الصالِحين، ومن هنا كان حقٌّ للنصيحة أنْ تَتبوَّأ هذه المنْزلة الرفيعة، والمكانة الراقية المَنيعة، ولمَ لا؟ وهي مُهمَّة رُسُل الله وأنبيائه
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
إنَّ النصيحة حقٌّ من حقوق المؤمن على المؤمن أخيه أو أبيه أو ابنه أو صاحبه، فكلٌّ منهم للآخر ناصِح وموجِّه، مُرشِد ومُنبِّه؛ لأنَّها حماية وحفْظ ووقاية، فقد تُنقِذ المنصوحَ من أخطار مُحدِقة، وكوارثَ مُحقَّقةٍ، فقد كانت سببًا في نَجاة موسى – عليه السلام – من الهلاك؛ قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [القصص: 20]، وآخر يَنصَح مدينة بأكملها لاتباع رُسل الله، فقال – تعالى -: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: 20]، ولِمَ لا نَتَّبع نصيحة مُحبٍّ باتِّباع من نحب أنْ نكون في حفْظه وحماه؟ فكم للنصيحة من ثَمراتٍ، وكم لها من خيرات ومُعطَيات، وعلى المنصوح أنْ يَستقبِلَ النصيحة بترحاب لا تَشوبُه مَضاضة، حيث لا حرجَ في ذلك ولا غَضاضة، ولقد احْتضَن القرآن الكريم العديد من النماذج الناصِحة، منها ما كان من الأب لولده، كنصيحة لقمان ويعقوب، ومنها ما كان من الصاحِب لصاحِبه، كنصيحة يوسف لصاحبَيه في السجن، وكذلك حين اغْترَّ صاحب الجنَّتَين بجنَّتَيه وما فيهما من كثير ثَمَرٍ، وما عنده من غزير نَفَر، حتَّى أوصَلَه الكِبْر والغرور، إلى إنكار يوم البعث والنشور، حينئذٍ نَصَحه صاحبه حاثًّا إيَّاه، على الإيمان بالله، وحذَّره من سوء حاله، وضَياع ماله، فقال – تعالى -:﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: 37 – 39]، ومنها ما كان من الابن لأبيه كالتي نحن بِصددها، كنصيحة إبراهيم – عليه السلام – لأبيه، ومن هنا ينبغي أنْ تكون النصيحة مُتَّسِِِمة باللُّطف والإحسان، وإرشاد المنصوح إلى ما فيه صلاحه، وظَفَره ونَجاحه، ودَفعُ الأَذى والمكروه عنه ما اسْتطاع النَاصِح إلى ذلك سَبِيلاً، وأنْ يَقصد من وراء نصيحته الحفْظ والصَّون، وتَقديم العون، وردَّ المنصوح إلى الحقِّ إنْ ضلَّ، واستنهاضه من عثْرتِه إنْ زلَّ، بلينٍ ويُسر، لا عنفَ فيه ولا عُسر، ولكي تُؤتِي النصيحة ثِمارها المرجوَّة، وفوائدها المأمولة؛ لا بدَّ من اتِّسامها بالإخلاص؛ لأنَّه في كلِّ شيء قاعدة وأساس، فبدون الإخلاص فيها خرج آدم وزوجه حواء من الجنَّة، فقال – تعالى – على لسان إبليس: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: 20، 21]، كما أنَّ من أهمِّ بواعِث النصيحة ودواعيها الخوفَ والحب والرجاء، خوفًا على المنصوح، ورغبة من النَّاصِح في إصلاح حاله، وسلامة مستقبله ومآله؛ حتى تَنصلِح أحواله، ومن هنا وجَب عليه استقبال نصيحة الحبيب، بصدْر مُنشرِح رحيب.
وقد تعرَّضنا في مقال سابِق للشجاعة الأدبيَّة في النصيحة الأبويَّة، التي تَهزُّ الولد هزًّا من أبيه؛ مَخافةً عليه، واليوم نتعرَّض للنصيحة الابنيَّة، التي تَهزُّ الوالِد هزًّا من ولَدِه حبًّا وشفقة عليه، فلا عجب أنْ يَدعو الوالد ابنه ويتعهَّده بالنُّصح والصلاح، فهو ابنه ومن صُلبه، ويُمثِّل قِطعة منه، ولكن الأعجب أنْ يَتعهَّد الابن أباه بالنُّصح والنصيحة إذا كان على غير التوحيد، خاصَّة أن الابن هو الأصغر سنًّا، والأقل خبرة ودراية من أبيه، ونظرًا لأهمية القضية المطروحة التي نَجدُها نصًّا في قصة إبراهيم – عليه السلام – والتي تَكشِف عمَّا في عقيدة الشرك من نَكَارة وكذِب وضَلال؛ فقد ذُكِرت قصَّته في خمس وعشرين سورة وفي ثلاث وستين آية من القرآن الكريم، وتَبدو في هذه الحلقة شخصيَّة إبراهيم الابن الرضي الحليم، تَبدو وداعتُه وحلْمه في ألفاظه وتعبيراته التي يَحكي القرآن الكريم تَرجمتَها بالعربيَّة، وفي تَصرُّفاته ومواجهتِه للجَهَالة من أبيه، وشجاعته الأدبيَّة وشدَّة حبِّه له ودعوته إلى التوحيد، وقد ذكَرها في أيما موضِع، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: 74]، كما تتجلَّى رحمة الله به وتعويضه عن أبيه وأهله ذريَّة صالحة تَنسل منها أمَّة، فيها الأنبياء وفيها الصَّالِحون، ويَصف الله إبراهيم بأنَّه كان صدِّيقًا نبيًّا؛ أي: كثير الصِّدْق والتصديق، وكلتاهما تُناسِب شخصية إبراهيم – عليه السلام – فقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا * قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ [مريم: 41 – 48]، كلمات تَهزُّ عطْف السامِعين الخاشِعين المُنصتِين، بهذا اللطف في الخطاب، يَبدأ إبراهيم دعوتَه ونصيحته إلى الله بدعوة أبيه، ويُكرِّر دعوتَه له؛ لأنَّه أقرب الناس إليه وأولى الناس بما عنده من خير، مُستعمِلاً مع أبيه لفظة (يا أبتِ)؛ ليُشعِره بأنَّه ابنه، والابن البار يكون حريصًا على ما يَنفعُ والده بنُصْحه، وهذا عَين ما فَعَله النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وقد نزَل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: 214]، فكان إبراهيم – عليه السلام – حريصًا على أنْ يَهديَه إلى الخير الذي هَداه الله إليه وعلَّمه إيَّاه، وهو يَتحبَّب إليه، ويُكرِّر دعوتَه بغاية اللطف واللين والرِّفْق، فكان في دعوته إيَّاه مُراعيًا آداب النصيحة وحسْن أدبِ الصغير مع الكبير، قويَّ الحُجَّة، صابرًا مُحتسبًا كلَّ أذًى يَلقَاه في سبيل دعوته، فما أحوجَنا إلى داعية يَسلُك في دعوته أحسنَ مِنْهاج وأقوم سبيل، مع حُسن الأدب والخُلق الجميل! وذلك حتى لا يَركَب المدعوُّ مَتْن المُكابَرة والعناد، ولا يَنكب بالكليَّة عن مَحجَّة الرَّشاد، يَدعو إبراهيم أباه: ﴿ يَا أَبَتِ ﴾، ويسأله: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: 42]؟ والأصل في العبادة أنْ يَتوجَّه بها الإنسان إلى من هو أعلى منه وأَعلَم وأقوى، وأنْ يَرفَعها إلى مقام أَسمى من مَقام الإنسان وأَسْنى، فكيف يتوجَّه بها إذًا إلى ما هو دونه، بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان، لا يَسمعُ ولا يُبصِر ولا يَملِك ضرًّا ولا نفعًا؟! إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قريش الذين يُواجِههم الإسلام، لقد كانت كلمات إبراهيم تفيض حنانًا وشفَقة، وتَتدفَّق عطفًا ورقَّة، فبيَّن لأبيه أنَّ ما يَعبده فاقِد لأوصاف الربوبيَّة من السمع والبصر، فضلاً عن الخَلْق، فكيف يَضرُّ أو ينفع؟ هذه هي اللَّمسة الأولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوتَه لأبيه، ثم أردَف يُتبِع ذلك ببيان ما قد أُوتيه من عِلم وحكمة، وأنَّ دعوتَه قد بُنيتْ عليهما؛ ففي اتِّباعه سلوك الصراط السَّوي؛ لأنه لا يقول هذا من نفسه؛ إنَّما هو العِلم الذي جاءه من الله فهداه، وإن كان أصغر من أبيه سنًّا وأقلَّ تَجرِبة، ولكن المدد العلوي جعَله يَفقَه ويَعرِف الحقَّ، فهو يَنصَح أباه الذي لم يَتلقَّ هذا العِلم، ليَتَّبِعه في الطريق الذي هُدي إليه: ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: 43]، ثم حذَّره من عدو البشرية الذي تَلبَّس بمعصية الرحمن، فهو جدير بأنْ يُتَّخذ عدوًّا وألا يُطاع، ثم أَعلَمه بشدَّة خوفه عليه من أنْ يَمسَّه مُجرَّد مس عذاب من الرحمن فيكون وليًّا للشيطان، وأمام هذه الدعوة الحانية الرفيقة المُتَّزِنة، نَسمَع عبارات الأب الفـجَّة الغليظة التي تُمثِّل صورة التقليد الأعمى وإغلاق القلب عن النَّظر والتأمُّل، ومع ذلك كله فإنَّ الابن البار لم يُواجِه تلك السيئةَ إلا بالتي هي أحسن: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ ﴾ [مريم: 47]، كحال قول الله – تعالى -: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: 63]، بل ووَعَد بالاستغفار لأبيه، وذلك قبل أنْ يَتبيَّن له أنَّه عدو لله، كما قال – تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيم ﴾ [التوبة: 114]، ثُم قرَّر اعتزاله؛ ليُراجِع الأب نفسه، وليَنأى إبراهيم بنفسه عن الشر ومواطنه، فليست هناك غَضاضة في أنْ يَتَّبِع الوالِد ولدَه، إذا كان على اتِّصال بمصدر أعلى؛ فإنَّما يَتَّبِع ذلك المصدر، ويَسير في الطريق إلى الهدى، وهكذا بقدْر انصباغ نفس المسلم بمعاني الإسلام يكون بروز شخصيَّته الإسلاميَّة، فهذا هو إبراهيم الأمة ومع ذلك ظلَّ مُحتفِظًا بتواضعه وهضْمه لنفْسه في تَواضُع لله، مُستعينًا بكلمة (عسى)؛ إذ فيها من الحُسن والأدب والتنبيه على أنَّ الإنابة بطريق التفضيل من الله قائلاً: ﴿ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا ﴾، وكانت رحمة الله به أنْ عوَّضه بأبناء صالحين بَرَرة عن أولئك القوم الفَجَرة.
في هذه الآيات البيِّنات إشاراتٌ سريعة يَنبغي أنْ نَعيَها جيِّدًا في حياتنا، نوضِّحها فيما يلي:
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
• النصيحة الخالِصة لله في الله وبالله من دَعائم وركائز الدِّين، بل هي الدِّين كلُّه،؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((الدين النصيحة)).
• تَملُّك الفرد للشجاعة الأدبيَّة في الدعوة إلى التوحيد الخالِص لله، والبداية في الدعوة للأقرَبِين.
• التشنيع على المعبودات الباطِلة وعابِدِيها، وذلك قول إبراهيم لأبيه: ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: 42].
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
• التأكيد على إبراز صفةِ السَّمع والبصر، والنَّفع والضر لله رب العالمين، وذلك مُستفادٌ من قوله أيضًا: ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾.
• تقرير توحيد الألوهيَّة ببيان دلائل الربوبية، وذلك مُستفَاد أيضًا من قوله – تعالى – في التقرير النبوي غير المباشر: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾.
• امتِثال الدُّعاة والناصحين لتلك الصفات العظيمة التي تَحلَّى بها إبراهيم – عليه السلام – حتى قال الله – تعالى فيه -: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: 37]، فكانت نِبراسًا يَقتفي أثرَه فيها الدُّعاةُ إلى الله.
• استغراق القرآن واستقصاؤه لأساليب إبراهيم المتنوِّعة في عرْض دعوته على قومه، ونُصْحه لأبيه، حتى إنَّه لَيعزُّ على الباحث أنْ يَجد لنبيٍّ من الأنبياء – خلا نبينا صلى الله عليه وسلم – مِثلَما يَجد لهذه الأيام من الطرائق والسُّبُل في إقناع المدعوِّين وتَرويضهم على قَبَول الدعوة.
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
• رسَمتْ هذه الدعوة للدُّعاة مِنهاجًا في الصبر يَحقُّ لهم أنْ يَقتدوا به، فقد صبَر إبراهيم – عليه السلام – في أحوال مُختلفة، وظروف مَتباينة، وأعمالٍ مُتنوعة؛ كالصبر على جَفَاء الأبوة، وعُدوان العشيرة، وهِجران الأرض، والفتنة بالنار، والأمر بذبْح الولَد.
• التصريح بقصْد النصيحة، وأنَّه لا هدَف للدَّاعي إلا نفْع المدعوِّين؛ برًّا بهم، ومَخافةً عليهم، وأنَّه لا يريد على ذلك حظًّا من الدنيا.
• الدعوة إلى الله والنصيحة لا تكون إلا بالحكمة والموعِظة الحسنة، وقد جاءتْ جليَّة في دعوة إبراهيم لأبيه وخِطابه الرقيق الحاني المُتدفِّق لينًا وعطفًا ولطفًا؛ اتِّباعًا للحكمة التي تُقرِّب المدعوَّ من الدعوة، وتُلين قلبَه للاستجابة.
• المُلاطَفة وخفْض الجَناح ومراعاة آداب النصيحة، مع حسْن الأدب والخُلق الجميل، خاصَّةً مع كِبار السنِّ والمقام منهم بصفة عامة، ومع الآباء بصفة خاصَّة.
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
• إشارات واضِحة وصريحة بأنَّ الله وحدَه هو السميع البصير، الذي يَملِك الضرَّ والنَّفْع، وما عداه فهو باطلٌ لا أثرَ له ولا تأثير.
• إنَّ طريق الله هو الصراط السوي المستقيم، الذي يُؤدِّي بصاحبه ويُوصله إلى برِّ الأمان، وإنَّ طريق الشيطان هو طريق اعوجاج لا أملَ فيه ولا إصلاح، وذلك قول إبراهيم – عليه السلام -: ﴿ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: 43].
• إشارة واضِحة المعالَم في السياق الكريم بإظهار قُبْح المعصية، وبأنَّ طريق الشيطان نهايته عذابٌ من الرحمن، وهذا هو العذابُ الأليم.
• تَحوُّل الداعية أحيانًا من أسلوب الترغيب إلى أسلوب الترهيب، مع عدم الخروج عن حدود اللَّباقة والأدَب في الدعوة، إذا احتاج الأمر ذلك، وذلك قوله – تعالى – على لسان إبراهيم: ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [مريم: 45].
قراءة المزيد: أجمل دعاء في رمضان
• تَحمُّل الأذى من الكبار مما لا نَتحمَّله من غيرهم؛ لمزيد حقِّهم والشفقة عليهم، وذلك قوله – تعالى – على لسان آزر: ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم: 46].
• مقابلة الإساءة بالإحسان مما يَنبغي أن يتسلَّح به الابن الراشِد، فلا يَستعمِل من الكلمات إلا ما حَسُن منها وطاب.
• صاحب الشخصيَّة المسلمة الحق لا يَتأثَّر بالبيئة الفاسدة من حوله، بل يَسعى في أنْ يُؤثِّر فيها ويُصلِحها، ولا يَتأثَّر هو بها وبمفاسدها.
قراءة المزيد: توصية رمضان ١٤٣٨ ه
• الجزاء من جنْس العمل، فمن برِّ إبراهيم بأبيه آزر، يكون الجزاء من جنْس البرِّ، فيَبره ولده إسماعيل، حين يرى إبراهيم رؤيا الذَّبح، فيَعرِض الأمر على ولده قائلاً كما قال – تعالى -: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: 102]، مُستعمِلاً إسماعيل لفْظَة والده إبراهيم – عليهما السلام – مع أبيه، وذلك قوله: ﴿ يَا أَبَتِ ﴾.
[1] رواه مسلم عن تميم بن أوس الداري – رضي الله عنه.
المصدر : الألوكة
قراءة المزيد: أشياء يجب عليك توفيرها في موائد الرحمن خلال رمضان













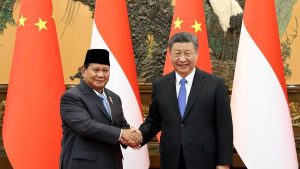






 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic