الجمعة 13 ذوالحجة1434 الموافق18 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
عندما جاء الإذن للرسول والمسلمين من الله – سبحانه وتعالى – بالقتال بعد أربعة عشر عامًا من الصبر على أقسى صور الإذلال والملاحقة، لم يتوانَ الرسول – عليه السلام – في الخروج بالمسلمين على شكل سَرايا وغزوات؛ وذلك لتأمين حياتهم في المدينة، في مواجهة القبائل المتربِّصة بهم، وفي مواجهة قريش التي لا تريد أن تَعترف بكِيانهم الجديد، ولا أن تَرفع سِياطها عن المستضعفين المُعتقلين لديها، الممنوعين من الهجرة، ولا أن تكفَّ عن مُصادرة أموالهم، وعن ملاحقة الدولة الجديدة بصورة التآمُر والتأليب والتحريض لليهود والمنافقين في المدينة، وللقبائل الأخرى في الجزيرة.
قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية
وكانت السرايا أشبه بالدوريات الاستطلاعية التي تسعى لفرض الهَيبة وإشعار الآخرين باليقَظة، وأيضًا لاستكشاف الطرق المحيطة بالمدينة، والتي يُمكن أن يَنفُذ منها الأعداء، وعقد معاهدات السلام مع القبائل التي تقع مساكنها على هذه الطرق، فضلاً عن جمْع المعلومات عن هذه القبائل وصِلتها بقريش، والتفاهم معها لتزويد المسلمين بالمعلومات عن تحرُّكات أهل مكة ضد دولة الإسلام في المدينة.
ومن متابعة حركة السرايا، يبدو أن السرايا التي يقل عدد أفرادها عن عشرة أفراد، كان هدفها استقصاء الأخبار وجمع المعلومات، إلا إذا فرَض الأعداء عليها الدفاع عن نفسها، أما السرايا الأكثر عددًا، فكانت سرايا مسلحة ومُدربة، هدفها إرهاب العدو؛ حتى لا يفكر في غزو المدينة، وكانت على استعداد للاشتباك عند اللزوم – مع جمعها للأخبار والمعلومات أيضًا – وكان عدد بعض هذه السرايا يتجاوز مائتي مقاتل[1].
قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة
وثمة مَلمحٌ هنا نَسوقه لتأكيد الطبيعة الإنسانية الأخلاقية لهذه السرايا، فمن المعروف أن جزيرة العرب كانت في عصور كثيرة – ومنها العصر الذي نتكلم عنه – تَعِجُّ بكثيرٍ من قوافل السلب والنهب – لنتذكَّر هنا قصة سلمان الفارسي، وزيد بن حارثة وغيرهما – وكانت الصحراء تبدو ملكًا لهذه القوافل – التي يمكن أن تستغل أيضًا – عن طريق المال لقريش وغيرها؛ لجمْع المعلومات عن المسلمين، وترويع أهل المدينة، فكانت السرايا هي الحل الأمثل للوقوف ضد هذه القوافل من جانبٍ، ومن جانب آخر سوف يرى الناس في الجزيرة أن قوافل – أو سرايا – رسول الله، على العكس من هذه السرايا في سلوكها وتعامُلها، فهي لا تَمدُّ يدها بسوء لأي شخصٍ، لا لماله ولا لعِرضه، ولعلها المرة الأولى في الجزيرة التي تمرُّ فيها قوافل على هذا النحو من أمام البيوت والمساكن، تَبعث على الأمن لا الخوف، وتدعو إلى التعاهد على السلم، وتُقاوم قوافل السلب والنَّهب، وسوف يشعر العرب بأن هناك مَن يمكن أن يَطمئنوا إليه ويَجدوا في ظلاله الأمن إذا وضَعوا أيديهم في يده، كما أن قريشًا التي كانت تريد أن تبقى مسيطرة على الجزيرة كلها، لَم يعد الظرف الجديد يَسمح لها بذلك؛ فهناك مَن يتربصون بها وبتجارتها، ولن يَكفوا عنها؛ حتى تُسالمهم وتعترف بكِيانهم وحقِّهم في الحياة، والدعوة لعقيدتهم، وهذه المعاني السامية كلها حقَّقتها السرايا أولاًَ، والغزوات ثانيًا.
♦♦♦
وكانت السرية الأولى في رمضان من السنة الأولى للهجرة، فقد جعل الرسول عليها عمَّه حمزة بن عبدالمطلب، ومعه ثلاثون شخصًا، أُرسلوا إلى سيف البحر، فلَقُوا عِيرًا لقريش بقيادة أبي جهل، فيها ثلاثمائة مشرك، ولم يَحدث قتال، إلا أن أبا جهل – بالطبع – قد فَهِم الرسالة الموجهة إلى أهل مكة، وهي أن هناك قوة جديدة تَفرض عليهم السلام والاعتراف بها، وإلا ستُهدد مصالحهم التجارية.
قراءة المزيد: مرحباً بشهر رمضان، شهر البر والتقوى
♦♦♦
وفي شوال خرَجت السرية الثانية في ثمانين راكبًا على رأسها عبيدة بن الحارث، وفيها سعد بن أبي وقاص، ولم يحدث قتال، إلا أن سعدًا رمى بأوَّل سهمٍ في الإسلام، وفرَّ إلى المسلمين المقداد بن عمرو (الأسود)، وعُتبة بن غزوان، وكانا قد أسلما وحُبِسا في مكة.
قراءة المزيد: الأربع مشاكل صحية الأكثر شيوعا للصيام وطرق علاجها منزليا
♦♦♦
وفي السنة الثانية للهجرة خرَج الرسول الكريم – قبل بدر – بقيادة ثلاث غزوات وسرايا، فقد خرج ليَعترض عيرًا لقريش عند (ودان)، فلم يدرك العير، وعاهَد بني صخرة على الأمان والتناصر، ثم بلَغه أن عيرًا لقريش يقودها أُميَّة بن خلف في مائة من قريش، ذاهبة إلى الشام، فخرج لمُلاقاتهم في مائتين من المهاجرين حتى بلغ بواط، فوجد العير قد فاتَته، ولم يَلقَ كيدًا، وكذلك خرج الرسول ومعه مائة وخمسون في غزوة العشيرة؛ لملاقاة عير لقريش يقودها أبو سفيان، ففاته العير، ووادَع بني مُدلج وحلفاءَهم، ثم عاد إلى المدينة ينتظر رجوع القافلة، فرجَعت وأفْلَت بها أبو سفيان، ثم كانت – بسبب هذه العِير – غزوة بدرٍ الكبرى.
ونلاحظ أن السرايا السابقة خلَت من الاشتباكات الدموية؛ مما يؤكد طبيعتها ووضوح أهدافها التي أشرنا إليها سابقًا.
قراءة المزيد: الدعاة بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن
♦♦♦
وقد أغار على المدينة كرز بن جابر الفهري، وهرَب، فخرَج الرسول في طلبه، ولم يُدركه، وهذه تُسمى غزوة بدر الأولى، ثم خرَج عبدالله بن جحش على رأس سرية من ثمانين رجلاً، حتى نزلوا (نخلة) في طريق البصرة بأمر الرسول، ولقوا عيرًا لقريش تريد مكة فيها عمرو بن الحضرمي، فقتَلوه في آخر أيام رجب، وأسروا عثمان بن المغيرة والحكَم بن كيسان، فكرِه الرسول ذلك منهم، وقال: ((لم آمُركم بقتالٍ))، وأفرَج عن الأسيرين، وأرسل دِيَة القتيل، ومع ذلك شهَّر المشركون بالمسلمين، وقالوا: إنهم قاتَلوا في الأشهر الحُرم، فنزَلت آيات سورة البقرة تدافع عنهم: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: 217].
قراءة المزيد: أجمل دعاء في رمضان
♦♦♦
وفي غزوة بدر الكبرى – 17رمضان 2هجرية – عدَّل رسول الله صفوف المسلمين، وكان في يده قَدَحٌ يُعدِّل به، وكان سَواد بن غَزيَّة مُسْتَنْتِلاً من الصف، فطَعنه الرسول في بطنه بالقدَح، وقال: ((استوِ يا سواد))، فقال سواد: يا رسول الله، أوجَعتني، فأقِدني، فكشَف عن بطنه، وقال: ((استقِد))، فاعتنَقه سواد، وقبَّل بطنه، فقال: ((ما حمَلك على هذا يا سواد؟)) قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأرَدت أن يكون آخر العهد بك أن يَمسَّ جلدي جلدك، فدعا له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بخير، وهذه لمسة إنسانية تدل على الطابع الأخلاقي الكريم للرسول القائد الرحيم مع أصحابه وأعدائه.
ومع بداية المعركة أخذ الرسول يتضرَّع إلى ربِّه في إلحاحٍ وخضوع؛ فقد روى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال: لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، وذلك ليلة بدر، وهو يُكثر من قول: يا حيُّ يا قيُّوم، ويُكرِّرها وهو ساجد، وكان – صلى الله عليه وسلم – يَرفع يده ويَهتف بربه ويقول: ((اللهم إن تَهلِك هذه العصابة لا تُعبد بعد في الأرض، اللهم أنجِز لي ما وعَدتني، اللهم نصرك، ويرفع يده إلى السماء حتى سقط رداؤه عن مَنكِبيه، وجعل أبو بكر يقول له مشفقًا عليه: يا رسول الله، كفاكَ مناشدتك ربَّك، فإنه مُنجز لك ما وعَد.
قراءة المزيد: توصية رمضان ١٤٣٨ ه
وهذا الموقف أيضًا دليل من الأدلة التي تدل على الطبيعة الإيمانية لحروب الرسول – صلى الله عليه وسلم.
♦♦♦
قراءة المزيد: أشياء يجب عليك توفيرها في موائد الرحمن خلال رمضان
وفي غزوة أُحد، وبعد خيانة عبدالله بن أُبي بن سلول، وعودته بثلاثمائة (ثُلث الجيش)، قام النبي – صلى الله عليه وسلم – ببقية الجيش – وهم سبعمائة مقاتل – ليُواصل سيره نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين (أحد) في مناطق كثيرة، فقال: ((مَن رجل يخرج بنا على القوم من كثبٍ – أي: من قريب – من طريقٍ لا يَمر بنا عليهم؟))، فقال أبو خيثمة : أنا يا رسول الله، ثم اختار طريقًا قصيرًا إلى (أُحد)، ومرَّ الجيش من هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي – وكان منافقًا ضرير البصر – فلما أحسَّ بالجيش المسلم، قام يَحثو التراب في وجوه المسلمين، ويقول: لا أُحِلُّ لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله، فابتدَره القوم ليَقتلوه، فقال: لا تَقتلوه؛ فهذا أعمى القلب، أعمى البصر، وترفَّع الرسول عن قتْل الأعمى مع إساءته للرسول والجيش، وهذه لمسة إنسانية نراها جديرة بالتقدير.
• ومن المعروف أنه بعد انتصار المسلمين في موقعة أُحد – في أول المعركة – خالف الرُّماة أمر الرسول لهم بألاَّ يَتركوا مواقعهم، قائلاً لهم ولقائدهم عبدالله بن جُبير: ((انضَحِ الخيل عنا بالنبل، لا يَأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا، فاثبُت مكانك، لا نُؤْتَيَنَّ من قِبَلك))؛ (البخاري وأبو داود باب الجهاد)، وفي رواية للبخاري أيضًا: ((إن رأيتمونا يَخطَفنا الطيرُ، فلا تَبرحوا، وإن رأيتمونا ظهَرنا، فلا تَبرحوا حتى أُرسل إليكم))، ومع ذلك نزل أربعون منهم مُعرِّضين قائدهم عبدالله بن جبير وتسعة معه للإبادة.
قراءة المزيد: كيفية صلاة قيام الليل في رمضان
وعندما أدرك هذه الثغرة خالد بن الوليد، انقضَّ منها على المسلمين، ثم ركَّز المشركون جهودهم ضدَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – وطمِعوا في القضاء عليه، فرماه عُتبة بن أبي وقاص بالحجارة، فوقع لشقه، وأُصيبت رَباعيته اليمنى والسفلى، وكُلِمت شفَته السفلى، وتقدَّم إليه عبدالله بن شهاب الزهري، فشَجَّه في جَبهته، وجاء فارس عنيد هو (عبدالله بن قَمئة)، فضرَبه على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكا لأجلها أكثر من شهرٍ، ثم ضرب على وجنته – صلى الله عليه وسلم – ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حِلَق المِغْفَر في وَجنته، وقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – له وهو يَمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله، فلم يَلبَث أن هلَك عندما نطَحه تيسٌ أثناء عودته!
وفي الصحيحين أنه – صلى الله عليه وسلم – كُسِرت رَباعيته، وشُجَّ في رأسه، فجعَل يسلت الدم عنه، ويقول: ((كيف يُفلح قوم شجُّوا وجْه نبيِّهم، وكَسَروا رَباعيته وهو يدعوهم إلى الله)).
قراءة المزيد: معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة
ومع كل ذلك كان لا يَفتأ – عليه السلام – أن يقول: ((اللهم اغفِر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون))، وفي رواية مسلم: ((ربِّ اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون)).
• ومع أن منظر الشهداء كان مريعًا يُفتِّت الأكباد، فحمزة – رضي الله عنه – لم يوجد له كفنٌ إلا بُردة مَلحاء، إذا جعلت على رأسه قلَصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلَصت عن رأسه، حتى مُدَّت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر، ومع أن هندًا بنت عُتبة مثَّلت به، وأخرَجت كبده لتأكلها، ثم لفَظتها.
ومع أن الداعية العظيم مصعب بن عُمير – رضي الله عنه – كُفِّن في بُردة؛ إن غُطِّي رأسه، بدَت رِجلاه، وإن غُطِّيتْ رجلاه، بدا رأسه، ورُوي مثل ذلك عن خبَّاب، وفيه : ((فقال لنا النبي – صلى الله عليه وسلم – غطَّوا بها رأسه، واجعلوا على رِجله الإذخر))، (وهو نبات).
• مع كل هذا العناء الذي كابَده الرسول، فإنه – صلى الله عليه وسلم – أمر أصحابه – بعد أن انصرف المشركون – بأن يقفوا صفوفًا، وقال لهم: استَووا حتى أُثني على ربي – عز وجل – فصاروا خلفه صفوفًا، فقال: ((اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابِض لما بسَطت، ولا باسط لما قبَضت، ولا هادي لمن أضْلَلت، ولا مُضل لمن هدَيت، ولا معطي لما منَعت، ولا مانع لما أعطَيت، ولا مُقرِّب لما باعَدت، ولا مُبعد لما قرَّبت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم، الذي لا يحول ولا يَزول، اللهم إني أسألك العون يوم العَيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شرِّ ما أعطيتنا وشر ما منَعتنا، اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيَّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعَلنا من الراشدين، اللهم توفَّنا مسلمين، وأحْينا مسلمين، وألْحِقنا بالصالحين، غير خَزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رُسلك، ويَصدون عن سبيلك، واجعَل عليهم رِجزك وعذابك))[2].
• ومع كل ما أصاب الرسول والمسلمين من جرَّاء مخالفة الرُّماة لأمر رسول – صلى الله عليه وسلم – الصريح الواضح أولاً، ومخالفتهم لأمر قائدهم الذي ولاَّه عليهم رسول الله، وهو عبدالله بن جبير ثانيًا، وما نجَم عن ذلك من هزيمة للجيش المسلم بعد انتصاره، ومع أن القوانين الوضعية الدولية كلها تطبِّق أقصى العقوبات – ومنها الحكم بالإعدام – على مُرتكبي مثل هذه المخالفة، إلا أن الأمر الإلهي الرحيم نزَل على نبيِّ الرحمة يقول له: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 152]، وبقوله له أيضًا: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾[آل عمران: 159].
• وهكذا من خلفِ كل الآلام والمِحن، كانت القيم الإنسانية والربانية هي الحاكمة لكل التصرفات في أُحد (شوال 3هـ)، فلم يَسمح الرسول لنفسه بأن يَحمل مشاعر الانتقام من قومه، وأن يدعو عليهم كما دعا بعض الأنبياء على أقوامهم، بل دعا لهم في أحلك الظروف بالهداية، وحتى الرماة المسلمون – وهم السبب في هذه المحنة – لم يَسمح الله بالانتقام منهم، ولقد لقِي هذا رضًا من رسوله، الذي نعتَه ربُّه بالرحمة واللين وعدم الغِلظة، وأمره بالعفو عنهم والاستغفار لهم، ومشاورتهم جمعيًا في الأمر، فالشورى ليست هي المسؤولة عن الهزيمة، وإنما المسؤول هم الرُّماة الذين عفا الله عنهم، وأمر رسوله بالعفو عنهم، فحتى في هذه المحنة الأليمة التي كابَدها رسول الله، وحتى في مستوى هذه المعاملة البالغة السوء من المشركين – تَقف القِيم الإنسانية والأخلاقية النبوية ثانية مؤكدة – في الحرب والسلم معًا – الصدق البالغ في قوله تعالى في وصْفه نبيَّه محمدًا – عليه السلام -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾.
♦♦♦
وبعد (أُحد) شهِدت السنة الرابعة للهجرة عددًا من السرايا، تعرَّض المسلمون في بعضها لعدد من النَّكبات، ومن أهمها (سرية الرجيع)، التي كانت مؤامرة من المشركين ادَّعوا فيها رغبتهم في الإسلام، واصطَحبوا معهم عشرة من القراء، قتَلوا منهم ثمانية، وباعوا اثنين لأهل مكة، فصَلبوهما، وتأتي (سرية بئر معونة) كارثة أعظمَ وأكبر، وكانت شبه مؤامرة على النحو السابق، وانتهت باستشهاد سبعين رجلاً من الصحابة القرَّاء.
كما شهِدت هذه السنة أيضًا إجلاء بني النضير اليهود من المدينة، بعد أن حاوَلوا قتْل الرسول مرتين.
وفي السنة الرابعة للهجرة أيضًا، خرَج الرسول لملاقاة أبي سفيان الذي كان قد توعَّد المسلمين باللقاء بعد أُحد في العام القادم في بدر، وقد أقام الرسول في بدر ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان، لكنه لم يأتِ، فعُدَّ هذا نصرًا للمسلمين، وبدؤوا يستردون هَيبتهم بعد أُحد وآثارها.
• وفي هذه السنة أيضًا قرَّرت قبيلتا بني ثعلبة وبني محارب من غَطفان – الهجوم على المدينة، وعندما وصَلت الأخبار إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – خرَج مع أربعمائة من المسلمين، حتى وصل موضعًا يقال له ذات الرِّقاع، غير أن هاتين القبيلتين عندما علِمتا بقدوم المسلمين، خنَستا واختبأَتا في جحورهما؛ لذا فلم يقع أيُّ قتال، ولكن النتيجة كانت نصرًا في قائمة المسلمين أمام العرب وقريش[3].
♦♦♦
وفي السنة الخامسة للهجرة (شعبان)، خرَج النبي بجيشه إلى المُريسيع (على تسعة فراسخ من المدينة)؛ ليواجه بني المصطلق وسيِّدهم الحارث بن ضرار، بعد أن تأكَّد أنهم يَجمعون لحربه، فهزَمهم، وهربوا، وعاد المسلمون بأسرى كثيرين ومغانمَ كثيرة، لكن الدرس الإنساني والأخلاقي المستفاد من هذه الغزوة، تمثَّل في موقف الرسول من عبدالله بن أُبي بن سلول، الذي حاول استغلال خلاف بين حليف لأحد الأنصار وأجير لأحد المهاجرين، حول أيهما أحق بسقي بعيره من بئر هناك، فأسفر عبدالله بن أُبي بن سلول عن نفاقه عند العودة من هذه الغزوة، عندما قال بمناسبة هذه الوقعة: أما والله لئن رجَعنا إلى المدينة، ليُخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ، وكان يشير إلى نفسه بأنه هو الأعز، وإلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – حاشاه بأنه الأذل، وعندما بلغ هذا النبأ ابنه – وهو الصحابي الكبير عبدالله بن عبدالله بن أُبي – جاء إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقال له: “يا رسول الله، إنه بلَغني أنك تريد قتل أبي (عبدالله بن أُبي) فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلاً، فمر لي به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمَت الخزرج ما كان بها من رجلٍ أبرَّ بوالده مني، وإني أخشى أن تأمُر به غيري، فيَقتله، فلا تدَعَني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس، فأقْتله، فأقتل مؤمنًا بكافر، فأدخل النار، فقال له الرسول – صلى الله عليه وسلم -: ((بل نترفُق به، ونُحسن صُحبته ما بقِي معنا))، ثم إن عبدالله – رضي الله عنه – وقف لأبيه عبدالله بن أُبي بن سلول عند مضيق المدينة قائلاً: والله لا تدخلها؛ حتى يأذَن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك، فلما جاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استأذَنه في ذلك، فأذِن له، فأرسله حتى دخل المدينة[4].
وهكذا كانت إنسانية الرسول وأخلاقيته العالية في مواجهة الأعداء – إكرامًا لذَويهم المخلصين.
♦♦♦
وقد قدَّمت موقعة الخندق التي وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة – كثيرًا من المواقف الإنسانية الرائعة، فقد انتصرت فيها الشورى، وانتصر في الشورى رأي العبد السابق (سلمان الفارسي)، الذي اقترح إنشاء (الخندق) في مواجهة أحزاب – يصل عددهم إلى عشرة آلاف مقاتل سوف يهاجمون المدينة – استفادت من الأساليب الحربية للفرس الذين كان ينتمي إليهم.
• وإنه لموقف إنساني رائع – كذلك – أن يَشترك ثلاثة آلاف مسلم في حفر الخندق، يقودهم الرسول بنفسه، يتحمَّل حصة من العمل مثلما يتحملون، ويتحمَّل معهم الجوع أكثر مما يتحملون، ويقودهم إلى الأمل والتفاؤل في ظلِّ هذه الظلمة المُحيطة بهم، والتي زُلزِل فيها بعض المؤمنين زلزالاً كبيرًا، وظهَر أمر بعض المنافقين.
وقد كانت حصة كل رجل القيام بحفْر طول ذراعٍ من الخندق في عُمق لا يستطيع الذي يسقط فيه أن يَخرج منه مع فرسه، وقام بتوزيع العاملين عشرةً، عشرة، وقام بينهم التنافس الكريم في الجدِّ والتحمل، وكان الرسول وهو يعمل معهم ويدفعهم إلى التنافس، يُسري عنهم – بإنسانيَّته المشرقة الوضَّاءة – وينشد وهم ينشدون معه:
|
اللهمَّ لا عيش إلا عيشُ الآخرة فاغفِر اللهمَّ للأنصار والمهاجرَه |
وأيضًا كان الصحابة ينشدون:
|
نحن الذين بايَعوا محمدًا على الجهاد ما بقِينا أبدَا |
وكانوا مع الرسول ينشدون أيضًا:
|
اللهم لولا أنت ما اهتَدينا ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا فأنْزِلنْ سكينةً علينا وثبِّت الأقدام إن لاقَينا إنَّ الأُولي قد بَغوا علينا وإن أرادُوا فِتنة أبَينا |
وكان – عليه السلام – يَرفع صوته: ((أبَينا، أبَينا))[5].
ولنا أن نتخيَّل وأن نُحاول أن نرسُم في ذهننا – من وراء حُجب التاريخ – هذه اللقطة الرائعة التي يجتمع فيها ثلاثة آلاف مسلم على الحب والولاء لدينهم وقائدهم، وهم يعملون بشيء من التنافس على الثواب العظيم، ولا ننسى منظر القائد النبي الأعظم الذي يعمل بينهم ويَكسِر الأحجار كما يكسرون، ويَحملها كما يحملون، ويشترك في الأكل إن وجدوا طعامًا، وفي الجوع إن لم يَجدوا، وينشد معهم الأناشيد المؤكدة لشكر الله الذي هداهم للإيمان، والثقة – بالتالي – في عبور الامتحان.
وبثقة كبيرة لا يُمكن أن تتأتَّى – وسط هذا الامتحان – إلا من نبيٍّ معصومٍ مُلهَمٍ، يضرب أمامهم حجرًا قويًّا، لم يستطيعوا كسْره، قائلاً: ((بسم الله))، فيَلمَع بريقٌ تحت الضربة، فيقول: ((الله أكبر؛ أعطيتُ مفاتيح الشام، والله إني لأُبصر قصورها الحمر – إن شاء الله))، ثم يَضرب ضربة ثانية، فيَلمَع بريق من ضربته، فيقول: ((الله أكبر أعطيتُ مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض))، ثم يضرب الثالثة، فيبرق أيضًا بريق تحت الضربة، فيقول: ((الله أكبر، أُعطيتُ مفاتيح اليمن، والله إني لأُبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة))[6].
إنها لقطة من أعظم لقطات التاريخ الإنساني، حين يعمل ويأكل ويجوع جنبًا إلى جنبٍ أعظمُ رجل ونبي عرَفته الإنسانية، يعمل مع العبيد، ومع الأحرار، أبيضهم وأسودهم، غنيِّهم وفقيرهم، والأكثر من ذلك أنه ينشد معهم أناشيد الإيمان، ويفتح لهم آفاق الأصل في ظل هذا الحصار الشديد – عليه الصلاة والسلام.
يقول علامة العصر الداعية التركي الشيخ: فتح الله كولن:
“لقد احتفَظ الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالقيادة في يده على الدوام، ولم يترك جبهة القتال طوال أيام الحصار ساعة واحدة، تصرَّف كأي فردٍ منهم، وشارك جيشه في جميع مشاكله وساعات ضيقه، وهذا يؤكد كيف أن قيادته كانت في الذِّروة على الدوام[7].
وفي ختام هذا الحصار قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – لأصحابه: ((الآن نغزوهم ولا يَغزوننا))[8]، وقد صدقت الأيام قولَه هذا، كما صدقت كل أقواله – عليه السلام.
♦♦♦
وفي السنة السادسة للهجرة – وبعد الانتهاء من الخندق وبني قريظة – قام الخزرج – بمفرزة منهم قوامها خمسة رجال – بقتْل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، الذي كان من أكابر مجرمي اليهود الذين وقفوا مع الأحزاب، وأعانوهم ضد المسلمين، ومع إجرام هذا الرجل فقد نهى الرسول (المفرزة) عن قتْل النساء والصِّبيان؛ ولذلك قتَلوه في بيته، ولم يَمَسُّوا أحدًا سواه، بأمر الرسول الكريم – عليه الصلاة والسلام.
[1] أقرب الآراء إلى القبول أن السَّرية هي التي لم يَخرج فيها الرسول، والغزوة هي التي قادها الرسول – عليه السلام.
[2] رواه أحمد في المسند، والحاكم في المُستدرك.
[3] محمد فتح الله كولن؛ الرسول قائدًا (التنظير والتطبيق)، ص 116.
[4] محمد فتح الله كولن؛ الرسول قائدًا (التنظير والتطبيق)، ص 117- 118.
[5] البخاري، باب: مناقب الأنصار، مسلم، باب: الجهاد.
[6] السيرة النبوية؛ لابن هشام 3/230، وتاريخ الأمم والملوك؛ للطبري 3/ 167- 168، والكامل في التاريخ؛ لابن الأثير 2/ 179.
[7] فتح الله كولن؛ الرسول قائدًا (التنظير والتطبيق)، ص 134.
[8] البخاري، المغازي 29، والمسند للإمام أحمد 4 /262.
المصدر : الألوكة







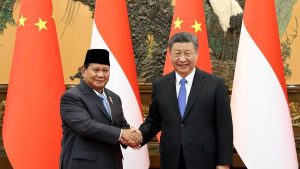











 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic