الإثنين 21 ذو الحجة 1436//5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
الشيخ محمد حامد الفقي
تفسير قوله تعالى
﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾
بسم الله الرحمن الرحيم
قول الله تعالى ذكره: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 51 – 54].
بعد أن ذكَر الله تعالى بني إسرائيل بنعمةِ إنجائهم من فرعون بما صنع لموسى من معجزة فلقِ البحر إلى فرقَيْنِ، كل فِرْق كالطَّود العظيم، جعل لهم بينهما طريقًا يبسًا لا يخافون فيه غرقًا، ولا يخشون من فرعون وجيشه دركًا، وما صاحَبَ هذه النعمة العظيمة من نعمة إغراق عدوِّهم، وشفاء غيظ قلوبهم بإهلاكه؛ انتقامًا منه لبَغيه، وظلمه، وجبروته، وكفرِه، وجعله عبرة ومثلاً لمن يخشى، ذكَّرهم بعد ذلك بما قابلوا به هذه النعمة الجليلة من الضلال البعيد، والنكران القبيح، والكفران الذي سفَّهوا به أنفسهم أشدَّ السَّفه وأبعده في الدلالة على أنهم أحق الناس بمقت الله وغضبه؛ ذلك أنهم لما جاوز الله بهم البحر تركهم موسى يمشون على هونهم؛ رفقًا بهم، وشفقةً عليهم؛ لِمَا معهم من أثقال نسائهم وأطفالهم ودواجنهم، وأمتعة بيوتهم التي تحمَّلوها من منازلهم بمصر، وحرصوا على حملها؛ لشدة تعلُّقِهم بالدنيا وعَرَضها، مهما كان قليلاً حقيرًا، ومهما عوق عن بلوغ الغايات العلا، ومنازل العزة القصوى.
وتعجَّل موسى لميقات ربِّه الذي كان واعده إياه عقب مجاوزة البحر؛ ليكلِّمه، ويوحي إليه بالشرائع والوصايا، التي تناسب بني إسرائيل، وتُصلِحُهم في حياتهم الجديدة التي انتقلوا إليها.
وكان يحفز موسى عليه السلام أيضًا إلى التعجل للقاء ربِّه شوقُ الحبيب، وحرصُه العظيم على المبادرة إلى شكر ما أولاه وليُّه الأجلُّ الأعلى سبحانه من نعمة إنجائه وبني إسرائيل من فرعون وقومِه بهذه المعجزة، فاستخلَف أخاه هارون في قومه، وأوصاه بهم أن يصلح في معاملتهم، وألا يتَّبع سبيل المفسدين، وما كاد موسى يبعد عنهم حتى قام فيهم السامريُّ يختلهم عن دينهم الحق، ويَحتال أن يكيدَهم ويكيد موسى، ويفسدَ عليه أمرَ بني إسرائيل، فقال لهم: لقد حملتم أوزارًا من زينة المصريين وحُليِّهم التي يصوغونها على صور آلهتهم وفراعينهم، فما أنتم ترون في آذان نسائكم أقراطًا على صورة الجعلان – الجسران- وعلى صورة العجل والثعبان وغيرها، مما اتخذوا من الحيوانات المقدسة، وكذلك القلادات، والأساور كلها قد رُسم عليها صور هذه المقدسات الوثنية، أليس ذلك ينافي ما جاءكم به موسى من الدين الذي يمقتُ هذه الوثنيَّات، ويبغضُها أشدَّ البغض بكل معانيها وما يمت إليها بأي سبب؟!
وهو في الوقت نفسه تعظيم للفراعين وشِيعتِهم وحزبهم، وحفظٌ لآثارهم، وإبقاء لذكراهم تحملونها معكم حيث كنتم، وقد رأيتم الله قد أبادهم، فالأولى بآثارهم كذلك أن تفنَى وتبيد ويُقضَى عليها كما قضي عليهم!
قراءة المزيد: آفاق البحث في علم التفسير
وهذا قول ظاهر حسنٌ جميل، ولكنه غاب عنهم أن يردُّوا عليه بأن موسى رأى ما رأيتَ، ولم يقل لنا ما قلت، وأن هارون هو خليفة موسى فينا، فلا قولَ لك ولا سمعَ ولا طاعة، فلو كنت محلَّ ثقة في الدين، وموضعَ نصحٍ، لأوصى بك موسى.
لكن بني إسرائيل لم يتفطَّنوا لشيء من ذلك، بل ولم يستشيروا هارونَ فيما قال لهم السامريُّ، وبادروا إلى طاعة السامريِّ، وألقوا إليه بكل ما يحملون من حُليٍّ وذهب، وقد كان السامري صواغًا ماهرًا، ومثالاً فنانًا، ومهندسًا بارعًا، فصاغ من هذا الحُلي عجلاً جسدًا، وزخرَفَه بالنقوش الفاتنة، والرسوم المدهشة، بما كان في الحُليِّ من الأحجار والجواهر المختلفة الألوان، واحتال عليه بحيلةٍ جعلته إذا دخل الريحُ من دُبره خرج من فيه على صوت العجل، على مثال ما ترى اليوم من أبواب السيارات التي يُسمَعُ لها أصوات مختلفة على حسب ما أراد صانعُها، بما وضع فيها من آلات الزمر، فلما أتقن صنعَه كذلك خرج به إلى بني إسرائيل فدُهِشوا له أشدَّ الدهش، وعجبوا لصوته أشدَّ العجب؛ فانتهز فرصة دهشهم، وأخذهم وهم في نشوة استغرابهم، وقال لهم: هذا إلهكُم وإله موسى.
ثم نفخ في شيطان الغرورِ والبغي والحسد لموسى على نعمة ربه، والعمل على تقويض رياسة موسى لبني إسرائيل؛ بالقضاء على رسالته، وامتلاك قلوب أولئك الحَمْقَى الذي لا يعقلون؛ إذ لا يبدو لهذا التمثال الذهبي للعجل أيُّ ميزة على بقيَّة الجمادات والأحجار، فإنه لا يكلِّمُهم ولا يهديهم سبيلاً، اللهم إلا ما في بريق الذهب الذي خطف قلوبهم وأبصارهم، ولَمَعان الجواهر الذي استعبد نفوسهم واستذل أرواحهم به، وأثر ذلك ظاهر إلى اليوم وبعد اليوم في هذا الشعب البغيضِ الممقوتِ من كل العالم: عباد الأصفر الرنان، الذي لا إله لهم غيرُه، ولا معبود لهم سواه، وفي حبِّه وطاعته يبذلون كلَّ شيء.
ووحَّد السامري فِريته، وموَّه ضلالته بإيهام بني إسرائيل أن هذا العجلَ كان مع موسى يعبدُه وأنه نَسِيَه، وذهب إلى الطور ولم يأخذه معه؛ لأن الظاهر أن السامري عكف الليل والنهار على صياغة العجل حتى أخرجه في مدة لا يتصورونها؛ فصدَّقه بعض بني إسرائيل، وأطاعوه في عبادة العجل الذهبي، وقاموا يعكفون حولَه، ويدورون عليه بحركات يرسمها لهم، وأصوات ونغمات وألفاظ يرددها عليهم.
قراءة المزيد: مسارات الفاعلية في القرآن الكريم
وقد تحلقوا حول العجل حلقة يتمايلون فيها ذات اليمين وذات الشمال، وطورًا إلى الخلف والإمام. والسامري وسط الحلقة يدير هذه الحركات، ويضبط تلك الاهتزازات والرقصات مرة بما ينغم من الأنغام، وأخرى بما يصفق على كفيه، وطورًا بما ينشدهم من القول المثير للحركات.
وقد أخذته نشوة الغرور، وكبرياء ما زعمه له شيطانه من الرياسة الحمقاء على أولئك الذين هم أشبه بالقردة المقلِّدة لمروِّضها، أو الحمير الناهقة بأنكر الأصوات.
فلما رأى هارون ذلك وسمعه أخذه الهم والحزن من كل ناحية! وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وقال لهم: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ [طـه: 90]، فحرك لهم السامريُّ ذيل العجل وأذنيه، وأخرج من فِيه صوتًا كالخوار، وقال: ﴿ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى ﴾ [طـه: 88]، فقالوا لهارون: لن نسمعَ لقولك، ولا نترك هذا الإله الجميل الذي أخذ عقولنا وأبصارنا، و﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [طـه: 91]، فلما جاء موسى إلى طور سيناء لميقات ربه قال الله تعالى له: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى * قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ [طه: 83-85]، فإنهم حديثو عهد بوثنية، وقريبو عهد بجاهلية، وتلك المدة القليلة التي أقمتُها فيهم لا تكفي لإخراجهم مما كانوا فيه من ظلمات تلك الجاهلية الوثنية، وليس مكان هارون منهم بمثل مكانك من نفوذ الكلمة وقوة السلطان؛ لما لك عليهم من الأفضال قديمًا وحديثًا، وإنهم لذلك سريعو الانقلاب والتأثر بأقل فتنة، وهارون لا يَقْوَى على ردعهم وتقويم معوجِّهم، وها هم قد فتنوا ﴿ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ [طه: 85] بكيده وحسده، ولقد كان الأولى بك يا موسى ألا تترك قومك لغيرك الآن، وأن تصحبهم في سيرهم حتى يبعد عهدهم بالوثنية، وتقوى فيهم روح الدين بكثرة ما يسمعون من العلم، وما يرون من آيات الله؛ فارجع إليهم، وأسرع بإنقاذهم قبل أن تعظم الفتنة بالسامري وعجلِه، ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴾ [طـه: 86]، فأخذوا يعتذرون عن فعلتهم الشنيعة؛ ويبررون موقفهم الأثيم ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴾ [طـه: 87-88].
وقال الذي يخاطب موسى ويجيبُه عن عماية أولئك المفتونين الحَمْقَى، مقيمًا الدليل على غبائهم وضلالهم، إن هذا لعجيبٌ؛ بعد أن عرَّفتهم بالله سبحانه، وأنه كلمك، وأنه ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طـه: 50]، وأنه الذي يملك الضرَّ والنفع وحده لا شريك له – قال يخاطب موسى ويقرعهم ويوبخهم على شنيع فعلهم: ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ [طـه: 89]، ويقيم الحجة لهارون عليهم، وأنه لم يسكت على منكرهم، بل دعاهم إلى الكفر بالعجل وعبادة الله وحده ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ [طـه: 90]، فعصوه وأبَوْا إلا طاعة السامري الخبيث، و﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [طـه: 91]، فالتفت موسى إلى أخيه هارون في غيظ وحنق – وكان موسى شديدًا، سريعَ الغضب – ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ [الأعراف: 150]، وقال له: لماذا لم تأخذهم بمثل هذه الشدة التي آخذك بها، وتقهرهم على الحق بالقوة، وتردعهم عن هذا الشرك بالعصا والسيف، وتريهم في السامري الخبيث قوةَ بطشك به، وتقيم لهم الحجة العملية بتحريق هذا العجل أمامهم؛ ليعرفوا قدر ما صنع لهم السامري من إله حقير مهين، كما سأفعل أنا به؟! (قال) هارون لأخيه يَستعطِفُه، ويرقق قلبه، ويستدفع غضبه: ﴿ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾ [الأعراف: 150]؛ لشدة جهلهم، وتمكن الخبيث السامري من عقولهم السخيفة، ولما أغراهم به؛ ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: 150]، فقال له موسى: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴾ [طه: 92]، الضلال المبين الذين بلغ بهم أنهم كادوا يقتلونك ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ﴾ [طه: 93]، وتلحق بي بمن بقي من بني إسرائيل على الحق، وتترك هؤلاء الضُلاَّل الذين انفصلوا عنا، وفارقوا ديننا مع السامري الخبيث ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه: 93]؟ في السير واللحاق بي، فتقعد بهم في هذا المكان وتتخلف، (قال) هارون: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ [طه: 94]، فلما سمع موسى من أخيه معذرته، وتبين له أنه لا لوم عليه، وأن مكثه إنما كان لما يحرص عليه من جمع كلمة بني إسرائيل، والخوف من تفرقهم، مع علمه أن موسى سيرجع إليهم من عند ربه الذي علم ما كان منهم، وأنه لا بد مخبرٌ نبيه موسى بما صنع السامري، وما كان من بني إسرائيل؛ فإذا ترك هؤلاء أكلهم الشيطان بدون أمل في توبتهم، ولا رجاء في عودتهم؛ ويظفر الخبيث السامري بهم فينال بذلك أمنيته، ويبلغ بهم غايته، (قال) موسى: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأعراف: 151].
قراءة المزيد: آداب قراءة القرآن
وبذلك فرغ من شأن هارون فتركه، ثم التفت إلى السامري و﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾ [طه: 95]، وما شأنك الذي حملك على ما صنعتَ من هذه الفتنة التي كفرتَ بها بالله، وأوقعت هؤلاء في الكفر وعبادة العجل؟ ﴿قَالَ بَصُرْتُ ﴾ [طه: 96]؛ من فن الصياغة والهندسة، وإتقان الصنعة والحيلة في صنع هذا العجل ﴿ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ [طه: 96]، وبَصُرتُ أيضًا في شأنك ورياستك على بني إسرائيل، وتزعمك عليهم، وحلولك منهم هذا المحل الذي أوقد نارَ الحسد والحنق عليك في قلبي بما لم يبصروا به؛ إذ أعطوك طاعتهم مخلصين، وأظهرتُ طاعتَك مخادعًا لك ولهم، منتهزًا الفرصة للتمرد عليك، وإعلان عصيانك.
وكنت لسَبْك هذه الخدعة، ولتمامِ هذه الحيلة الشيطانية قد أخذت قدرًا قليلاً من علمك ورسالتك قدرَ ما يأخذ الإنسان بكفه وقبضة يده من الشيء التافه الذي لا خطر له عنده؛ حتى أسترَ به ما في نفسي؛ ولأتخذ منه سلاحًا أحاربُك به عند الحاجة، فإذا قضيتُ منه حاجتي نبذته نبذ النواة، وطرحته طرح الشيء المهين الذي لا قيمة له؛؛ وهذا هو معنى قوله: ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾ [طه: 96]؛ أي: موسى بصفته رسولاً، لا بصفته من بني إسرائيل، وليس الرسول هو جبريل، ولا فرس جبريل – كما يُحكى – فليس له ذكر في القصة في أي سورة، ولا جاء الخبر بذلك عن الصادق صلى الله عليه وسلم فنتبعُه، وإنما هو من بنات أفكار الإسرائيليِّين.
ويدل لذلك قولُه: ﴿ فَنَبَذْتُهَا ﴾ [طه: 96]، ولم يقل: فألقيتها، ولا وضعتها، ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي * قَالَ ﴾ [طه: 96، 97] له موسى ﴿ فَاذْهَبْ ﴾ [طه: 97] لا تكن معي، وانفصل عنا؛ فإن الله سيعاقبُك بما تستحق ﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ ﴾ [طه: 97] بما سيعاقبك الله به من الأمراض ﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ ﴾ [طه: 97] لشدة ما في جسمك وجلدك من الآلام التي لا تتحمَّل معها مسُّ البعوضة، فضلاً عن يد الإنسان، ﴿ وَإِنَّ لَكَ ﴾ [طه: 97] بعد هذا ﴿مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ [طه: 97]، ثم التفت إلى بني إسرائيل، وقال لهم: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: 98].
﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 53]
ثم ذكَّرهم الله بنعمة هي أجلُّ نعمة، وأفضلها، وأبينها، وأحقُّها بالذكر والشكر، وأبعدها عن النسيان والنكران؛ وهي نعمة العلم والهداية بالتوراة، التي وضح جليًّا جدًّا بحادثة العجل أنهم أعطوها من نفوسهم أشد الكفران، وأقبح النسيان؛ فإن الذي يعبد العجل أبلدَ الحيوان، وأذلَّه وأقله دفعًا عن نفسه؛ بحيث يضرب به المثل في البلادة والذلة، وهو مع هذا ليس حيوانًا، بل صورة من المعدن صاغه صانعه بعد أن أذابه بالنار، ودقه بالمطرقة، وبرده بالمبرد، وكل هذا مع ما عاينوا وشاهدوا بالأمس القريب جدًّا من نقمة الله بعبَدَة العجل، ونكاله بهم أشد النكال وأخذهم الأخذة الرابية – مع هذا كله كان بنو إسرائيل أشدَّ الناس كفرًا بنعمة العلم وهداية التوراة وفرقانها بين الهدى والضلال والكفر والإيمان والخبيث والطيب، وعزة الآخذين بها المستمسكين بحبلها، المقيمين لحدودها، العالين بشرائعها ظاهرًا وباطنًا وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وذلة المعرضين عنها المنحلين عن حبلها وعروتها المنتهكين لحرماتها، المضيعين لحقوقها، المميتين لشرائعها، المتعدين لحدودها وخسرانهم في الدنيا والآخرة، فقول الله تعالى: ﴿ وَالْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة: 53] عطف بيان على الكتابِ، الذي هو التوراة؛ أي: التوراة التي هي الفرقان، و”الفرقان” صيغة مبالغة من “الفرق” فالمراد منه أوضح الفرق وأشده بيانًا وجلاء وتمييزًا؛ بحيث لا ينبغي أن يخفى على أحد ولا يبقى لأحد معه عذر ولا حجة، وقد سمى الله التوراة في هذه الآية فرقانًا، وفي سورة الأنبياء: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأنبياء: 48]، وفي سورة آل عمران سمَّاها وغيرها من كل الكتب المنزلة فرقانًا: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَان ﴾ [آل عمران: 3، 4]، وسمَّى القرآن فرقانًا في سورة البقرة ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: 185]، وفي سورة الفرقان: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1]، وقال في ليلة القدر: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: 3، 4]؛ أي: يُميِّز الله بما أنزله من القرآن فيها بين كل أمر حكيم من العلم والإيمان، وأمر سفيه من الجهل والشرك وتقاليد الآباء.
قراءة المزيد: الدعوة إلى العمل الصالح
وسمَّى الله يوم أُحد يوم الفرقان في سورة الأنفال: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنفال: 41]، فإن النصر الذي أنزله الله في هذا اليوم على الطائفة القليلة التي لم تكن قد اتخذت للحرب عُدَّتها ولا تهيَّأت لها أسبابها وهي تقاتل في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله باعت نفسها لله؛ على الطائفة الكثيرة العدد والعُدة وهي كافرة تقاتل في سبيل الشيطان؛ فرَّق هذا النصر بين أهل الحق والباطل، ووضع في قلوب أهل الجزيرة أسسَ الإيمان وهيأها لما أتى بعده من الفتح المبين، ودخولهم في دين الله أفواجًا.
وسمى الله ما يقذفه في قلب عبده المؤمن من نور الهداية والمعرفة فرقانًا، فقال في سورة الأنفال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: 29].
فاللهُ تعالى يُذكِّرهم بنعمة العلم التي أنزلها على موسى في التوراة، وفرَّق لهم بها بين الإله الحق الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، وبين الآلهة الباطلة الحقيرة التي لا تستحق إلا التحريق والنذرية في اليم نسفًا ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 53]؛ رجاء أن تهتدوا الصراط المستقيم، وتسلكوا وراء موسى السبيل القويم، ولكنكم تنكَّبتم الصراط السوي، واتبعتم السامري على ضلاله المبين وكفره الشنيع.
ولما انتهى أمر إله السامري اللعين إلى هذه النهاية التي لا تليق إلا لهما ولا يلقيان إلا لها ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾ [البقرة: 54]، وحملتموها من عقوبة هذا الشرك بعبادة العجل، والكفر بالله وأنبيائه بطاعة صانع العجل أمرًا عظيمًا شاقًّا أشد المشقة ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]؛ إذ أحييتم أنفسكم الشيطانية الأمارة بالسوء، وغذيتموها أشدَّ الغذاء وأقواه بعباده العجل؛ ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ﴾ [البقرة: 54] ومصوركم وخالقكم وحده؛ فإنه القوي العزيز الشديد العقاب، ومن شروط التوبة: إحياء النفس اللوامة، وتغذيتها بالعمل الصالح في طاعة الله وعبادته وحده لا شريك له؛ لتتولد النفس المطمئنة التي يقال لها: ﴿ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: 28 – 30]، ولا تحيا النفس اللوامة وتتغذَّى إلا بالندم والتحسُّر على ما جره الغرورُ والطيش وجهل النفس الأمارة ونزواتُها طاعةً للهوى والشيطان، والرضا عن هذه النفس والتعامي عن عيوبها ونقائصها، فإذا ما قُتِلت كلُّ هذه المعاني والصفات، وحل مكانها الذلة والخوف من عذاب الله، وخشية غضبه، والترامي على أبواب رحمته، والانطراح على أعتاب عفوه ومغفرته، والتعلق التام بحبل هدايته وتوفيقه، والتجرد من الحول والقوة إلى حول الله وقوته، إذا تم كل هذا – ماتت النفس الأمارة وحَيَتِ النفس اللوامة، وأخذت سبيلها إلى بارئها على صراطه المستقيم ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 54].
قراءة المزيد: قصة موسى مع الخضر
هذا وقد رُوِي في هذه القصة وكيفية قتل بعضهم لبعض بالسيوف والخناجر رواياتٌ عن ابن عباس، ذكرها ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [طه: 40] في سورة طه، وساقها قصة طويلة في أربع ورقات؛ ثم قال: وهو موقوفٌ من كلام ابن عباس، وليس مرفوع إلا القليل منه؛ وكأنه تلقاه مما أبيع نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، وكذلك نقله غير ابن كثير ولا حدةَ فيه، والله أعلم.
واقرأ قصة عبادة بني إسرائيل للعجل في سورة الأعراف الآيات [142-154]، وفي سورة طه [83-98]، وأشار إليها في سورة البقرة [92؛ 93]، وسورة النساء [153].
ويُشبهُ هذا العجل من بعض الوجوه ما يتَّخذه الناس من عجل السيد البدوي، وعجل العزب وأمثالهما مما يسيبونه للأولياء والصالحين، وينذرونه للموتَى؛ فيتبركون به، ويتمسَّحون، ويتركونه يدخل بيوتهم وغيطانهم يأكل منها ما يشاء، معتقدين حلولَ البركة في بيوتهم وغيطانهم بدخوله، وانتسابه إلى من سموه باسمه، نسال الله العافية لنا ولهم من كل ما يغضبُه؛ ونرجوه سبحانه أن يتوب علينا وعليهم من كل معصية، وأن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا في ديننا ودنيانا، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين.
المصدر: مجلة الهدي النبوي
المجلد الرابع – العدد 45 – أول جمادى الأول سنة 1359هـ
قراءة المزيد: تأثير الاستماع لصوت القرآن على القلب









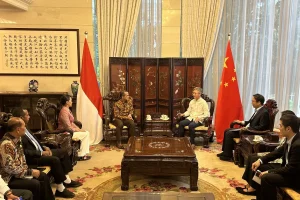
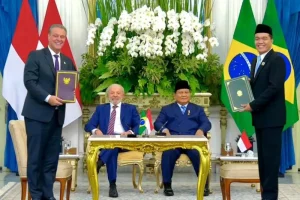










 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic