من مجالات الدراسات الاستشراقية .. الحديث الشريف والسنة
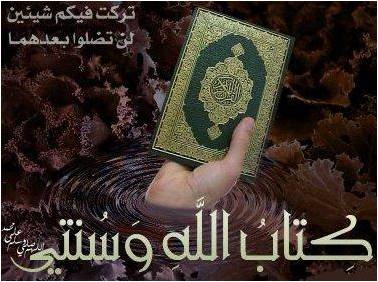
السبت 23رجب 1437/ 30 أبريل/نيسان 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
د. أنور محمود زناتي
من مجالات الدراسات الاستشراقية.. الحديث الشريف والسنة
وكان للحديث مكانٌ بارز في دراسات المستشرقين باعتباره المصدر الثاني للتشريع لدى المسلمين بعد القرآن، وفيها توضيحه وبيانه؛ فبحثوا في تدوين الحديث وسنده، ومصطلح علم الحديث، وبرز من المستشرقين في هذا المجال المستشرق المجري اليهودي “جولد تسيهر”؛ كما وضع المستشرق “فنسنك” بالإنجليزية كتابه المشهور: “مفتاح كنوز السنة” (نقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباقي)؛ وذلك للكشف عن الأحاديث النبوية المدونة في كتب أربعة عشر إمامًا في السنَّة، منهم: “البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه”؛ كما أعقبه فريق من المستشرقين بوضع “المعجم المفهرس لألفاظ الحديثالنبوي”، جمعوا فيه كافة الأحاديث النبوية التي وردت في مختلف كتب السنة المعتمدة، ورتَّبوها حسب الحروف الأبجدية، مما يسهل الرجوع إلى أي حديثٍ في مصادره متى عُرِف ألفاظه، ومع وضوح بداية استعمال السند، وشيوع التزامه، والتمسك به في هذا الوقت المبكر من تاريخ الحديث؛ فإن بعضَ المستشرقين حاولوا أن يُثِيروا الشكوك حول الإسناد وبداياته، وأهميته في الرواية؛ وذلك لإضعاف الثقة به، ومن ثَمَّ إضعاف الثقة بالحديث النبوي؛ لأن التشكيك في الإسناد أو التقليل من أهميته، هو في الحقيقة تشكيك في السنة النبوية، التي وصلت إلينا، وتناقلتها الأمة جيلاً إثر جيل، بواسطة هذه الأسانيد.
فمن المستشرقين مَن شكَّك في بدايات الإسناد، وأشار “شبرنجر” (ت 1893 م) إلى ضعف نظام الإسناد، وأن اعتبار الحديث شيئًا كاملاً – سندًا ومتنًا – قد سبَّب ضررًا كثيرًا وفوضى عظيمة.
وأما “موير” – معاصر “شبرنجر” – فينتقد طريقةَ اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث؛ لاحتمال الدس في سلسلة الرواة.
وأما “شاخت”، فقد أجرى دراسةً على الأحاديث الفقهية وتطورها – على حد زعمه – أجراها على كتابي “الموطأ” لمالك و”الأم” للشافعي، وعمَّم نتائج دراسته على كتب الحديث الأخرى، ثم خلص إلى أن السند جزءٌ اعتباطي في الأحاديث، وأن الأسانيد بدأت بشكل بدائي، حتى وصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وأنها كانت كثيرًا لا تجد أقل اعتناء؛ ولذا فإن أي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات فيضعها في الإسناد”.
ومن الأسباب التي جعلت المستشرقين يتوصَّلون إلى هذه النتائج في حكمهم على الأحاديث النبوية، أنهم لم يُجْروا دراستَهم على كتب الحديث المعتمدة التي عُنِيت بذكر الأسانيد وعوَّلت عليها، بل اختاروا الكتب التي تكون دراستها للحديث غير مقصودة لذاتها – ككتب السيرة والفقه مثلاً – فـ: “شاخت” عندما أصدر حكمه هذا على الأسانيد أصدره بناءً على دراسة قام بها لكتاب الموطأ للإمام مالك، والموطأ للإمام محمد الشيباني، وكتاب الأم للشافعي، ومن المعلوم أن هذه الكتب أقربُ ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث، وعلى الرغم من ذلك، فقد عمم نتيجته التي توصل إليها في دراسته لتلك الكتب، وفرضها على كافة كتب الحديث، وكأنه ليس هناك كتب خاصة بالحديث النبوي، وكأنه ليس هناك فرْق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث؛ فقد يحذف الفقهاء جزءًا من الإسناد اكتفاءً بأقل قدر ممكن من المتن الذي يدل على الشاهد والمقصود؛ وذلك تجنبًا للإطالة، وقد يحذفون الإسناد بكامله، وينقلون مباشرة عن المصدر الأعلى، وقد يستعملون الإسناد أحيانًا، ويقطعونه أحيانًا، وبهذا يتبيَّن أن كتب السيرة وكتب الفقه ليستْ مكانًا صحيحًا لدراسة ظاهرة الأسانيد ونشأتها وتطورها، وأن أي دراسة أو نتيجة يتوصل إليها الباحث فيما يتعلق بالأحاديث النبوية أو الأسانيد في غير مصدرها الأصلي – محكومٌ عليها بالفشل والإخفاق، وعلى هذا الأساس، فإن ما قام به المستشرقون من دراسة، وما توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال كانتْ نتائج خاطئة، هذا إذا افترضنا حسن النية، والنزاهة في البحث العلمي، فكيف إذا انضمَّ إلى ذلك سوءُ القصد، والعداء للإسلام وأهله، وتشويه مصادره، وهدم أصوله وأركانه، والمعلوم لدى كل منصفٍ أنه لم يلقَ علْمٌ من العلوم الإسلامية في جميع جوانبه وفروعه ما لَقِيه علمُ الحديث من العناية والاهتمام، بدءًا من عهد الصحابة – رضي الله عنهم – وإلى الان، فما من جزئية من جزئياته إلا وقد فصَّلها العلماء بحثًا ودراسة؛ وذلك تحقيقًا لوعد الله في حفظ الذِّكر، ومن ذلك ما يتعلق بإسناد الحديث، فقد درس المحدِّثون هذه الأسانيد دراسة مستوفاة من حيث الاتصال، ووضعوا القواعد التي تتناول كافة أحوال الاتصال، وسائر وجوهه، فنظروا إليه من حيث مبدئه ومنتهاه، ودرسوا صيغه، وبيَّنوا شروطها، ونظروا إلى مسافة السند من حيث الطول والقِصر، وإلى حال الرواة عند الأداء، ونقدوا الأسانيد في الحديث الواحد، وما فيها من زيادة ونقص؛ كما درسوا الإسناد من حيث الانقطاع، وأنواعه، فبحثوا عن مواضعه من أوله أو وسطه أو آخره، كما بحثوه من حيث طبيعته في الظهور والخفاء، وبلغوا في ذلك المنتهى، فاستوفوا بذلك جميع أوجهِ الاحتمالات في اتصال الحديثوانقطاعه، مما جعل حكمَهم على الأحاديث في غاية الدقة والسداد، إضافةً إلى أنهم اشتَرطُوا في الحديث الصحيح شروطًا تضمن أن ينقلَه الثقةُ عن الثقة حتى يبلغ به النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – مع الاتصال التام، وكل واحد من الرواة يُخبِر باسم الذي أخبره، ونسبه، وحاله، لا تفوتهم في ذلك كلمة أو زيادة لفظة فما فوقها، وهذه الشروط هي الضبط، والعدالة، واتصال السند، وعدم الشذوذ، والعلة، فاختص الإسناد من ذلك بثلاثة شروط، واشترك مع متن الحديث في الشرطين الآخرين، وعُرِف عن أئمة هذا الشأن الإكثارُ من الترحال والتنقل في طلب الأسانيد، للوقوف على أحوال الرواة وسِيرهم عن كثبٍ، وحرصًا منهم على قرب الأسانيد وقلة النقلة والوسائط، ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلُّنا على مدى المشاقِّ والصعوبات التي لقيها هؤلاء الأئمة، واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من منابعها الصحيحة ومصادرها الأصلية، حتى رأينا الصحابي يرحل من المدينة – التي هي بلدُ رسول الله وموطن الحديث – إلى مصرَ في طلب حديث سمعه آخرُ من النبي – صلى الله عليه وسلم، وأخبار العلماء ورحلاتهم في ذلك كثيرةٌ، يَضِيق المقام عن ذكرها، ولا ينقضي العجب منها.
-الألوكة-



