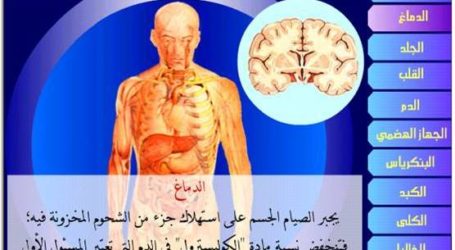مفهوم البيئة
الإثنين-11 ذوالقعدة 1434 الموافق 16 أيلول /سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
مفهوم البيئة
تعريف البيئة لغةً:
الأصل اللغوي لكلمة بيئة هو الجذر (ب و أ)، قال ابن منظور[1] في لسان العرب: بَوَأَ: باء إلى الشيء يَبوء بَوءًا؛ أي رجَع.
وتبوَّأتُ منزلاً؛ أي نَزلتُه، وقوله – تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ﴾ [الحشر: 9]، جعل الإيمان محلاًّ لهم على المثل، وإنه لحسن البيئة؛ أي: هيئة التبوُّء، والبيئة والباءة والمباءة: المنزل، وباءت بِيئَة سوء، على مثال (بِيعة): أي بحال سوء[2].
وقد تمَّ استِعمال كلمة البيئة بمعنى الحال الراهن للمكان المحيط بالإنسان – وهو تقريبًا المعنى المُستعمَل اليوم – لم يكن الخيار الأول والوجه الأكثر استعمالاً عند العرب، وعلى كلٍّ فالمُصطَلح قطع هذه المرحلة وبات مُستعمَلاً بسلاسة ووضوح؛ ذلك أن المقصود بالبيئة عند أكثر المُتحدِّثين بها هو: المكان أو الحيِّز المُحيط بالإنسان[3].
البيئة في الاصطلاح العلمي المعاصر:
تُعرَّف البيئة بأنها: “كل ما يُحيط بالإنسان من أشياء تؤثر على الصحة، فتشمل المدينة بأكملها، مساكنها، شوارعها، أنهارها، آبارها، شواطئها، كما تشمل كل ما يَتناوله الإنسان من طعام وشراب، وما يلبسه من ملابس، بالإضافة إلى العوامل الجوية والكيميائية، وغير ذلك“[4].
ومِن تعريفات البيئة في هذا العلم أيضًا ما قاله البعض: إن للبيئة مفهومين يُكمل بعضهما الآخَر: “أولهما البيئة الحيوية؛ وهي كل ما يختصُّ بحياة الإنسان وبعلاقته بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية التي تَعيش معه.
أما ثانيهما فهي البيئة الطبيعية، وتشمَل موارد المياه، والفضلات، والتخلُّص منها، والحشرات وتربة الأرض، والمساكن، والجو ونَقاوته أو تلوثه، والطقس، وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط“[5].
أما البيئة بمفهومها الواسع فهي تشمل عدة أبعاد؛ تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية، تاريخيَّة، ثقافية.
وكل بُعدٍ من هذه الأبعاد يتفاعل مع الأبعاد الأُخرى، ويلعب دورًا حيويًّا في توازُن هذا الكل، فعندما نقول البيئة، فنحن نقصد جميع العناصر التي تُحيط بالإنسان وتتفاعل معه من خلال قيامه بنشاطاته الحيوية“[6].
ويُمكن إدراج تعريف آخَر مُشابه لما سبَق ذكره؛ فالبيئة – حسب بعض الباحثين -: “عبارة عن نسيج من التفاعلات المختلفة بين الكائنات العُضوية الحيَّة بعضها البعض “إنسان، حيوان، نبات..”، وبينها وبين العناصر الطبيعية غير الحية (الهواء، الشمس، التُّربة…)، ويتمُّ هذا التفاعل وفق نظام دقيق، مُتوازِن ومُتكامِل يُعبَّر عنه بالنظام البيئي“.
وهناك مَن عرف البيئة من الناحية العِلميَّة بأنها: “مجموع العناصر الطبيعية التي تُكيِّف حياة الإنسان“[7].
نظرًا لما سلف ذِكرُه، يُمكن استِخلاص تَعريف عِلمي لمفهوم البيئة بأنها: إجمالي الأشياء المُحيطة بالإنسان والمؤثِّرة على وجود الكائنات الحية على سَطح الأرض، متضمِّنة الهواء والماء والتربة والمعادن والمُناخ والكائنات أنفسهم.
كما يُمكن وصفُها بأنها: مَجموعة من الأنظمة المُتشابِكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد، والتي تؤثِّر وتُحدِّد بقاء الإنسان في هذا العالم، والتي تتعامَل وفق نِظام دقيق مُتوازِن ومُتكامِل يعبَّر عنه بالمنظومة البيئية.
المفهوم القانوني للبيئة:
الباحث عن تعريف محدَّد للبيئة يُدرِك أن الفِكر القانوني يَعتمد بصفة أساسية على ما يُقدِّمه علماء البيولوجيا والطبيعة للبيئة ومُكوِّناتها، وسيظهر هذا جليًّا مِن خلال بعض التعاريف القانونية المختلفة من دولة إلى أخرى، والتي سنُقدِّمها كما يلي:
• القانون المصري رقم 4 لسنة 1994 عرف البيئة بأنها: “المحيط الحيوي الذي يشمَل الكائنات الحيَّة، وما يَحتويه من مواد، وما يُحيط به من هواء وماء، وما يُقيمه الإنسان من مُنشآت“.
• القانون المغربي عرف البيئة بأنها: “مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية، وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تُمكِّن من وجود الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية، وتُساعد على تطورها“.
• القانون الليبي أقرَّ بأن البيئة هي: “المُحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحيَّة، ويَشمل الهواء والماء والتُّربة والغِذاء“.
• أما القانون الكويتي فعرفها بأنها: “المُحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية مِن إنسانٍ وحيوان ونبات، وكل ما يُحيط به من هواء وتربة، وما يَحتويهما من مواد صلبة أو سائلة أو غازية، أو إشعاعات، إضافة إلى المنشآت الثابتة والمتحرِّكة التي يُقيمها الإنسان“[8].
• وأما مؤتمر الأمم المتَّحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم سنة 1972 فقدَّم تعريفًا للبيئة بأنها: “رصيد الموارد المادية والاجتماعية المُتاحة في وقتٍ ما، وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلُّعاته“[9].
وإذا نظرْنا إلى هذه التعريفات السالفة الذِّكر نجد أنها تختلف باختلاف الأنظِمة القانونيَّة، لكنَّها تتَّفق في الإطار العام الحاكم للمَفهوم.
ومِن المُهمِّ أن نُقدِّم نبذة عن تطوُّر المفهوم القانوني للبيئة، فإن تاريخ المُحافظة على البيئة يرجع في أقلِّ تقدير إلى ثلاثة آلاف سنَة قبل الميلاد، عندما شرعت آر “UR” (العراق اليوم) قوانين تضمَن عدم اضمِحلال الغابات مِن جراء الاستنزاف الجائر، وبالمِثل أقرَّ المجلس الروماني قبل نحو ألفَي سنَة قانونًا يَقضي بحفظ المياه خلال فترات الجَفاف.
وغنيٌّ عن التذكير أن جذور المحافظة على البيئة مَغروسة بثبات في تعاليم الأديان السماوية الربانية، بل حتى في شعائر الأديان الوثنية؛ كالبوذية والهندوسية، التي تُرشِد أتباعها إلى حسن المحافظة على الطبيعة الأمِّ“[10].
“لقد ظهر قانون البيئة نتيجة التطورات التي جرَت في الواقع في مجال البيئة وتلويثها؛ حيث أظهرت بوضوح أهمية إقرار حق الإنسان في حماية بيئيَّة سليمة ومناسِبة، يُعتبر هذا الحق من حقوق الجيل الثالث من أجيال حقوق الإنسان، والتي أُطلِق عليها حقوق التضامن“[11].
ويُعتبَر القانون الدولي للبيئة حديث النشأة؛ إذ إن أصوله الحقيقية تعود إلى نهاية الستينيات من القرن العشرين، وهي المرحلة التي بلغ فيها النمو الاقتصادي مستويات مُرتفِعة بعد مرحلة البناء التي تلت الحرب العالمية الثانية.
حيث يعدُّ قانون البيئة أحد فروع القانون الدولي العام الذي يهتمُّ بحماية البيئة بمختلف جوانبها، ويُمكن إجمال المواضيع التي يهتمُّ بها القانون الدولي البيئي فيما يلي:
“منع تلوث المياه البحرية، وتوفير الحماية والاستخدام المعقول للثروات والأحياء البحرية، حماية المحيط الجويِّ من التلوث، حماية النباتات والغابات والحيوانات البريَّة، حماية المَخلوقات الفريدة، حماية البيئة المحيطة من التلوُّث“[12].
مما سبَق يُمكن تعريف القانون الدولي البيئي بأنه: “مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تُنظِّم نشاط الدول في مجال منْع وتَقليل الأضرار المختلفة التي تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي“.
وقد أُبرمت مجموعة من الاتفاقيات بشأن حماية البيئة، سواء على المستوى العالَمي أو الإقليمي.
أهم الاتفاقيات المُبرَمة على المستوى العالمي:
• “اتفاقية لندن 1954 الخاصة بمنع تلوث البِحار بالنفط“.
• اتفاقيَّة باريس 1960 بشأن التجارب الذرية.
• اتفاقية 1969 بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجِمة عن التلوُّث، لقد عالجتْ هذه الاتفاقية القواعد المنظِّمة للإجراءات الضرورية لحماية الشواطئ في حالة وقوع أضرار ناشئة عن كوارث نفطية في أعالي البحار.
• اتفاقية بروكسيل 1970 بشأن صيد وحماية الطيور.
• اتفاقية باريس 1972 المُبرَمة في إطار منظَّمة اليونسكو بشأن حماية التراث الطبيعي والثقافي.
• اتفاقية أسلو 1972 بشأن منع التلوث البَحري من خلال إلقاء النفايات من الطائرات والسفُن.
• الإعلان العالمي للبيئة في أستوكهولم 1972، وهو اللبِنة الأولى في صرح القانون الدولي للبيئة“[13].
• اتفاقيَّة واشنطن 1977 في إطار منظَّمة العمل الدولي بشأن حماية العمال من الأخطار الناجِمة في بيئة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضاء، وما شابَه ذلك.
• الميثاق العالمي للطبيعة 1980.
• اتفاقية الأمم المتَّحدة لقانون البحار 1982.
• اتفاقية فيينا لحِماية طبقة الأوزون.
• الاتفاقية الدولية المُبرَمة سنة 1986 بشأن المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي.
• الإعلان الصادر عن قمَّة الأرض بريودي جانيرو 1992.
• اتفاقية مكافَحة التصحُّر 1994.
• بروتوكول طوكيو 16 مارس 1998 الذي يلزم الدول المتقدِّمة بالحد من الأنشطة الاقتصادية[14].
أما على المستوى الإقليمي فأهم الاتفاقيات ما يلي:
• “الاتفاقية الإفريقية لحِفظ الموارد الطبيعية 1968.
• مبادئ سنتي 1974 بشأن حماية البيئة لبحر البلطيق.
• اتفاقية جدَّة 1982 بشأن حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن“[15].
[1] هو أبو الفضل جمال الدين بن منظور محمد بن مكرم الأنصاري الرُّوَيفعي الإفريقي، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد سنة 630 هـ – 1232م في القاهرة، كان عالمًا في الفقه واللغة، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر؛ حيث عاش بقية حياته، وتوفي بها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وقد كُفَّ بصره في آخر عمره، من أشهر أعماله وأكبرها: لسان العرب، عشرون مجلدًا، جمَع فيها أمهات كتب اللغة، فكاد يُغني عنها جميعًا؛ “الأعلام” للزركلي، عن موقع المعرفة على شبكة الإنترنت.
[2] ابن منظور، الإفريقي، لسان العرب، ط1، دار الكتب العلمية 1424هـ – 2003م، باب الألف، فصل الباء فالواو، مادة (ب و أ) (1: 42) فما بعدها.
[3] القحطاني، د. عمر بن محمد القحطاني، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، ط1 دار ابن الجوزي 1429هـ – 2008م، المبحث الأول، (ص: 21 – 24) باختصار.
[4] انظر الموقع على شبكة الإنترنت، مقالة: “ماهية البيئة“؛ للدكتور: أسامة عبدالعزيز.
[5] انظر المرجع السابق، نفس الموضع.
[6] البحث العلمي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 46، (ص: 22 – 23)
[7] الوجيز في قانون البيئة؛ للدكتور عبدالمجيد السملالي، (ص: 13)
[8] تُراجع موسوعة التشريعات العربية.
[9] الوجيز في قانون البيئة؛ للدكتور عبدالمجيد السملالي، (ص: 29)
[10] الوجيز في قانون البيئة؛ للدكتور عبدالمجيد السملالي، (ص: 30)
[11] نفس المصدر السابق، (ص: 37 – 38)
[12] انظر الموقع على شبكة الإنترنت www.cmes – maroc.com مقالة: “القواعد الدولية لحماية البيئة” لحياة زلماط.
[13] انظر الموقع على شبكة الإنترنت www. Cmes – mroc.com، مقالة: “القواعد الدولية لحماية البيئة” لحياة زلماط.
[14] انظر الموقع على شبكة الإنترنت: www.cmes – maroc.com.
[15] نفس الموقع السابق.
المصدر : الألوكة